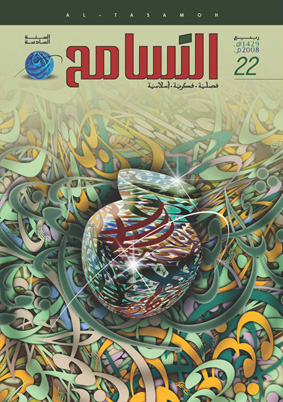|
الحركات الأصولية المعاصرة في الأديان* |
|||
|
|||
|
ثأر الله La Revanche de Dieu لجيل كيبيل، أراده مؤلفه بحثا تاريخيا علميا للحركات الأصولية: الإسلامية والمسيحية واليهودية، بين 1975 و1990م، أي للفترة التي شهدت إعادة تأكيد الهوية الدينية في الشرق والمغرب العربيين، وفي أوروبا وأمريكا وإسرائيل. والمؤلف يشير في مقدمته إلى أنه قد يصل إلى تفسيرات وتأويلات لا يوافقه عليها كثيرون، إلا أن أمله هو أن يقدم -بنزاهة- مادة صالحة للمناظرة.
إن الحركات الإسلامية والمسيحية واليهودية، في هذه الفترة، جاهدت لتأكيد تشوش العالم وفوضاه، باعثة مصطلحات فكر ديني لتطبيقها على العالم المعاصر، ثم راحت تضع مشروعات لتغيير النظام الاجتماعي، ولجعله متفقا مع قيم القرآن والتوراة والإنجيل، بصفتها الضمان الوحيد -في تفسيرها- لمجيء عالم من العدالة والحق. إذاً، هي تشترك جميعها بخصائص تتعدى مجرد تزامن ظهورها، فهي ترى أن مشروعية (المدنية) الدنيوية صارت أنقاضا، والتحويل الجوهري هو في عودة النصوص الدينية لتكون الإلهام الأول (للمدنية) المقبلة، وهنا تفترق الديانات الثلاث في المحتوى الذي ينبغي إيلاؤه لهذه الأخيرة.
في سنوات الستين، تراخت الصلة بين الدين ونظام المدينة، ما أدى إلى قطيعة منذ عام 1975 حين انقلب الأمركله، إذ راح يتكون خطاب ديني جديد لا يهدف إلى التكيف مع القيم الدنيوية، وإنما إلى إعطاء تنظيم المجتمع أساسا قدسيا، داعيا إلى تجاوز حداثة يعود فشلها إلى ابتعادها عن الله. وهذه الحداثة -عمليا- لم تستطع في النهاية أن تولد قيما. ومن جهة أخرى، فإن الحركات الدينية المعنية وهي تريد تجاوز الحداثة، لا تهدف -كلها وعلى المدى القريب- إلى الاستيلاء على السلطة والتحويل الثوري للمجتمع.
وهنا راح المؤلف يرصد نقاط استدلال من بين أحداث تلك الحقبة، فأشار إلى سنوات 1977 و1978 و1979م، التي حصل في كل سنة منها، انقلاب في اليهودية والمسيحية والإسلام:
1- سنة 1977م لم تسمح الانتخابات التشريعية في دولة إسرائيل للعمال بتشكيل الحكومة، فحققت الحركات الصهيونية اختراقا بتسلم بيغن رئاسة الوزارة، وراحت تكثر من إنشاء المستوطنات (بناء لعهد نوعي جرى بين الله وبين الشعب المختار) وكان التساؤل بعد خسارة حرب 1973م قد ازداد حول السّنة العلمانية للصهيونية، مما أفسح المجال للأحزاب الدينية أن تغالي في سلفيتها، وهي على اختلافها تشترك في اطراح تعريف اليهودية بالانتماء فقط، فالمعيار عندها هو سيادة الطقوس والتقيد الصارم بالعبادات وأحكام الدين في الحياة.
2- سنة 1978م اعتلى البولوني فويتيلا سدة البابوية في الكنيسة الكاثوليكية، فوضع حدا لمماشاة العصر، أو مزامنة الطقوس والعقيدة، وبدأت تتنامى المجموعات اللدنية (التي تقول بالهبة اللدنية) في أوروبا كما تنامت في أميركا، فجندت المتعلمين الشباب، إلا أن ترجمتها السياسية تفاوتت من بلد إلى آخر، فهي راسخة في إيطاليا وبولونيا، ضعيفة في فرنسا، لكنها جميعا تعلن بطلان المجتمع الخاضع لربقة العقل فقط، وتقدم شهادات على ضرورة العودة إلى الله لإنقاذ البشر.
3- سنة 1979م، الذي تصادف أنه بداية القرن الخامس عشر الهجري -بدأ مع عودة الخميني إلى طهران، ثم الهجوم على المسجد الحرام في مكة، مما أظهر القوة الكامنة في الدين أمام العالم. لقد اعتاد الغربيون على اعتبار ديانات العالم الثالث بقايا فولكلورية، لذا فوجئوا بانبعاث الإسلام، الذي لم يكن سوى الجزء المرئي من حركات عميقة لأسلمة الحياة اليومية والعادات، انطلاقا من النصوص المقدسة.
4- سنة 1979م انتخبت أميركا رئيساً معمدانياً شديدَ الإيمان، جاء ليغسل الإدارة ويطهرها من خطيئة ووترغيت، كما أن انتخاب منافسه سنة 1980م يعزى إلى أصوات الإنجيليين الجدد. لقد اشتدت الحركات الدينية الأميركية فاخترقت الشرائح كلها مطورة شبكة وعظ وتبشير بتمويل هائل، لتعميم مفهومها عن المجتمع المؤسس على (القيم المسيحية) فقط.
هذه الحركات الدينية في الأديان الثلاثة -التي برزت في السنوات المشار إليها- كانت ولادتها قبل ذلك، ومع أن حميتها متفاوتة، لكنها وجدت صدى واسعا في عوالمها، وكائنا ما كان ضلال أو تعصب أو غرابة هذه الحركات، إلا أن رصدها يعني أن نحمل محمل الجد خطابها وممارساتها، وهنا بدأ (جيل كيبيل) باستعراض أربعة سياقات في رصد انتشار الحركات الدينية: في الإسلام المتوسطي، والكاثوليكية الأوروبية، والبروتستانتية الأميركية الشمالية، ثم في إسرائيل والشتات اليهودي.
أولا: السيف والقرآن
في سنوات السبعين، دارت نزاعات عنيفة بين المجموعات الماركسية وحركات العودة إلى الإسلام، في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، للسيطرة على فضاءات بنيوية، تمثلت بالجامعات وبأطراف المدن، وقي بداية الثمانينات لحقت الهزيمة بالماركسيين، لتشهد عشرية هذا العقد اضطرابات متقطعة، لم تحقق الاستيلاء على السلطة لأي من الحركات، سوى ما حصل في إيران، فرغم الحرب اللبنانية والعراقية ومظاهر الإرهاب، لم تتزعزع بنية أي نظام اجتماعي بصورة أساسية. لقد كانت عودة الإسلام (من تحت) واضحة لتطال العادات وأنماط المعيشة، في إنشاء شبكات واسعة ذات هيكليات من السلطة المضادة، عملت بدأب على تقويض الديكتاتوريات القديمة.
والمتابع لواقع هذه البلدان، في حقبة الستينات، يلاحظ ما عانت حكوماتها في إدارة اقتصاد العوز في سياق الانفجار السكاني، فلا النمط السوفياتي نجح في تكييفه للمجتمع، ولا الإقطاع ولّد نموا قضى على الفساد. وإزاء استياء عام، أدمجت الدول المنتسبة إلى الاشتراكية بعض الشيوعيين بتحالفات مؤيدة للسلطة، لكن سرعان ما سجنتهم أو هجّرتهم حين تجاوزت انتقاداتهم ما يحتمله قادة البعث أو عبد الناصر أو جبهة التحرير الجزائرية.
أما في الدول المحافظة -أو البورجوازية- فالمجموعات الشيوعية عملت في السر، أو بصورة غير شرعية، دون أن تملك وسائل للإطاحة بالسلطة. وقد غلبت على حرم الجامعات فيها اتحادات سرية لعب فيها الماركسيون أدوارا أيديولوجية هامة، كما في المغرب وتونس ولبنان. وفي الجزائر التي تخلصت حديثا من الاستعمار الفرنسي، مع احتفاظها بقربى ثقافية معه، ظهرت تيارات يسارية طلابية، قادها فيما بعد، حزب الطليعة الاشتراكية، لكن شباب الطليعة كانوا يفكرون ويعبّرون بالفرنسية، وحين أقلقوا السلطة عارضتهم (بالمستعربين) الذين عادوا من الشرق حيث اتصلوا بالإخوان المسلمين، هذا الموقف أضعف المجموعات الاحتجاجية الماركسية وأنهض الحركات الإسلامية.
وفي الشرق الأوسط، بين حربي 1967 و1973م -ووضع النخب الحاكمة هش بعد انهيار الجيوش العربية- أصبحت فلسطين رمز المقاومة ضد إسرائيل والأمبريالية الغربية، فلم يعد الحاكمون هم المرجع، بل حركات التحرر الوطني. وسارع الماركسيون لجعل أنفسهم دعاة المقاومة والمدافعين عنها في وجه (الخيانات) القيادية العربية. لكن الجميع فوجئوا بثورة عظمى في إيران لا تنتسب إلى ماركس أو لينين: إنها مراوغة التاريخ، فالغرب الذي كان ينتظر يساريا يلبس كوفية رأى شيخا يحمل بندقية. وإذ بالحركات الإسلامية تطرد الماركسيين في تطلعها إلى عالم أفضل، مرجعيته في الدين.
وفي الواقع، إن الحركات الوطنية والقومية ما خلت يوماً من جناح ديني، فجمعية العلماء الجزائريين -والتي تستلهم فكر عبد الحميد بن باديس- أسهمت في الإبقاء على مرجعية الإسلام في خطاب جبهة التحرير، كما أن الإخوان المسلمين في مصر ساندوا نظام عبد الناصر ورفاقه الضباط الأحرار، وعبد الناصر والسادات كلاهما متحدر من أوساط متواضعة أشبعت برؤية للعالم تعبر عن الرغبة في التغيير بمقولات قرآنية. إلا أن عبد الناصر -بعد أن اطمأن إلى سلطانه سنة 1954م- راح يصفي شريكه، ومنافسه السياسي الوحيد.
وقد لاقت طروحات سيد قطب شهرة واسعة في العالم الإسلامي، وهي تردّ إلى كتابيه: في ظلال القرآن، ومعالم في الطريق. وقوام ما انفرد به سيد قطب أنه فصل فصلا كاملا بين الإسلام ومجتمعات عصره، بما في ذلك تلك التي تدعي الانتماء إلى الدين. فأوجب القطيعة مع (الجاهلية) المتمثلة بالعالم المعاصر، لإقامة الدولة الإسلامية على أنقاضها. وقال أن البربرية الناصرية بلغت نقطة اللارجوع، وعلى النخب المؤمنة أن تستولي على المجتمع بعد أن (تفاصله وتعتزله). وحركة القطيعة بتأويلاتها، كانت هي في أصل حركات العودة إلى الإسلام، وقد امتد خط القطيعة في مختلف المجتمعات المعنية، ليفجر الإجماع السياسي، الذي لم يهتز بمثل هذا القدر من الاتساع منذ الاستقلالات.
هذه الحركات -في تأكيدها على الهوية الإسلامية التي أرسى أسسها سيد قطب- بدأت تحتل حقول التمرد تدريجيا على حساب اليسار الماركسي، وكان لحرب 1973م انعكاس غير مباشر على تناميها، ولأن البترو -إسلام هو الذي كان المنتصر الحقيقي في هذه الحرب- وهو لا يؤيد أية إعادة نظر بالنظام الاجتماعي، ولو جاءت المراجعة باسم مبادئ القرآن -فقد راحت المملكة العربية السعودية تلعب دور زعيم نشر الإسلام، بصيغته السعودية، جاعلة هذا الدور من الأهداف الأولية عندها. نعم، لكن النفط -مع انقلاب الأمر هنا- لم يكن سوى مولّد هذا الإسلام المنبعث.
ومع ارتفاع أسعار النفط، تفككت مجتمعات، وتعززت الفوارق بين العالم الريفي والمراكز المدينية حيث تتركز الثروات، ففاضت مدن الشرق الأوسط بالفلاحين الذين استقروا في أحزمتها، في أحياء صفيحية وسواها من ضروب السكن الهشة، وفيها، راحت ترتفع مآذن المساجد، صغيرةً وكبيرةً، تشفعها جمعيات خيرية وتعليمية، في ظل غياب للدولة: في جنوب طهران، وأسطمبول، إلى مقابر القاهرة وأحياء الجزائر الصفيحية…
أما أهم الاختراقات الاجتماعية للحركات الإسلامية فكانت في الجامعات، وذلك بتنظيم (مراجعات ومحاضرات) مجانية للطلاب في المساجد، وتكاثرت هناك (الخدمات) حتى طليت صور لينين نهائيا، في الجامعات، بشعار: الله أكبر.
ووقعت أول مواجهة مع (المؤمنين الحقيقيين) في مصر سنة 1974م, فتصدى لها السادات وفككها وأعدم قادتها، وكان هذا أول فشل للإستراتيجية الإسلامية في الأستيلاء على السلطة. لكن وبعد 1979م سيجسد طرف هذه الآمال، ولن يكون من (ذرية) سيد قطب، بل هو إيران الشيعية التي انتصرت فيها الثورة الخمينية.
هذه الثورة كانت (فريدة) ذلك أنه في الإسلام الشيعي شبه كهنوت هرمي متراتب، والمذهب الشيعي يعتبر، من الناحية الأيديولوجية، أن حائز السلطة لا يملك الشرعية قبل ظهور الإمام الغائب. كما أن صاعق تفجير الثورة كان في التحالف الذي تم بين رجال الدين وبين النخب الطلابية، وقد عرف هذا التحالف كيف يقف على رأس حركة قدم لها (المستضعفون) المكدسون في الضواحي جنودها. وبرغم تيقن الإيرانيين بأن ثورتهم ستمتد وتشمل العالم الإسلامي، إلا أنهم لم يجدوا مؤيدين بأعداد كبيرة إلا في جنوب لبنان، حيث جرى تأطير مناضلي حزب الله الخمينيين بمتطوعين جاءوا من طهران.
وفي عودة إلى الحركات الإسلامية السنية، فإنها جميعا – من محاولتها تغير نظم الحكم في البلاد الإسلامية خرجت مهزومة: في السعودية (الهجوم على مكة) وفي مصر وأفغانستان، وحيثما حصل تمرد للاستيلاء على السلطة. ولعل هذا الفشل المتواتر يعود إلى هيكلية الحقل الديني في العالم السني، فالعلماء السنة -خلافا لزملائهم الشيعة- لم ينجحوا في الاحتفاظ باستقلال حقيقي إزاء السلطات القائمة، ونادرا ما انبعث المناضلون الإسلاميون من صفوف العلماء السنة، بل على العكس، فالمناضل النموذجي هو طالب كلية حديثة دنيوية، مع ميل إلى الفروع التطبيقية أكثر الأحيان.
إن فشل الحركات الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط، جعل من إيران الغارقة في حرب مكلفة مع العراق، النجاح الوحيد للعودة إلى الإسلام من فوق، لكن هذه العملية اضطرمت في أواسط الثمانينات لتفضي إلى الإرهاب الدولي.
وكانت قضية سلمان رشدي آخر محاولة قام بها الخميني (توفي سنة 1989م) ليعاود ترويج الجهاد على الصعيد الدولي، وكان الأمام قد دعا إلى قتل الكاتب بعد اتهامه بالردة، لأنه نال من النبي –صلى الله عليه وسلم- واحترامه، في روايته (الآيات الشيطانية). هذه القضية لم تعد تنتمي إلى منطق العودة إلى الإسلام (من فوق) لأن ما فعلته إيران هو تضخيم حركة ولدت خارج مناطق نفوذها، وسط مسلمين هندوباكستانيين مهاجرين، ولكي نفهم هذا الانتقال من (فوق) إلى (تحت) ينبغي أن نعود إلى دلالة (العزلة) أو (المفاصلة) الإسلامية.
في الهند، جماعة (التبليغ) ضبطوا سلوكهم انطلاقا من تعاليم (رياض الصالحين) فإليه يعودون ليعرفوا شؤون حياتهم اليومية، مقلدين النبي –صلى الله عليه وسلم- في كل ما كان يفعل، وفيما وراء البعد المذهبي، فإنهم كانوا يستجيبون لطلب ذي طابع اجتماعي، من هنا كان (اعتزال) المؤمنين للمجتمع الكافر، وتقديم محميات لهم.
الحيزات المؤسلمة في أوروبا
يتحدر أكثر المسلمين في بريطانيا من شبه القارة الهندية، وقد نظموا مرجعية لهم في المركز الأوروبي للتبليغ في (دوزبري) قرب برادفورد، وما يسر لهم هذه الهيكلة المتحدية للإسلام، هو السياسة البريطانية التي تفضل الانخراط الجماعي للمهاجرين (خلافا لفرنسا التي تفضل الانخراط الفردي)، ولما خفضت السيدة تاتشر الموازنات الاجتماعية التي طالت الفقراء، نشبت اضطرابات بركستون العنصرية، فشعر المسلمون أيضا بضرورة التجمع في شبكات تعاون إدارتها المساجد، مما ولد أرضية مؤاتية للعودة إلى الإسلام من تحت، فتم اعتزال (الجاهلية البريطانية) في (غيتو) حول المساجد، وفي انتخابات 1987م أعطى المسلمون أصواتهم لمن تعهد بقبول (شرعة المطالب الإسلامية). لذلك عندما أطلقت قضية سلمان رشدي كان الجو الإسلامي جاهزا، فأحرقت آيات سلمان رشدي الشيطانية. لكن الإمام الخميني في أمره بإعدام الكاتب -استجابة للسياسة الإيرانية، ومحاولة لاسترداد الزعامة الأيديولوجية للعالم الإسلامي- رفع الرهان عاليا، مبشرا بمرحلة جديدة للعودة إلى الإسلام من فوق.
كذلك قضية الحجاب الإسلامي في فرنسا التي انفجرت في خريف 1989م، فقد صدرت عن المنطق ذاته، وهي تترجم ما حققته في فرنسا شبكات العودة إلى الإسلام من تحت، وتطبيقها (المفاصلة) عن (الجاهلية الفرنسية)، وقد استفاد المناضلون المسلمون في معركتهم من تضامن بعض الكاثوليك من أجل (علمانية جديدة) يعود فيها الديني إلى الحيز العمومي.
الانتفاضة وجبهة الإنقاذ
تنامت ظاهرة العودة إلى الإسلام من تحت أيضا، في العالم الإسلامي، والانتفاضة الفلسطينية هي عنصر مكون لها، كما كانت جبهة الأنقاظ في الجزائر، فالقضية الفلسطينية -التي كانت آخر تعبير عن القومية العربية- لم تكن مصطلحات التعبئة الإسلامية تلعب فيها سوى دور متواضع.
ففي حرم الجامعات الفلسطينية ولدت مجموعات إسلامية حققت نجاحا في الانتخابات الطلابية، ومع اندلاع الانتفاضة نشأت لجان شعبية أطرت التعبئة المعادية لإسرائيل، وشجعت قيام شبكات من التعاون والإحسان كان للمساجد فيها دور رائد، فاشتهرت، حينها، المقاومة الإسلامية تحت اسم (حماس).
وفي الجزائر، حققت إستراتيجية (العودة إلى الإسلام) من تحت، نجاحا مع فوز جبهة الأنقاظ في انتخابات 1990م البلدية، وسبب ذلك أن نظام بومدين حين شعر بالقلق من نشاط الماركسيين والفرنكوفونيين -الذين سبق وشجعهم- عارضهم بالطلاب (المستعربين) الذين درسوا في الشرق الأوسط وتعرفوا هناك إلى الإخوان المسلمين، وفي النزاعات الجامعية انتصروا. ثم تعاظمت الحركة الإسلامية وصارت مسلحة سنة 1982م، كما بدأت شبكات جامعية إسلامية تتهيكل في الأحياء وحول المساجد (البرية) خارج المدن، وداخلها. والمساجد استطاعت الالتفاف على الرقابة والقمع، وهنا نجد (المفاصلة) واقعية. لكن، ومع انفتاح النظام السياسي، سمح بتكوين جبهة الأنقاظ الإسلامي،التي أثبتت قدرتها على توحيد القوى المنبثقة من شبكات معاودة التحنيف من تحت.
أوروبا أرض رسالة وأرسالية
في الربع الأخير من القرن العشرين، كانت أوروبا على قدر كثيف من الدنيوية واللامسيحية، فتكاثرت حركات معاودة التنصير في كل مكان. وجاءت بابوية يوحنا الثاني لتعيد التأكيد على القيم والهوية الكاثوليكية، في وقت اتسم بنمو العصر الصناعي الذي راح يهدد بالإفراط في التسلح والتلوث، بل وساهمت الثورة الإلكترونية في انقلاب لا سابق له في القواعد الخلقية، وبلغ ذلك أنماطا فظة من نقل القيم في تلقيها وتبليغها. أما في الشرق الأوروبي فسقط حيز إيديولوجي شاسع كانت الماركسية تمارس عليه رقابة شديدة، وتم تعيين رئيس وزراء كاثوليكي في بولونيا، كل ذلك أشار إلى أن (عودة الديني) إلى المسرح السياسي صار محتوما كنتيجة لخروج الشيوعية، وقد رأت الكنيسة في ذلك نهاية دورة الحداثة التاريخية التي بدأها عصر التنوير.
وفي تحليل عملية (معاودة التنصير) نفهم ما تعرض له مجمع (الفاتيكان الثاني) لمناهضة التأويلات التقدمية (لكاثوليك اليسار) أو لاهوت التحرير)، حتى ظهرت حركات كاثوليكية تطمح إلى الضغط على السلطة أو إلى الوصول إليها، وعلى عكس (معاودة الإسلام) فإن (حركات معاودة التنصير) ولدت حيث عاشت علمنة دنيوية عميقة، لذلك كان ينبغي على هذه الحركات إعادة تعليم مفاهيم أنجيلية لشبان فقدوا مسيحيتهم، وهذا أحد أسباب تدني التأثير العام للحركات الدينية في أوروبا الكاثوليكية بالقياس مع العالم الإسلامي.
لكن هذا لم يمنع نشوء نزاعات بين طوباويات دنيوية وبين عقائد دينية مترسخة (قاطعت) و(فاصلت) نفسها عن (نجس) العالم، فتهيكلت حركات تطمح إلى إعادة التنصير من فوق ومن تحت، لتعيد العصر المسيحي، كما حاولت الحركات الإسلامية استعادة جيل قرآني يستلهم رسالة محمد –صلى الله عليه وسلم-.
قام المجمع الفاتيكاني الثاني سنة 1962م بمراجعة تهدف إلى مماشاة الكنيسة مع العصر، فأصدر ست عشرة وثيقة، كانت ثمرة تسويات بين القوى الحاضرة، والكنيسة لقلقها من (خطر امتصاصها في الروحية الحديثة)، عملت للمحافظة على المؤسسة مع التخلى عن الحد الأدنى من الطقوس، كما حاولت أدراج مثل العصر الكبرى، كالتنمية والعدالة الاجتماعية ضمن منظار ذي اسس مسيحية،في وقت بدأ احتياط الكنيسة الديموغرافي ينتقل إلى جماهير اميركا اللاتينية الفقيرة. أما في أوروبا فأن الطبقة العاملة بدت لامبالية إزاء مسيحية اجتماعية يندد بها الماركسيون، بصفتها سلاحا بيد البورجوازية، وانتهى المجمع بإعلان: أن الإنسان خليقة الله لا يمكن تقليصه وتحجيمه إلى مجرد عامل إنتاج يمكن استغلاله إلى ما شاء الله.
لكن أحد لاهوتيي التحرير قال في المجمع: أنه لم يتجرأ على إعادة النظر في النظام الظالم الذي هو في أساس الحياة الاجتماعية، فلم يتعرض للوجوه النزاعية في الحياة السياسية. و(لاهوت التحرير)، الذي لامس كثيرا من فكر المؤمنين، مـّثل في نظر المراتب الدينية (الخطر الماركسي) الذي يوشك أن يستخدم الكنيسة لينحرف بها عن رسالتها.
وما وراء لغة النص، صرنا إزاء موضوعتين: الاستلاب الديني الذي تعززه المراتب الدينية مقفلة على التأويل داخل نظام من الشروح غايتها إضفاء المشروعية على النظام القائم، والالتزام الاشتراكي الذي يمثله لاهوتيو التحرير، المنطلقون من دون توسط النصوص المقدسة لتبرير التزامهم هذا.
إذاً، نكون أمام ايديولوجية قطيعة مع النظام القائم، مما يعني إمكانية شق الكنيسة، فإقامة الاشتراكية مقام مجيء المسيح أمر خطير، رغم ذلك راعت الكنيسة هذا اللاهوت بحكمة، فحين اكتسبت هذه الظاهرة الطابع الجماهيري خاصة في أميركا اللاتينية، أمسكت بالمؤتمر الأسقفي اللاتيني، فعينت أساقفة معادين لهذا اللاهوت، لتوقف نفوذه بأوثق وآمن الوسائل، وهكذا عانى الاهوتيو التحرير خيبات كثيرة.
أما حركات إعادة التنصير فقد تعززت منذ أواسط السبعينات، والمسؤول عن ذلك هو هيمنة العقل على الإيمان، ويجسد الكاردينال لوستيجيه والكاردينال راتزنجر (البابا بنديكتوس السادس عشر حالياً) -كل على طريقته- انخراط الكنيسة في ما بعد الحداثة. الأول يهودي بولوني، اعتنق المسيحية إبان الحرب الثانية، خريج مدارس دنيوية، عاش في البورجوازية الباريسية، والثاني ريفي أظهر نفسه في كتابه (اختيار الله) مثقفا يتحكم بمعارف القرن، فيحدد ما قدمته العلوم الاجتماعية ويعين مآزقها، واجدا في الإيمان الكاثوليكي وسائل لتجاوز هذه المآزق. يقول لوستيجيه: إن اكتفاء العقل بنفسه يجعله يجهل الله، بحيث لا يعود عليه تقديم حساب إلا إلى نفسه، وهو ما أفضى إلى التوتاليتارية النازية أو الستالينية وتجسيدها الأعلى الشيوعية. فالعقل المكتفي يولّد الوثنية، مما يقود إلى الارتياب بالإيمان، فيحل العقل –وهميا- مكان المثل الأعلى. والحال أن العائق أمام إعادة التنصير في المجتمعات العلمانية الدنيوية الأوروبية هو استبعاد الديني، ولا بد إذاً من استحداث (علمانية جديدة).
وقد ظهرت أعمال راتزنجر، الذي عينه البابا رئيسا للمجمع الكنسي لشؤون العقيدة الإيمانية، بمواقف عادت التيارات التقدمية، فرأته حافر قبور آمالها، في وقت كثرت فيه الانشقاقات الكنسية، فقام ليؤكد على أولوية البابا، المتأسسة على لاهوت الاستشهاد، وأن الكنيسة هي الملاذ الوحيد ضد توتاليتارية الدول التي تريد تسخير الإنسان، ولكي يستطيع الصليب الدفاع عن الإنسان، فإنه لا يعود مقبولا أن يزاح إلى حيز الحياة الخاصة. إن استرداد وضعية (القانون العمومي) هو أحد رهانات إعادة التنصير المعاصرة، فتبعية الدولة لحقائق الإنجيل تحفظ لها حيزا مستقلا ذاتيا، لأن التنظيم الاجتماعي المسيحي هو إثنَيني، والكنيسةُ في الرُبع الأخير من القرن العشرين ليست دولةً ولن تصير كذلك.
إعادة التنصير في أوروبا الغربية
في أوروبا مجتمعان شهدا تنامي حركات تسعى إلى التحرير من فوق، بممارسة الضغوط على الدولة كما في بولونيا، حيث لعبت الكنيسة دورا بارزا في ذلك، وفي إيطاليا مع حركة (تناول وتحرير)، مثل هذه الحركات فضل ازدهار (الهبة اللدنية) التي تنشئ حيزات متحدية جماعية لمريديها، على إنشاء مدارس تقف بين الخاص والعمومي.
حركة (تناول وتحرير) في إيطاليا -والتي تعود بدايتها إلى الخمسينات- سجلت نجاحها في النصف الثاني من السبعينات حين اشتد نضالها من أجل حضور الكنيسة في عالم ابتعد عن الله، فعاش مريدوها مشكلاتهم وآمالهم معا، يصلون ويقدمون القرابين ويداومون على القداس اليومي، وقد أكثروا من المعسكرات والاجتماعات المختلطة، فأثاروا فضائح شجبتها الكنيسة.
وبعد المجمع الفاتيكاني الثاني، وجدت الحركة نفسها في ارتباك، فهي لا تريد تحديث المسيحية، بل تمسيح الحداثة، لتأكيد هوية الكاثوليك (باعتزال) منطق العلمانية الغالبة. وسنة 1970م -حين أعلنت الحركة رسميا- اجتمع المريدون وأكدوا وفاءهم للعيش في (حالة وحدة) مثل تلك التي حققها المسيح بنفسه بتوسط المعمودية.
في فرنسا
تجلت حركة إعادة التنصير حصريا بمجموعات (تجددية الهبة اللدنية) العاملة على ذلك من تحت في مشروعات اجتماعية متنوعة، وأصول هذه الحركة أميركية كاثوليكية، متأثرة بالبروتستانتية، وهي رغبة عامة بالتجديد بعلاقة شخصية مع الله يعبر عنها بتوسط الروح القدس على شكل صدمة انفعالية لا يستطيع العقل البشري فهمها، فالروح القدس يتنزل على المؤمنين هؤلاء ويجود عليهم بنفحات روحية، أكثرها أبهارا (تكلم اللغات، والقدرة على الشفاء العجائبي). وقد عاش المؤمنون (عددهم حوالي 200000) في تجمعات استقبلت كثيرا من الشباب المتعلمين، وعاشوا ضابطين حياتهم على الإنجيل، شأن المسيحيين الأوائل (في ممارسة أقوال المسيح بحرفيتها) وفي فرنسا استمر التفاوض والنضال من أجل إعادة الوضع القانوني العمومي إلى المسيحية، وتجلى ذلك في تحالف مجموعات إعادة التنصير ومعاودة الإسلام ومعاودة التهويد معا، خاصة بعد أزمة الحجاب الإسلامي، لاحتلال الحقل العمومي، ولو (في المدارس) في مرحلة أولى.
انتشرت معاودة التنصير في أوروبا كجواب على الأزمة الاجتماعية في السبعينات، في رغبة لتطلع ديموقراطي بالإعراب عن كثرة من الآراء الفردية، بعد سنوات من اعتناق (حقائق) لا تقبل المناقشة، مع التساؤل: هل التوتر الروحي الفذ في البلاد سيستمر بعد استرداد حرية الحياة السياسية، وهل كان فقط رد فعل على تحدي التوتاليتارية، أي أنه سيموت في اليوم الذي يزول فيه هذا التحرير؟ ولكي نفهم رهانات معاودة التنصير في عملية الخروج من الشيوعية، لا بد من قراءة (النمط البولندي).
في بولندة
الانتماء إلى الكاثوليكية هو من أهم السمات المكونة لهوية بولندة بين بروسيا البروتستانتية وروسيا الأرثوذكسية، ومع النازية التي قامت بمحو منظم للنخب الثقافية وتشجيعها وصول رحال جدد إلى السلطة، لم يكن في مقابلها إلا الأكليروس، فصفته سخنت وتفكيكا سنة 1956م، ثم اضطر النظام إلى التعايش معه للحصول على حالة اجتماعية مستقرة.
كانت بولندة مختبرا لمعاودة التنصير، فحين شيد العمال كنيسة في مدينة نوفاهوتا بالقوة، افتتحها كارول فويتيلا (البابا فيما بعد) شاهدا لكفاح عنيد في تأكيد الهوية الكاثوليكية في دولة ملحدة وبدء عملية التنصير من تحت.
ثم تأسست (حركة الواحة) فعقدت مخيمات مبعثرة لتقيم مع روادها حياة جماعية قوامها التفكير والصلاة والمقاسمة، واكتمل المد الكاثوليكي مع (ثورة الراكعين) في نهاية السبعينات، ليصبح المحادث السياسي للسلطة، محاولة التنصير هذه أتت من فوق, وبين 1981 و1989م كانت الكنيسة الناطق المتميز باسم المجتمع المدني، مع محاولة قادة النقابات تحجيمها، وتقليصها إلى (قوة روحية) وبقي النزاع حتى زوال السلطة الشيوعية.
المثال التشيكي المناقض
في البلاد التشيكية كان الوضع مناقضا لوضع بولندة، ففيها لم يحصل الحزب الشيوعي على أكثر من ثلث الأصوات في أي انتخابات، من هنا إعلان الحزب صراعه السياسي والإداري ضد قوى الرجعية وعلى رأسها الكنيسة الكاثوليكية. غير أن الكنيسة لم تكن تمثل الهوية القومية، كما لم تكن تملك الوسائل لتكون الناطق الرسمي باسم المجتمع المدني، فلدى إعلان قيام جمهورية تشيكوسلوفاكيا غداة الحرب الأولى، كان شعور العداء للكاثوليكية واسعا في بوهيميا، وسنة 1948م شهد تأميم أرزاق الكنيسة، وإلغاء التعليم الطائفي.
هذا التدمير للهيكلية الخارجية للكنيسة كان ذا نتائج إنسانية مأساوية لآلاف الكهنة والرهبان، الذين عرفوا السجن والنفي ومعسكرات العمل، حتى الذين حصلوا على تراخيص ممارسة القسوسة كانوا خاضعين لرقابة بوليسية.
بدأت حركات التنصير من تحت مع العائلات الكثيرة الأولاد، المتقيدة بالعقيدة المسيحية في ذلك، فعاشت هويتها (المفاصلة) أو المنقطعة عن المجتمعية الشيوعية، في (نادي الأسر المعيلة) ثم جرت اتصالات دولية لتنمية وتطوير (صورة مسيحية للعالم) فتم التواصل مع جماعة الصلاة المسكونية في فرنسا.
ولما عاد (هروزا) (الرعب) سنة 1968م إلى سكريتارية الشؤون الدينية، بعد أن أقصاه (ربيع براغ) تجدد العداء السافر للكنيسة وأفرادها بالابتزاز والتهديد والتخويف. واعتبارا من السبعينات، برز موقفان بين الكاثوليك: فهناك تعزيز لشبكات معاودة التنصير من تحت، وفي الجهة الأخرى التزام قلة من الكاثوليك بالانشقاق والخروج، هما متكاملان ولكنهما مبنيان على تصورين مختلفين لمكانة الكاثوليك في المجتمع.
وبعد قيام الديموقراطية في البلاد ظهرت انقسامات أكثر بين الكاثوليك، بسبب الالتزام السياسي لفريق منهم، لكن رجالات الكنيسة سارعوا إلى تأسيس (تحالف مسيحي ديموقراطي)، كما راحت حركات معاودة التنصير من تحت تعبئ قواها، رافضة كل التزام مع النظام الشيوعي، مقترعة للمسيحية الديموقراطية.
في أواسط السبعينات عاودت الكنيسة تأكيد هويتها واضعة حدا لريب ما بعد الفاتيكان الثاني، فواجهت خيارا مستحيلا، لتشجيع التنصير من تحت أو من فوق. فعدد من المؤمنين كانوا يتطلعون إلى الديموقراطية ويعتبرون أن التعبير عن الحقيقة الأخيرة التي هي في عهدة الكنيسة، تظل تابعة -في هذا العالم- لبحث البشر عن حريتهم، وليس ثمة (حزب مسيحي) مكلف برسالة تنظيم اجتماعي جرى ضبطه على الحق أو على الحقيقة التي لا يملكها سواه، وهذا (إكراه على الديمقراطية)، ليس حاضرا اليوم في حقل العودة إلى الإسلام، ولكننا لن نلبث أن نرى مثل هذا الاختراق -في أشكال مختلفة- في عالم الإنجيليين والسلفيين الأميركيين.
إنقاذ أميركـا
ظهر مصطلح الأصولية السلفية fundamentalism في السنوات العشرين على أثر ظهور اثني عشر مجلدا سنة 1910م تحت عنوان (الأصول) تضم مقالات اللاهوتيين البروتستانت المعارضين لكل تسوية، أو حل وسط، مع الحداثة المخيمة.
وحين حوكم أستاذ على تدريسه نظرية تطور الإنسان، منكرا قوانين الولاية التي تحظر كل نظرية غير موافقة على رواية الخلق الإلهي للإنسان سنة 1925م، برزت الأصولية إعلاميا، مقابلة الحداثة الليبرالية التي تنادي بها المؤسسة البروتستانتية، مؤمنة بعصمة الكتاب المقدس المطلقة، وما يشتمل عليه من أوامر سياسية واجتماعية.
وفي هذا النزاع استفاد الطرفان من الإحصاءات، التي أشارت مرة إلى زيادة عدد المؤمنين والمعتقدين بالوصايا العشر، أو الذين يمتلكون مثلا عليا، فبادر الإنجيليون إلى الاهتمام بفقراء الجنوب، كما عزمت كنائسهم على نشر رسالة المسيح في العالم.
والإنجيليون ينحون نحو الخلاص الشخصي، مع ممارسة اجتماعية هامة عبر الرعويات وتكوين شبكات قومية تستخدم وسائل الإعلام بقوة وتقنية عالية. وهي تتناول الشرور والآلام عبر تعرية الخطيئة وفدائها، وتجاهد للتأكيد أن سبب الشر هو في الابتعاد عن الله، هذه الحركة لمعاودة التنصير من تحت ظل بعدها السياسي مغيبا.
جسد هذه الحركة على الصعيد القومي بيلي غراهام وأوزال روبرتس، فالأول طور (إحيائيات) متجولة، هي تجمعات حاشدة في مهرجانات كبرى ومع جمهور متحمس يستمع إلى وصف العذاب الأزلي الذي ينتظر الخاطئ، وهذا الواعظ استطاع أن يتخذ الإذاعة وسيلة له ثم التلفزيون ليصبح أحد أكبر المشاهير الأميركيين والعالميين (وقد حول الإنجيلية إلى ظاهرة ثقافية). كذلك الواعظ الآخر روبرتس صاحب الشهرة الخارقة في حملاته الصليبية من أجل المسيح، كان يشفي بعجائبية وينقل احتفالياته هذه عبر التلفزيون، فيضع يده على المريض كأنه يطرد الشيطان منه، وحين يصرخ المريض ليدخل في الإغماء، يشير الواعظ إلى أن صرخة الشيطان المسعور انطلقت… ولكن أحدا لم يشف مباشرة، ورغم ذلك كان التأييد الجماهيري له حاشدا، والتبرعات الكثيرة -له ولأمثاله- بملايين الدولارات تتدفق، والمتبرعون يعتقدونها ضرورية لشفائهم، (هناك ظاهرة جيم بايكر، الواعظ المحتال الذي جنى ثروة طائلة واقترف الآثام كلها ثم حكم عليه بالسجن 45 سنة).
الشفاء العجائبي كما (التكلم بالألسنة) (أي التحدث بلغات لا يفهمها البشري وإنما يعلمها الله) اندرجا في ممارسة اجتماعية تسير عكس ممارسة الكنائس الليبرالية؛ لأن المسألة ليست المساعدة للتوصل إلى الرفاه والغبطة في هذا العالم، بل لتقويم علاقة الفرد المضطربة مع الخالق، وإعادتها إلى ما كانت عليه، وذلك بإدخاله في جماعة أو متحد، تحركه فيها (الفضيلة المسيحية بإلهام الروح القدس).
ثم تغلغلت هذه الحركات في الأوساط الكاثوليكية، وكانت وراء ظهور اللدنيين الذين قطعوا الأطلسي إلى أوروبا، والكاثوليك هؤلاء كانوا يؤمنون أن (الكنيسة أضعفتها العدوى التي انتقلت إليها آفات المجتمع، ولذا فإن إلهاما من الروح القدس هو وحده الذي يسمح بالعودة إلى الينابيع).
سنة 1980م انتخب رونالد ربغان، وفي تحليل لأصوات الناخبين تبين أنه حظي بتأييد واسع من الحركات الدينية الإنجيلية، وأكبر هذه الحركات كانت حركة جيري فولويل الأخلاقية، إلى جانب حركات أخرى ضغطت لمعاودة تنصير أميركا لإنقاذها، وقد اجتمعت هذه الحركات على رفض سياسات اجتماعية للدولة، منها السماح بالإجهاض الذي اعتبروه (عدم إطاعة للمسيح، وقد وضعت الدولة نفسها خارج الشريعة)، الأمر الذي يجعل العصيان المدني مشروعا.
وقال فولويل: (إن على الأميركيين انتخاب قادة يحكمون أميركا بصراط الله ونهجه). وهكذا كان المرشحون الثلاثة سنة 1980م يدّعون كلهم الانتماء الأنجيلي، لكن ريغان الرابح كان يطرح نفسه كبطل الوطنية الأميركية التي تتماهى مع رسالة الكتاب المقدس، وتجعل الولايات المتحدة (بيت المقدس الجديد)، فتميز.
وقد أبدى ريغان خلال حملته الانتخابية شكوكه حول نظرية داروين. كما جرّم النظام التربوي المحايد العاري من الأخلاق، بعد تفاقم الجريمة وتعاطي المخدرات، وحين خاطب الأنجيليين نال رضاهم، ثم أعلن أن عام 1989م (عام الكتاب المقدس).
وقد أكدت الإحصاءات -بعد السبعينات- التي يحترمها الأميركيون كثيرا ويوظفونها، أن الأنجيليين زادوا قوة وعددا، ففي المجال اللاهوتي قبل ذلك، كان نصفهم (مهدويين) أي في تشاؤمية ثقافية وسياسية،يرون أن الأمور ستسوء على الأرض، وأن الله يصطفي مختاريه ويأخذهم من الدنيا وهم يائسون من قدرة الإنسان على العمل من أجل الله ومن أجل الخير.
لقد عاشت الطائفة الإنجيلية في المنفى الداخلي في الريف الجنوبي، حتى السبعينات، حين جاءت أجيال شابة لعبت دورا في انتقال الطائفة إلى السياسة، وهو ما ظهر جليا في الربع الأخير من القرن العشرين، حين تركوا الهامشية دون أن يتخلوا عن القيم العائلية الموروثة مستخدمين أكثر التقنيات حداثة للدفاع عن معتقدهم.
وعلى الصعيد الجامعي، كانت هناك في الستينات جامعتان مهمتان إنجيليتان هما: (بوب جونز) و(أورال روبرتس) وبلغ المشروع الأخير ذروته في إنشاء كلية للطب لتصير (مدينة الإيمان) سنة 1979م زاعمة إمكانية تعليم الشفاء من الأمراض الشيطانية، فباءت بالفشل. أما المؤسسة الأكثر تسييسا فهي التي أنشأها جيريرفولويل في فرجينيا تحت اسم (جامعة الحرية) خرّجت الألوف من المتعلمين -الوعاظ، ليسهموا في حملات التنصير من فوق، إذ كوّن فولويل جماعة ضغط (لوبي) من (الأغلبية الأخلاقية) مستخدما الحداثة وتقنياتها الإعلامية خاصة، ما جعله مشهورا، وثريا جدا من الهبات المالية، وفاعلا في السياسة والمجتمع.
وحين استثارت هذه الحركات أعداء علمانيين، استبدل فولويل بـ(الأغلبية الأخلاقية) (فدرالية الحرية) وهواستبدال ذكي، فمصطلح الأخلاق محدود المعالم، بينما مصطلح الحرية يحول تعدد دلالاته دون تبلور ردود فعل معادية، وهكذا صار التخلي عن إستراتيجية (كل شيء سياسة) والانتقال إلى الميدان الاجتماعي دون توظيفه في اللعبة السياسية. وبينما انسحب فولويل من السياسي بالمعنى الضيق فإن روبرتسون -الممثل النموذجي للمجتمع الراقي الأبيض البروتستانتي، والواعظ الأنجيلي الشهير- خاض الانتخابات، وكاد ينجح لو لم يستخدم (بوش)كل وسائله وقوته ضده. ما قام به فولويل هو توظيف بعيد المدى، وما قام به روبرتسون في السياسة عابر، لأن السياسة ظاهرة فرعية، وليست أثرا ولا سببا.
وظهر خصم جديد هو (الطبقة الجديدة) أي الفريق النخبوي من الأفراد الذين يصنعون المعرفة، وهي طبقة وريثة لأميركا الثلاثينات ونجاحاتها، مثلت (الإنسانوية العلمانية الدنيوية)، وقد رآها الأصوليون كابحة للمشاريع الفردية بهدف تعزيز سلطة الدولة، وعلى الصعيد الأخلاقي وجدوها تنصّب نفسها حامية للحرية الكاملة، أي مع ما يميل إلى الفسق واللاأخلاقية، في إباحية تدمّر الأسرة. إذاً، لا بد من معركة، فالتقت حركة الأصوليين مع المحافظين التقليديين، وفي هذه المواجهة لوحظ توجه فولويل إلى (البيض الصغار) الذين يدفعون الضرائب ولا يستفيدون من شبكات الدولة السياسية والثقافية والاقتصادية، ومن هنا كان تأسيسه للجامعة، وإنشاؤه (بيت النساء) لحضن الحوامل الوحيدات وتأمين من يتبنى أبناءهن.
مشروع الجامعة مشروع تربوي لا يؤمن (بالقطيعة) أو (بالمفاصلة)، فالطلاب يدرسون وفق أحدث التقنيات، ولو قيدوا في علاقاتهم الجنسية، وسلوكهم اليومي، فهم يخرجون إلى الحياة لينافسوا الآخرين في كل مجالاتهم.
والإنجيليون الأميركيون لهم فرادتهم:
أولا: لاستخدامهم اللغة والتقنيات الأكثر حداثة، وهذه السوق الأميركية مفتوحة للوعاظ المقاولين الذين يتنافسون داخل منطق رأسمالي، فيكوّنون الثروات. إن التجانس بين حركة دينية وروح رأسمالية موجود فقط في أميركا.
ثانيا: في انتقال حركة معاودة التنصير إلى السياسة، وسلوكها طريقة فريدة أيضا، فقد حاول الإنجيليون، بعد الحرب، العمل (من تحت) ثم وظفوا أنفسهم في (الفوق) في معارك الحرب الباردة. وفي مفارقة أخرى، فالرئيس كارتر أعلن أنه منتم إلى الإنجيلية مع أنه يملك صورة ليبرالي، وهو مصطلح يمقته الإنجيليون.
وفي التشابه مع المسلمين، نجد أن المناضلين المسلمين كانوا من الفلاحين الذين هاجروا من الريف إلى أطراف المدن، وهكذا بدأ نظراؤهم الإنجيليون أيضاً، وها هم أولاء اليوم جميعا، خريجو جامعات مع ميل إلى العلوم التطبيقية، يكوّنون (نخبة مضادة) للممسكين بالسلطة والمنتجين للقيم الغالبة، وفي العالم الإسلامي تسمى هذه السلطة الأخيرة (الأنتلجانسيا المغربنة) وفي أميركا هي (الطبقة الجديدة) من المتغذين بالإنسانوية العلمانية الدنيوية.
افتداء إسرائيل
سنة 1984م اكتشف الرأي العام الإسرائيلي (التنظيم السري اليهودي) بعد أن أوقفت الشرطة أعضاء مجموعة يهودية يشتبه بأنها اغتالت طلابا من جامعة الخليل الإسلامية، وحاولت اغتيال رؤساء بلديات فلسطينيين، ووضعت خطة لتفجير المسجد الأقصى. والمجموعة تنتمي إلى (غوش ايمونيم) (كتلة الإيمان أو كتلة المؤمنين) وهي حركة سياسية دينية ولدت بعد حرب تشرين التي انتهت بهزيمة نفسانية للدولة اليهودية.
(غوش ايمونيم) كانت تتابع مسيرة ذات أيديولوجية متشددة تريد إعادة تهويد إسرائيل في مواجهة الدولة التي يسيطر عليها مفهوم علماني واشتراكي، وهذه الحركة من مجموعة إعادة التهويد في إسرائيل والشتات تطمح للسيطرة على الدولة، وحين انتقلت إلى العمل العنفي والإرهابي، جذبت انتباه وسائل الإعلام والدارسين، الذين أسموها (أصولية) بالبعد المبتذل للكلمة، وهي تقع في منزلة بين المنوعات المسيحية والإسلامية من هذه الظاهرة.
وهناك أيضا غلاة السلفيين الذين يعملون على تجنيد الشباب الجامعي والسيفاراد (الطوائف اليهودية الشرقية) من أوساط المهاجرين،حتى صار لهم في البرلمان وزن الأحزاب السياسية، وأطلق عليهم اسم (حريديم) (أي الذين يخشون الله) ولم يعد يستغنى عنهم في أي ائتلاف حكومي.
في سنوات السبعين شهد العالم اليهودي حركة (تشوفا) (أي عودة إلى اليهودية) وحركة (توبة) (أي عودة إلى التقيد بالشريعة اليهودية)، والتائبون هؤلاء -المتقيدون بـ1613 فريضة- استدعوا (القطيعة) أو (المفاصلة) الصارمة بين اليهود وغير اليهود.
وقد انشرت هذه الحركات في بلدان كثيرة غير إسرائيل، وكانت لها، محليا، ظواهر متنوعة، من فتح معاهد تلمودية في القدس، أو وصول تحالفها الديني بقيادة مناحيم بيغن إلى السلطة. وسنة 1978م صدر كتابان لاقيا شهرة واسعة، لمؤلفين تائبين، كانا أمثولتين أدبيتين في هذا الموضوع.
كتاب (الوجود اليهودي) أي: أن تكون يهوديا، لشيمون هورفيتز، يقدم كاتبه نفسه فيه كيهودي كان يعي مآزق المجتمع الغربي وقيمه، وقد اكتشف بعد دراسته في معهد تلمودي أن هذه القيم تتعارض كليا مع الثقافة اليهودية (فالغرب يسعى لإشباع الفرد في سياق من المادية لا حدود له، ولكن التوراة وحدها هي التي يمكن أن تعطي الفرد معنى). والكتاب الثاني (طريق العودة) لمئير شلر، الذي أراد فيه أن ينتقد المجتمع العلماني الدنيوي، انطلاقا من موقع المعرفة المزدوجة الدينية والدنيوية، وهو الذي درس التوراة في نيويورك، بعد أن (لامسه الوحي الإلهي) وقد استخدم علوم العصر، واللغة الشائعة في العلوم الإنسانية ليبين التفكك (الذي يرقى إلى كتابات دوركايم) وما يحدثه من آفات اجتماعية وأعراض عصابية، ليصل إلى أن اليهودي مجبر تلقائيا على التقيد بأوامر الوحي الإلهي، وهو لا يستطيع -عند ذلك- أن يقيم في (المدينة الدنيوية) بل عليه أن (يقاطعها) ليعيش مع طائفته مشاركا في مجهوداتها.
أما كتاب (عودة) لهرمن برانوفر، فقد اغتنت به الحركة، لأن المؤلف -وهو عالم كبير في ميدان مغناطيس الدينامية المائية- عالج المسألة اليهودية علميا (فهو لم يجد حججا ضد الدين في النظريات العلمية، حتى في أكثرها حداثة، بل اتضح له أن العلم لا يعالج سوى التفاعل بين الظاهرات، بينما الدين يكشف جوهر الأشياء وموضوعها).
والكاتب روسي يهودي، أنهى كتابه بتأكيد البعد الديني للهوية اليهودية، لذلك اعتبر (الصهيونية اليهودية) المؤسسة على مفهوم دنيوي علماني انحرافا أثيما). وقد ناضل من أجل فكره في العالم كله، مساهما في جعل حركة (توبة) هيئة يهودية عالمية منذ أواسط السبعينات.
وفي أميركا، هناك تجسيدان للهوية اليهودية: اليهودية الإصلاحية، وهي التي تمارس النقد التوراتي رافضة الطقوس، إلى حد أن قيادتها قدمت في حفل توزيع الجوائز على خريجي جامعة الاتحاد العبرية أطعمة غير محللة. وفي مقابل هذا التيار تيار (يهودي محافظ) يجاهد لاحترام الطقوس وأحكام الشريعة، موفقا بينها وبين قواعد الحياة العلمانية، مما أتاح له الإفلات من الخيار المستحيل بين الصراطية الأرثوذكسية وبين الانصهار الذي يمحو الهوية، وهو لم يعمل على (القطيعة) مع المجتمع المحيط.
وفي إسرائيل سكن السفرديم (الوافدون من البلاد العربية) في (مدن التنمية) في أطراف الدولة، والتفاوت كان قويا بين المقيمين في هذه المدن ومجتمع الأشكيناز المسيطر. لكن حرب 1967م هزت التوازن الثقافي عميقا، فالقوات المسلحة -ولو كانت علمانية دنيوية- حققت ظفرا سمح بانبعاث جملة من القيم الدينية، ذلك أن دولة إسرائيل باتت تتطابق بصورة تقريبية مع حدود أرض الميعاد التوراتية، قال دايان (وزير الدفاع يومها): كل من لم يكن متدينا أصبح كذلك اليوم.
هذا الشعور الصدمة تجلى على يد الحاخام كوك وابنه زافي الذي قال بأن دولة إسرائيل كانت الأداة اللاواعية للمشيئة الإلهية، فجيشها كان المنقذ لخطة إلهية قوامها المطابقة بين حدود الدولة وأرض الميعاد.
لقد كانت سنوات الستين في العالم اليهودي -كما في الإسلام والمسيحية- هي سنوات التكوين الأيديولوجي لحركات إعادة تكوين الأمر الديني. وستلعب الحرب الإسرائيلية في 1973م دورا كبيرا في عمليات انهيار الطوباويات التقدمية، فالأزمات الاقتصادية والاجتماعية ترجمت شعبيا بانتفاضات مؤلمة، أسهمت بتحول في إسرائيل والعالم الإسلامي كما في العالم المسيحي.
(غوش ايمونيم) أظهرت نفسها سنة 1974م، فصاغت رؤيتها لمستقبل إسرائيل بأنها تجاوز للصهيونية العلمانية الدنيوية، لاعتماد فكرة (أرض إسرائيل التوراتية محل أرض إسرائيل) ورفضت كمقايضة للأرض أو التنازل عنها لأنها يهودية إلى الأزل، وشجعت سياسة الاستيطان مكرهة السلطة السياسية على خوض (معاودة التهويد من فوق) وقد استطاعت هذه الحركة اجتذاب الكثير من المؤيدين ونالت تعاطفا واضحا في شرائح الدولة والإدارة، ثم تجلل نجاحها في الانتخابات؛ (لدمج الدين في السياسة بقدر أكبر).
حين ظهرت هذه الحركة في الحيز السياسي كثرت المظاهرات وتشجع الاستيطان الذي كان خجولا، حتى جاء بيغن فأعطاه مشروعيته مصادقا على أهداف غوش أيمونيم بمعاودة التهويد من فوق، ومن الضغوط التي مارستها الحركة أن صادقت الدولة على استيطان يهودا والسامرة، كما كانت الحركة مستاءة جدا من إعادة سيناء، لأنه يخالف مشروع السيطرة اليهودية على كامل أرض إسرائيل.
ويجد المؤلف جيل كيبيل وجوه شبه مذهلة على مستوى الأيديولوجية بين المتآمرين هؤلاء وقتلة السادات سنة 1980م، فنحن -يقول- أمام عملية تهويد أو تحنيف من فوق، ارتكبت العنف ضد رمز لتسريع تحول الدولة.
اكتساح العالم
وفي الباب الأخير، يلخص جيل كيبيل كتابه (يوم الله) في استعادة العناوين الرئيسية، ليشير إلى أن حركات معاودة الإسلام تنامت عندما ظهرت علامات تفكك في العالم الإسلامي، وكأن نجاحات الإسلاميين كانت أصرح جزاء للفشل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنخب الحاكمة منذ الاستقلال. فثمة ربع قرن تفصل في مصر بين ظهور عبد الناصر وانتصار الجماعة الإسلامية في حرم جامعة القاهرة، وفي الجزائر، لم تحقق جبهة الإنقاذ أولى نجاحاتها إلا في انتخابات 1990م البلدية، وفي فلسطين كان ينبغي انتظار الانتفاضة لتبدأ الحركة الإسلامية محاربة منظمة التحرير.
وهنا يشير إلى مفهوم الحكم ليقول: إن علي بلحاج خطيب الحركة الإسلامية الجزائرية، كان دائما ضد الديمقراطية، فعنده السيادة لا يمارسها إلا الله عبر حاكم واجبه تطبيق شريعته، و كيبيل يجد العذر لعدم فهم المسلمين للديمقراطية لأنهم يعيشون ديكتاتوريات ولم يعتادوا بعد عليها، ويضيف بأن استخدام العنف ضد الدول الكافرة وضد المسلمين المتغربنين أصبح اليوم عنصرا لا يمكن عزله عن الحركيين الإسلاميين.
وفي مملكة إسرائيل يستعيد ما قاله عن محاولة التهويد من فوق مع (غوش ايمونيم) التي ترى الدولة أداة لاواعية لمشيئة المسيح المخلص، فيجب تسريع طفرتها لا امتشاق السلاح لتدميرها كما يدعو سيد قطب وتلامذته.
أما مواجهة المريدين فهي عند المسلمين ضد الأنظمة، وبالعنف، بينما هي عند حركات التهويد ضد الأجنبي، وفي مقدمتهم الفلسطينيون. فحركات التنصير من فوق لا تلجأ إلى العنف أبدا، لا في أوروبا ولا في أميركا، وهي بذلك لا تطعن بكلمات المسيح: ما لقيصر لقيصر وما لله لله، جل ما تريد هو الإصلاح دون طرح مفهوم الديمقراطية، لأنها تتكلم لغة المواطنين، وقد يكون في هذا (قسر ديمقراطي) لأن المطلوب هو تحجيم العلمانية فقط. ومثل هذه العملية إذا نجحت لا يمكن تصورها إلا مع معاودة التنصير من تحت.
وفيما يتعدى أوجه الشبه هذه، فإن بين الحركات تباينات عديدة، موجودة في كل مذهب على حدة، فإقفال النظام السياسي في العالم الإسلامي وغياب أفق الرفاه، يشجع اللجوء إلى العنف، يغذيه مفهوم توحيدي أوحدي للكون، أما في العالم المسيحي فاكتسبت هذه الحركات ثنائية تندرج في المذهب الديني نفسه، وفي الإسلام كما في اليهودية والمسيحية أفضت حركات (من تحت) إلى القطيعة مع منطق المجتمع المحيط.
أن نتائج العودة أو التوبة هي أكثر ما تكون دويا في العالم اليهودي -فالحريديم من غلاة السلفين اليهود- أنشأوا شبكة طائفية بالغة الاتساع مقفلة تستند إلى الشريعة، وهي تعمل (بالمفاصلة) مع عادات منطق المجتمع المحيط (تعليما وزواجا دون تقييد للنسل) وذلك لحفظ أنفسهم ضد إغراءات اليهودية المعلمنة. أما في الشتات فلم يلجأ إلى (الغيتو)، كذلك حركات الإسلام من تحت لم تعتمد (المفاصلة) مع البيئة، فالمسألة عندها ليست إنقاذ شعب من مخاطر الصهر، وإنما الانخراط في مسار متنام لنشر الإسلام في الإنسانية جمعاء.
هذه الحركات جميعا بموازاة بعضها بعضا، وطموحها لاكتساح العالم، تحمل معها -على المدى المتوسط- منطق نزاع، هو النزاع أو الحرب بين (المؤمنين) الذين يجعلون من إعادة تأكيد وترسيخ هويتهم الدينية (معيارا) لحقائق هي حقائق خصوصية بمقدار ما هي حصرية استبعادية.
*********************
*) قراءة في كتاب جيل كيبيل: ثأر الله: الحركات الأصولية المعاصرة في الديانات الثلاث. ترجمة نصير مروة، ط1،1992م. **) باحث وجامعي من لبنان. |
**************
العدد 21 / 2008
عن موقع مجلة التسامح الالكترونية
السبت 28 شتنبر 2013