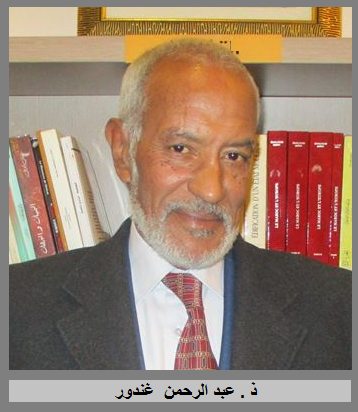
(*) المقال منقول عن جريدة ” السؤال الآن “
“لا يمكن أن تمر ذكرى 20 يونيو 1981 دون أن تحرك فينا كوابيس الذكرى وتراكمات إجهاض الحلم”.
لا أتقن فن الوهم… وأعرف أن التاريخ لا يعيد نفسه…
لا أتقن فن صنع التبريرات ولكني أحسن فن النقد والنقد الذاتي…
لا ترعبني الانكسارات ولكني أرغب دوما في الترميمات…
لا تحطمني الهزائم و لكني أطمح بدون هوادة في الانتصارات…
إلا أن ما يفزعني ويكسرني ويحطمني هو قتل الذاكرة… فهو الهزيمة والانكسار…
تحل اليوم ذكرى مرور 41 سنة عن يوم البطولات 20 يونيو 1981، وما يهمني فيها ليس النضالات والبطولات والتضحيات، ولكن ما فقدناه وما زال مطلوبا وهو “استقلالية القرار السياسي والنقابي”.
من يستطيع اليوم أن يقرر بعيدا عن دوائر التوجيهات والتعليمات؟؟؟ من يستطيع أن يحسب لنبض الوطن والمواطن قبل أن يحسب لنظرة وموقف المؤسسات الحاكمة والمتحكمة تحت اسم “الدوائر العليا”، ومع ذلك يكثر الحديث بإطراء كبير عن الفعل السياسي والفاعلين السياسيين وقد أصبحوا جميعا مفعولا بهم ومفعولا فيهم.
وللذكرى فقط لا بد من التأكيد على أن حدث 20 يونيو 1981 قد شكل تاريخيا، بداية التحولات الكارثية التي عصفت باستراتيجية النضال الديموقراطي.
علمتني الفلسفة، والتاريخ، وعلوم الحياة والأرض، والأركيولوجيا، والباليونطولجيا… وغيرها من العلوم الدقيقة، أن لا شيء يحدث صدفة، ولا شيء يولد بغتة، وأن لا شيء يضيع، وكل شيء في تحول مستمر. فكل الموجودات، في الطبيعة والحياة والمجتمع، هي نتاج تراكمات جزئية، وصغيرة جدا، لا تكاد ترى أو تدرك، ولكنها في حالة نمو دائم ومستمر، وفي حالة تفاعلات كثيرة، قد تقوى وقد تخفت حسب الشروط الذاتية والموضوعية، إلى أن يكتمل نضجها فتظهر في كيف جديد وكأنها وليدة اللحظة.
فما يجري اليوم في المجتمع المغربي، وفي مؤسساته المجتمعية والسياسية، وفي بنياته الاقتصادية والثقافية، وفي تنظيماته الحزبية والنقابية والجمعوية، ومن بينها حزب القوات الشعبية الذي عشت أغلب عمري فيه، ويستأثر باهتمامي أكثر، ويشكل الموضوع الرئيسي لمذكراتي…كل ما جرى ويجري، ليس وليد اللحظة، وليس قضاء وقدرا، بل هو نتيجة حتمية لما تراكم بصورة تفاعلية، عبر التاريخ القريب والبعيد.
نحن لا نستطيع مثلا، فهم ما سمي بالتناوب التوافقي في 1998، دون البحث عن الجذور الجنينية له، في النقاشات والمواقف التي عرفها المغرب من 1955إلى 1960. وطبيعة العلاقات بين “القصر” في صورته “الشعبية والشرعية” ومجموع الفاعلين السياسيين، من أحزاب وطنية ودوائر استعمارية ولوبيات اقتصادية.
وبالعودة إلى مذكرات المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، والعرض الذي قدمه المرحوم عبد الرحمان اليوسفي في بروكسيل سنة 2003، سنكتشف البذور المزروعة في أرض السياسة الوطنية منذ ” زمن الجفاف بين القصر والحركة الوطنية ” أو سنوات ” التجاذب الإقصائي ” بين الملك ومعارضيه، والتي سيتم سقيها واستنباتها، وتخفيف قساوتها، في بداية التسعينات، من أجل حصد نتائجها، مع حكومة التناوب التوافقي، وعدم تجديد حرثها في بداية الألفية الثالثة، بالعدول عن ما سمي بالمنهجية الديموقراطية في 2002، ودفع المرحوم عبد الرحمان اليوسفي عمدا إلى اعتزال العمل السياسي.
لهذه المنطلقات المبدئية والمنهجية، وأنا أستحضر ذكرياتي عن أحداث 1981، لا يسعني إلا أن أجد لها موطنا ضمن التراكم التاريخي من جهة، وأتأملها باعتبارها تشكل البذور الجنينية لما سيأتي.
لا أحد ينكر أن سي عبد الرحيم رحمه الله، كان رجل الملاءمات الكبرى، فهو لم يكن أبدا ذلك “الثوري” الدوغمائي، ولم يكن ذلك القائد المنبطح والقابل للمساومات الرخيصة. ولذلك دافع عن الخيار الديموقراطي خلال المؤتمر الاستثنائي باستماتة، ضدا عن التوجهات البلانكية “الثورية”. كما دافع بنفس الاستماتة عن استقلالية القرار الحزبي بشراسة، مما أدى به إلى الاعتقال، بعد موقفه من قضية قبول الاستفتاء الذي أعلنه المرحوم الحسن الثاني في نيروبي. لكنه كان في كل الحالات رجل المعادلات الصعبة، والتوافقات الممكنة مع المؤسسة الملكية وبالعودة لمذكراته نستخلص أن هذا المبدء متأصل في ثقافة الرجل منذ أن كان.
في كتاب شهادات وتأملات للمرحوم بوعبيد يقول في صفحة 218:
“غداة 20 ماي 1960 لما حاولنا الاحاطة بمختلف التحليلات حتى نردها الى ما هو أساسي توصلنا الى هذه الخلاصة: المشكل الرئيسي والأساسي هو مشكل دمقرطة الحياة الوطنية بالنسبة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لا يمكن لهذه الدمقرطة أن تتم الا بانتخاب مجلس وطني تأسيسي من شأنه ان يمنح الشعب كامل السيادة. وما كان مجرد وسيلة، صارت له قيمة العقيدة (الدوغما) من كثرة ما تم ترديد واعادة ترديد هذا الشعار، كما لو أن المجلس التأسيسي يمكن أن يمتلك السلطة المعجزة لإصدار الاختيارات والوسائل والسبل لتنفيذها، بل يمكننا أن نتساءل هل كل الأطر, بله حتى القياديين، كانوا مقتنعين كل هذا الاقتناع بأن المجلس التأسيسي هو السبيل الوحيد للدمقرطة”.
وهذا يعني أنه لم يكن متعصبا كما تعلمنا ونحن شباب قراءة وفهم مبدء “المجلس التأسيسي” لوضع دستور للبلاد، ولكن سي عبد الرحيم ساير الرأي الغالب في الحزب والداعي الى مقاطعة كل الدساتير وكل الانتخابات. وهذا ما يرويه بوعبيد في الصفحة 224 من خلال حديث جرى بينه وبين المرحوم المهدي بنبركة بباريس في فبراير 1961:
“كنت جالسا إلى جانب المهدي بن بركة الذي كان يسوق السيارة، فيما جلس المهدي العلوي في المقاعد الخلفية, استأنفنا مناقشاتنا اللانهائية حول السبل والوسائل الكفيلة بإقرار نظام ديمقراطي. وجهة نظري كانت هي أن التوافق وهو السبيل الوحيد في سياق الظرفية الداخلية المغربية.
قلت:
إن الوقوف عند شرط المجلس الاستشاري المغربي، المنتخب عبر الاقتراع السري، سيكون خطأ فادحا، فليس بمقدورنا أن نفرض على ملك يحظى بشعبية، حظي بمباركة مجموع الشعب، لدى عودته من المنفى، أن يسلم الملكية إلى مجلس منتخب، حتى ولو انتخب ديمقراطيا. لن يسعه أبدا القبول بذلك…
أجابني المهدي:
– فات الأوان، لن يمكننا العودة إلى الوراء…
ما فات أوانه هو أن نريد إعادة صناعة التاريخ من جديد. فعندما تضيع الفرصة، يكون من غير المجدي السعي لاستعادتها, سيكون ذلك بالضبط سقوط في فخ التاريخ… أية ايديولوجيا؟
… بيد أن مواصلة النضال من أجل مجلس تأسيسي، مع ترك المشاكل الأساسية للاقتصاد والقضايا الاجتماعية والثقافية جانبا، دون الحديث عن القواعد الأجنبية أو سياسة اللا- تبعية يكون المجلس التأسيسي بلوكاج (انحسارا)… فشئنا أم أبينا ذلك، فإن السلطة بين يدي الملكية…”.
إنها دعوة مفتوحة ومشروطة للتوافق مع المؤسسة الملكية، سيتم اللجوء إليها في التعامل مع استراتيجية النضال الديموقراطي. إلى جانب العلاقة الشخصية التي كانت تربط الملك الراحل بشخص المرحوم سي عبد الرحيم، والتي كانت تنتفي فيها الرسميات وتعقد البروتوكول المخزني.
من هذه المنطلقات المشخصة، نحاول فهم مجريات سنة 1981، في ترابطها وتداخلها. فمن المستغرب جدا أن يكون الموقف من الاستفتاء في الصحراء سببا في “الغضبة الملكية” على “صديقه” سي عبد الرحيم، خاصة أن موقف بلاغ المكتب السياسي الذي كان سبب الاعتقال لم يرفض قرار قمة نيروبي، بل اعترض على قرار لجنة المتابعة الافريقية، فالبيان بعد استعراضه لمخاطر قرار هذه اللجنة يقول:
“إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يقترح، بكل التأكيد الذي تتطلبه المرحلة التاريخية التي تعرفها بلادنا، أن ينظم استفتاء شعبي ديمقراطي طبقا للدستور، يدعو مجموع الشعب المغربي للتعبير عن موقفه بكل وضوح حول قرارات لجنة التطبيق المجتمعة في نيروبي الثاني المتعلقة بمستقبل الصحراء الغربية، أي بمستقبل وحدتنا الترابية”. وليس في هذه الفقرة ما يثير غضبة الملك.
إن السبب الحقيقي في اعتقال سي عبد الرحيم، يرجع إلى عدم تدخله لتوقيف إضراب 20 يونيو 1981 الذي تحول إلى مجزرة لطخت صورة النظام المغربي على الصعيد الدولي. بل إن بعض محاضر استنطاق الشرطة لعدد من القياديين النقابيين وحتى السياسيين على خلفية الإضراب، أبانت أن سي عبد الرحيم “سمح بالإضراب بعد استشارته”، وسمح لجريدة “المحرر” بأن تتبناه كموقف حزبي، بمعنى أن قرار الإضراب صادر عن القيادة السياسية، ونفذته القيادة النقابية وراح ضحيته المواطنون المغاربة من قتلى ومعتقلين ومجروحين. وأطاح بالصورة الديموقراطية، والاستقرار الأمني التي كان يسوقها النظام المغربي في الخارج.
نقرأ في الصفحة 223 من شهادات وتأملات للمرحوم عبد الرحيم:
“خلال الأيام التي تلت إطلاق سراحه يوم 3 مارس 1982، بعد إقامة إجبارية طويلة بميسور، استُقبل المرحوم عبد الرحيم بوعبيد من طرف الحسن الثاني بالقصر الملكي بمراكش في مقابلة خاصة. ولما عاد عبد الرحيم إلى بيت أسرته، روى محتوى اللقاء الذي دار بين الرجلين بالكلمات التالية: سأل الملك الراحل مخاطبه..
“- إذن، عبد الرحيم،
– أنت غير حاقد علي»
أجابه عبد الرحيم:
– أبداً يا جلالة الملك، لكنني أشعر بنوع من الأسف مع ذلك، وأتحسر على أنني لم أحظ بالوقت الكافي للانتهاء من كتابة مذكراتي”.
من خلال هذه الأحداث الثلاث، الإضراب العام، والموقف من استفتاء الصحراء، وانسحاب البرلمانيين، رغم عودتهم الفردية، وبوضعها في سياقها التاريخي من خلال صراع منظومة الدمقرطة مع منظومة المخزنة، ومن خلال محاولة المخزن احتواء القرار الحزبي لفائدته، وحرص الاتحاد الاشتراكي على استقلالية قراره. من خلال كل هذا يمكن فهم مختلف المتغيرات التي سيعرفها الحزب في اللاحق من الأيام.
أفرج عن سي عبد الرحيم في شهر مارس 1982، دون أن يفرج عن الحزب والكونفدرالية والسماح بفتح المقرات وعودة الصحافة الحزبية. وظل المناضلون مكتفين تنظيميا بلقاءات المنازل أو المقاهي، ولا إعلام لهم سوى ما تزودهم به جريدة ” البلاغ المغربي” التي أصدرها المرحوم محمد بن يحيى. ولم تعرف الساحة الحزبية أو النقابية أية مبادرة نضالية، إلا في بعض القطاعات المحلية المحدودة. بالإضافة إلى التساؤل الكبير حول آفاق المستقبل من حيث الاستمرار في هذا “الخط الديموقراطي” أو “مقاطعته ” والبحث عن بدائل استراتيجية أخرى.
ومن النتائج المباشرة لهذه الأحداث الثلاث، هي تحركات الاتجاه الحزبي الذي يرمي إلى “مقاطعة الانتخابات”، والذي عبر عن نفسه في المؤتمر الثالث، ولم يستطع أن يشكل أي ضغط على مسلسل النضال الديموقراطي. وهو نفس التوجه الذي سيحاول أصحابه فرضه في اجتماع اللجنة المركزية بتاريخ 8 ماي 1983، مما سيؤدي إلى انشقاق أصحابه لتأسيس حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي ظل رافعا لشعار المجلس التأسيسي لوضع دستور للبلاد ومقاطعا للانتخابات إلى حدود 2007، دون أن يؤثر ذلك في إيقاف التدهورات الديموقراطية، أو يسمح بتحقيق مكاسب جديدة.
يمكن القول، إن السنوات الثلاث الأولى من عقد الثمانينات، ابتداء من حدث 20 يونيو 1981 ستشكل منعطفا كبيرا في صيرورة النضال الديموقراطي، سواء بالنسبة للحزب أو المنظومة الحاكمة، أو بالنسبة للوطن عموما. وأن مرحلة جديدة ستبدأ وتحقق تراكمات قوية منها ما لامسناه ووعيناه دون أن نقدر خطورته، ومنها ما مر في غفلة عنا، وكلها كانت تجر الحزب والبلد إلى ما نعيشه اليوم.
ويأتي على رأس استراتيجية هذه المرحلة الجديدة، تنفيذ سياسة اختراق حزب القوات الشعبية، وإغراق مركبه عن طريق الركوب فيه بواسطة شراء عدد من أطره وقيادييه، وتدجين عدد آخر بالكثير من الإغراءات، وتشجيع عدد من منتخبيه على الاغتناء غير المشروع، والتغاضي عنهم، وتخويف “العصاة” عن طريق تلفيق التهم لهم وتعريضهم للمحاكمات، كما حدث مع الأموي في قضية “المانغانطيس”. ولم تمر 10 سنوات، حتى نجحت هذه الاستراتيجية في تدجين حزب القوات الشعبية، ودفعه تحت شعار حماية الوطن من السكتة القلبية، إلى القبول بسياسة التوافق التي أدت إلى ما سمي بالتناوب التوافقي الذي كان القشة التي قصمت ظهر البعير، ليأتي المؤتمر السادس، وقد اكتملت كل عناصر الزلزال الذي ضرب هذا الحزب وأخرجه من دائرة صنع التاريخ المعاصر للمغرب. وما تلا هذا المؤتمر من مؤتمرات وقيادات، لم يكن سوى حركات ارتدادية عصفت بما تبقى من الأطر والقواعد والقيم والمواقف المبدئية، ليصبح الحزب بوابة للتسول والارتزاق وتحقيق المكاسب الشخصية والمصالح الخاصة، وهي الصورة “الناصعة” التي يوجد عليها الحزب اليوم بشهادة الجميع.
“لا يمكن أن تمر ذكرى 20 يونيو 1981 دون أن تحرك فينا كوابيس الذكرى وتراكمات إجهاض الحلم”.
لا أتقن فن الوهم… وأعرف أن التاريخ لا يعيد نفسه…
لا أتقن فن صنع التبريرات ولكني أحسن فن النقد والنقد الذاتي…
لا ترعبني الانكسارات ولكني أرغب دوما في الترميمات…
لا تحطمني الهزائم و لكني أطمح بدون هوادة في الانتصارات…
إلا أن ما يفزعني ويكسرني ويحطمني هو قتل الذاكرة… فهو الهزيمة والانكسار…
تحل اليوم ذكرى مرور 41 سنة عن يوم البطولات 20 يونيو 1981، وما يهمني فيها ليس النضالات والبطولات والتضحيات، ولكن ما فقدناه وما زال مطلوبا وهو “استقلالية القرار السياسي والنقابي”.
من يستطيع اليوم أن يقرر بعيدا عن دوائر التوجيهات والتعليمات؟؟؟ من يستطيع أن يحسب لنبض الوطن والمواطن قبل أن يحسب لنظرة وموقف المؤسسات الحاكمة والمتحكمة تحت اسم “الدوائر العليا”، ومع ذلك يكثر الحديث بإطراء كبير عن الفعل السياسي والفاعلين السياسيين وقد أصبحوا جميعا مفعولا بهم ومفعولا فيهم.
وللذكرى فقط لا بد من التأكيد على أن حدث 20 يونيو 1981 قد شكل تاريخيا، بداية التحولات الكارثية التي عصفت باستراتيجية النضال الديموقراطي.
علمتني الفلسفة، والتاريخ، وعلوم الحياة والأرض، والأركيولوجيا، والباليونطولجيا… وغيرها من العلوم الدقيقة، أن لا شيء يحدث صدفة، ولا شيء يولد بغتة، وأن لا شيء يضيع، وكل شيء في تحول مستمر. فكل الموجودات، في الطبيعة والحياة والمجتمع، هي نتاج تراكمات جزئية، وصغيرة جدا، لا تكاد ترى أو تدرك، ولكنها في حالة نمو دائم ومستمر، وفي حالة تفاعلات كثيرة، قد تقوى وقد تخفت حسب الشروط الذاتية والموضوعية، إلى أن يكتمل نضجها فتظهر في كيف جديد وكأنها وليدة اللحظة.
فما يجري اليوم في المجتمع المغربي، وفي مؤسساته المجتمعية والسياسية، وفي بنياته الاقتصادية والثقافية، وفي تنظيماته الحزبية والنقابية والجمعوية، ومن بينها حزب القوات الشعبية الذي عشت أغلب عمري فيه، ويستأثر باهتمامي أكثر، ويشكل الموضوع الرئيسي لمذكراتي…كل ما جرى ويجري، ليس وليد اللحظة، وليس قضاء وقدرا، بل هو نتيجة حتمية لما تراكم بصورة تفاعلية، عبر التاريخ القريب والبعيد.
نحن لا نستطيع مثلا، فهم ما سمي بالتناوب التوافقي في 1998، دون البحث عن الجذور الجنينية له، في النقاشات والمواقف التي عرفها المغرب من 1955إلى 1960. وطبيعة العلاقات بين “القصر” في صورته “الشعبية والشرعية” ومجموع الفاعلين السياسيين، من أحزاب وطنية ودوائر استعمارية ولوبيات اقتصادية.
وبالعودة إلى مذكرات المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، والعرض الذي قدمه المرحوم عبد الرحمان اليوسفي في بروكسيل سنة 2003، سنكتشف البذور المزروعة في أرض السياسة الوطنية منذ ” زمن الجفاف بين القصر والحركة الوطنية ” أو سنوات ” التجاذب الإقصائي ” بين الملك ومعارضيه، والتي سيتم سقيها واستنباتها، وتخفيف قساوتها، في بداية التسعينات، من أجل حصد نتائجها، مع حكومة التناوب التوافقي، وعدم تجديد حرثها في بداية الألفية الثالثة، بالعدول عن ما سمي بالمنهجية الديموقراطية في 2002، ودفع المرحوم عبد الرحمان اليوسفي عمدا إلى اعتزال العمل السياسي.
لهذه المنطلقات المبدئية والمنهجية، وأنا أستحضر ذكرياتي عن أحداث 1981، لا يسعني إلا أن أجد لها موطنا ضمن التراكم التاريخي من جهة، وأتأملها باعتبارها تشكل البذور الجنينية لما سيأتي.
لا أحد ينكر أن سي عبد الرحيم رحمه الله، كان رجل الملاءمات الكبرى، فهو لم يكن أبدا ذلك “الثوري” الدوغمائي، ولم يكن ذلك القائد المنبطح والقابل للمساومات الرخيصة. ولذلك دافع عن الخيار الديموقراطي خلال المؤتمر الاستثنائي باستماتة، ضدا عن التوجهات البلانكية “الثورية”. كما دافع بنفس الاستماتة عن استقلالية القرار الحزبي بشراسة، مما أدى به إلى الاعتقال، بعد موقفه من قضية قبول الاستفتاء الذي أعلنه المرحوم الحسن الثاني في نيروبي. لكنه كان في كل الحالات رجل المعادلات الصعبة، والتوافقات الممكنة مع المؤسسة الملكية وبالعودة لمذكراته نستخلص أن هذا المبدء متأصل في ثقافة الرجل منذ أن كان.
في كتاب شهادات وتأملات للمرحوم بوعبيد يقول في صفحة 218:
“غداة 20 ماي 1960 لما حاولنا الاحاطة بمختلف التحليلات حتى نردها الى ما هو أساسي توصلنا الى هذه الخلاصة: المشكل الرئيسي والأساسي هو مشكل دمقرطة الحياة الوطنية بالنسبة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لا يمكن لهذه الدمقرطة أن تتم الا بانتخاب مجلس وطني تأسيسي من شأنه ان يمنح الشعب كامل السيادة. وما كان مجرد وسيلة، صارت له قيمة العقيدة (الدوغما) من كثرة ما تم ترديد واعادة ترديد هذا الشعار، كما لو أن المجلس التأسيسي يمكن أن يمتلك السلطة المعجزة لإصدار الاختيارات والوسائل والسبل لتنفيذها، بل يمكننا أن نتساءل هل كل الأطر, بله حتى القياديين، كانوا مقتنعين كل هذا الاقتناع بأن المجلس التأسيسي هو السبيل الوحيد للدمقرطة”.
وهذا يعني أنه لم يكن متعصبا كما تعلمنا ونحن شباب قراءة وفهم مبدء “المجلس التأسيسي” لوضع دستور للبلاد، ولكن سي عبد الرحيم ساير الرأي الغالب في الحزب والداعي الى مقاطعة كل الدساتير وكل الانتخابات. وهذا ما يرويه بوعبيد في الصفحة 224 من خلال حديث جرى بينه وبين المرحوم المهدي بنبركة بباريس في فبراير 1961:
“كنت جالسا إلى جانب المهدي بن بركة الذي كان يسوق السيارة، فيما جلس المهدي العلوي في المقاعد الخلفية, استأنفنا مناقشاتنا اللانهائية حول السبل والوسائل الكفيلة بإقرار نظام ديمقراطي. وجهة نظري كانت هي أن التوافق وهو السبيل الوحيد في سياق الظرفية الداخلية المغربية.
قلت:
إن الوقوف عند شرط المجلس الاستشاري المغربي، المنتخب عبر الاقتراع السري، سيكون خطأ فادحا، فليس بمقدورنا أن نفرض على ملك يحظى بشعبية، حظي بمباركة مجموع الشعب، لدى عودته من المنفى، أن يسلم الملكية إلى مجلس منتخب، حتى ولو انتخب ديمقراطيا. لن يسعه أبدا القبول بذلك…
أجابني المهدي:
– فات الأوان، لن يمكننا العودة إلى الوراء…
ما فات أوانه هو أن نريد إعادة صناعة التاريخ من جديد. فعندما تضيع الفرصة، يكون من غير المجدي السعي لاستعادتها, سيكون ذلك بالضبط سقوط في فخ التاريخ… أية ايديولوجيا؟
… بيد أن مواصلة النضال من أجل مجلس تأسيسي، مع ترك المشاكل الأساسية للاقتصاد والقضايا الاجتماعية والثقافية جانبا، دون الحديث عن القواعد الأجنبية أو سياسة اللا- تبعية يكون المجلس التأسيسي بلوكاج (انحسارا)… فشئنا أم أبينا ذلك، فإن السلطة بين يدي الملكية…”.
إنها دعوة مفتوحة ومشروطة للتوافق مع المؤسسة الملكية، سيتم اللجوء إليها في التعامل مع استراتيجية النضال الديموقراطي. إلى جانب العلاقة الشخصية التي كانت تربط الملك الراحل بشخص المرحوم سي عبد الرحيم، والتي كانت تنتفي فيها الرسميات وتعقد البروتوكول المخزني.
من هذه المنطلقات المشخصة، نحاول فهم مجريات سنة 1981، في ترابطها وتداخلها. فمن المستغرب جدا أن يكون الموقف من الاستفتاء في الصحراء سببا في “الغضبة الملكية” على “صديقه” سي عبد الرحيم، خاصة أن موقف بلاغ المكتب السياسي الذي كان سبب الاعتقال لم يرفض قرار قمة نيروبي، بل اعترض على قرار لجنة المتابعة الافريقية، فالبيان بعد استعراضه لمخاطر قرار هذه اللجنة يقول:
“إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يقترح، بكل التأكيد الذي تتطلبه المرحلة التاريخية التي تعرفها بلادنا، أن ينظم استفتاء شعبي ديمقراطي طبقا للدستور، يدعو مجموع الشعب المغربي للتعبير عن موقفه بكل وضوح حول قرارات لجنة التطبيق المجتمعة في نيروبي الثاني المتعلقة بمستقبل الصحراء الغربية، أي بمستقبل وحدتنا الترابية”. وليس في هذه الفقرة ما يثير غضبة الملك.
إن السبب الحقيقي في اعتقال سي عبد الرحيم، يرجع إلى عدم تدخله لتوقيف إضراب 20 يونيو 1981 الذي تحول إلى مجزرة لطخت صورة النظام المغربي على الصعيد الدولي. بل إن بعض محاضر استنطاق الشرطة لعدد من القياديين النقابيين وحتى السياسيين على خلفية الإضراب، أبانت أن سي عبد الرحيم “سمح بالإضراب بعد استشارته”، وسمح لجريدة “المحرر” بأن تتبناه كموقف حزبي، بمعنى أن قرار الإضراب صادر عن القيادة السياسية، ونفذته القيادة النقابية وراح ضحيته المواطنون المغاربة من قتلى ومعتقلين ومجروحين. وأطاح بالصورة الديموقراطية، والاستقرار الأمني التي كان يسوقها النظام المغربي في الخارج.
نقرأ في الصفحة 223 من شهادات وتأملات للمرحوم عبد الرحيم:
“خلال الأيام التي تلت إطلاق سراحه يوم 3 مارس 1982، بعد إقامة إجبارية طويلة بميسور، استُقبل المرحوم عبد الرحيم بوعبيد من طرف الحسن الثاني بالقصر الملكي بمراكش في مقابلة خاصة. ولما عاد عبد الرحيم إلى بيت أسرته، روى محتوى اللقاء الذي دار بين الرجلين بالكلمات التالية: سأل الملك الراحل مخاطبه..
“- إذن، عبد الرحيم،
– أنت غير حاقد علي»
أجابه عبد الرحيم:
– أبداً يا جلالة الملك، لكنني أشعر بنوع من الأسف مع ذلك، وأتحسر على أنني لم أحظ بالوقت الكافي للانتهاء من كتابة مذكراتي”.
من خلال هذه الأحداث الثلاث، الإضراب العام، والموقف من استفتاء الصحراء، وانسحاب البرلمانيين، رغم عودتهم الفردية، وبوضعها في سياقها التاريخي من خلال صراع منظومة الدمقرطة مع منظومة المخزنة، ومن خلال محاولة المخزن احتواء القرار الحزبي لفائدته، وحرص الاتحاد الاشتراكي على استقلالية قراره. من خلال كل هذا يمكن فهم مختلف المتغيرات التي سيعرفها الحزب في اللاحق من الأيام.
أفرج عن سي عبد الرحيم في شهر مارس 1982، دون أن يفرج عن الحزب والكونفدرالية والسماح بفتح المقرات وعودة الصحافة الحزبية. وظل المناضلون مكتفين تنظيميا بلقاءات المنازل أو المقاهي، ولا إعلام لهم سوى ما تزودهم به جريدة ” البلاغ المغربي” التي أصدرها المرحوم محمد بن يحيى. ولم تعرف الساحة الحزبية أو النقابية أية مبادرة نضالية، إلا في بعض القطاعات المحلية المحدودة. بالإضافة إلى التساؤل الكبير حول آفاق المستقبل من حيث الاستمرار في هذا “الخط الديموقراطي” أو “مقاطعته ” والبحث عن بدائل استراتيجية أخرى.
ومن النتائج المباشرة لهذه الأحداث الثلاث، هي تحركات الاتجاه الحزبي الذي يرمي إلى “مقاطعة الانتخابات”، والذي عبر عن نفسه في المؤتمر الثالث، ولم يستطع أن يشكل أي ضغط على مسلسل النضال الديموقراطي. وهو نفس التوجه الذي سيحاول أصحابه فرضه في اجتماع اللجنة المركزية بتاريخ 8 ماي 1983، مما سيؤدي إلى انشقاق أصحابه لتأسيس حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي ظل رافعا لشعار المجلس التأسيسي لوضع دستور للبلاد ومقاطعا للانتخابات إلى حدود 2007، دون أن يؤثر ذلك في إيقاف التدهورات الديموقراطية، أو يسمح بتحقيق مكاسب جديدة.
يمكن القول، إن السنوات الثلاث الأولى من عقد الثمانينات، ابتداء من حدث 20 يونيو 1981 ستشكل منعطفا كبيرا في صيرورة النضال الديموقراطي، سواء بالنسبة للحزب أو المنظومة الحاكمة، أو بالنسبة للوطن عموما. وأن مرحلة جديدة ستبدأ وتحقق تراكمات قوية منها ما لامسناه ووعيناه دون أن نقدر خطورته، ومنها ما مر في غفلة عنا، وكلها كانت تجر الحزب والبلد إلى ما نعيشه اليوم.
ويأتي على رأس استراتيجية هذه المرحلة الجديدة، تنفيذ سياسة اختراق حزب القوات الشعبية، وإغراق مركبه عن طريق الركوب فيه بواسطة شراء عدد من أطره وقيادييه، وتدجين عدد آخر بالكثير من الإغراءات، وتشجيع عدد من منتخبيه على الاغتناء غير المشروع، والتغاضي عنهم، وتخويف “العصاة” عن طريق تلفيق التهم لهم وتعريضهم للمحاكمات، كما حدث مع الأموي في قضية “المانغانطيس”. ولم تمر 10 سنوات، حتى نجحت هذه الاستراتيجية في تدجين حزب القوات الشعبية، ودفعه تحت شعار حماية الوطن من السكتة القلبية، إلى القبول بسياسة التوافق التي أدت إلى ما سمي بالتناوب التوافقي الذي كان القشة التي قصمت ظهر البعير، ليأتي المؤتمر السادس، وقد اكتملت كل عناصر الزلزال الذي ضرب هذا الحزب وأخرجه من دائرة صنع التاريخ المعاصر للمغرب. وما تلا هذا المؤتمر من مؤتمرات وقيادات، لم يكن سوى حركات ارتدادية عصفت بما تبقى من الأطر والقواعد والقيم والمواقف المبدئية، ليصبح الحزب بوابة للتسول والارتزاق وتحقيق المكاسب الشخصية والمصالح الخاصة، وهي الصورة “الناصعة” التي يوجد عليها الحزب اليوم بشهادة الجميع.
رابط المقال بصحيفة السؤال الآن







