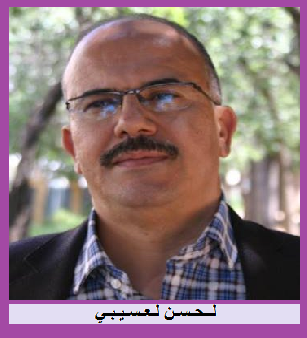هل هي دورة تاريخية، جديدة، دخلناها مغربيا؟.
إنه السؤال الكبير الذي تلزمنا بطرحه الأحداث غير البسيطة، التي تعيشها بلادنا. ولعل أول علامات تلك الدورة، أنها تقدم ملامح لانعطافة جيلية في المجتمع وفي الدولة. لكن، المثير، إن لم نقل، المقلق، كما لو أنها انعطافة تتم بدون ذاكرة.
فالخطاب المعبر عنه، في الدولة وفي المجتمع، فيه الكثير من الإنفعال وأنه بدون بوصلة. وأخشى أنه هناك فقط “فائض قيمة من العنف في اللسان”، لا يفضي عادة سوى إلى “آرواس”، حين يكون صادرا عن فراغ في الرؤية والمعرفة وهوية الإنتماء.
حقا، أمام يأس الواقع، هناك دوما تفاؤل الإرادة. لكن، علينا الإنتباه أنه في ما بين 1830 و 1844، أي بين سنة احتلال الجزائر من قبل فرنسا، وهزيمة المغاربة في معركة إيسلي أمام ذات الجيش الفرنسي الإستعماري، ولد جيل مغربي جديد، حمل هم الإصلاح في الدولة وفي المجتمع بالمغرب الأقصى. وفشل ذلك الجيل في مسعاه على امتداد القرن 19، مما فتح الباب لتسهيل تدويل القضية المغربية في مؤتمرات مدريد (سنة 1880) وبرلين (سنة 1884) والجزيرة الخضراء (سنة 1906)، التي مهدت الطريق لاحتلال المغرب وتقسيمه بين حسابات استعمارية متعددة (لاتزال تبعاتها قائمة إلى اليوم، في ملف الصحراء الغربية للمغرب، وفي ملف سبتة ومليلية المحتلتين والجزر الجعفرية).
وفي ما بين 1912 و 1947، أي بين تنفيذ معاهدة الحماية والتقسيم الإستعماري للتراب المغربي، وبين خطاب طنجة يوم 9 أبريل 1947، ولد جيل مغربي جديد، في الدولة وفي المجتمع، هو جيل الفكرة الوطنية وطموح الدولة الحديثة، دولة المؤسسات والقانون والحريات. وهو الجيل الهائل الإستثنائي الذي أنجبته تربة المغرب خلال القرن 20. بسقف الصراع فيه بين “قوة المجتمع الناهض” و”قوة الدولة التي تريد إعادة تأسيس ذاتها”، لكنه صراع أنتج نخبة في الدولة والمجتمع، ظل سقف “الوطن” عاليا عندها كقيمة، تلزم بتنازلات وتوافقات، في هذا التدافع والإمتحان أو ذاك.
اليوم ونحن في نهاية العقد الثاني من القرن 21، هناك ملامح لجيل جديد. بملامح تحديات جديدة، برؤية جديدة، يخشى أنها “متغولة” في الرؤية وفي السلوك. الرؤية للذات وللجماعة، كما يبلورها السلوك التراكمي في واقع هذا الجيل الجديد. مما يجعل السؤال كبيرا: ما الذي سيدونه عن نفسه، هذا الجيل الجديد، في التاريخ؟.
جديا، يخشى أن يكون مثل جيل القرن 19. جيلا بدون بوصلة مدركة لمنطق التاريخ، كونه يصر سلوكيا، وعلى مستوى الخطاب، على قطع الجدور قيميا مع جيل الفكرة الوطنية، وأن الحسابات الجهوية هي الغالبة. وأنه نسي دروس تاريخه القريبة جدا، حين انتصرت فكرة المحميين على منطق الدولة حينها، وحين ارتهنت الزوايا الدينية لباريس أو لندن في القرن 19، ما قوض وجود الدولة المغربية وليس النظام السياسي فقط. واتضح، بعد فوات الأوان، أن العطب كامن في “نوع الإنسان” المغربي، ذاك الذي كانت تصنعه بنيات متهالكة للتعليم وإنتاج المعرفة والقيم.
أليس اليوم، مثل البارحة، حيث عطبنا الكبير في “نوع الإنسان” المغربي، الذي تصنعه وسائط التربية الاجتماعية، من مدرسة وأسرة وشارع وإعلام؟.
“تمغربيت” مسؤولية، في الدولة وفي المجتمع. والقرارات الكبرى يصنعها الرجال العظام.
الدار البيضاء :الاربعاء 14 يونيو 2017.