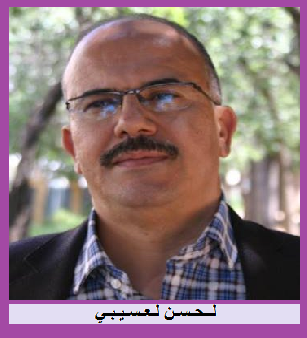حين تأملت الصورة الجماعية التي تخلد لتعيين جلالة الملك لهيئة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بكل القوة الدستورية التي أصبحت لهذا المجلس (عنوانا على أن خطوة تاريخية جبارة قد دشنت مغربيا، في باب منح استقلالية فعلية للقضاء كسلطة)، انتبهت، بمحبة وشغف خاص، إلى الرجل الواقف مباشرة على يسار جلالته، وترك الخاطر للبوح أن يفيد أن الرجل قد أنصفته البلاد، أخيرا، عبر بوابة هائلة اسمها «سلطة استقلال القضاء». وأكرم به من إنصاف.
الرجل ذاك هو الأستاذ محمد الحلوي، الذي عادت العديد من الوسائط الإعلامية والمجلات والمواقع الإخبارية للاهتمام بسيرته وقصته في الحياة السياسية والحقوقية والقانونية بالمغرب، بعد هذا التعيين. واكتشف الكثيرون، أن الرجل وهو يطل على الثمانين من عمره المديد، من أكثر الفاعلين، الصامتون تواضعا ونبلا بالمغرب. وأنه حين يدلف كل صباح إلى مكتبه في الطابق الثالث بإحدى أقدم عمارات الدارالبيضاء، في موقع استراتيجي بشارع لالة الياقوت، قبالة الفضاء حيث كانت بناية المسرح البلدي المأسوف على هندستها وتاريخها وقيمتها التاريخية والمعمارية، أنه كان قد اختار أن يكون على بعد أمتار من أدراج بناية المحكمة الابتدائية (اليوم يسمى مجمع المحكمة المدنية). التي قليلا ما ننتبه أنها البناية الوحيدة في قلب تلك الساحة الإدارية بالدارالبيضاء، حيث مقر القيادة الجهوية العسكرية وبناية بنك المغرب ومركز البريد الرئيسي وبناية الخزينة العامة ومقر مجلس المدينة وبناية الإدارة الجهوية للضرائب ثم البناية الشامخة، معماريا، لولاية المدينة بساعتها الشهيرة. أقول أنها البناية الوحيدة التي أدراجها عالية (12 درجا)، بينما باقي المؤسسات العمومية المحيطة بذات الساحة الواسعة لا تتجاوز أدراجها اثنين أو ثلاث، كناية على أن العدالة دوما أعلى من كل المؤسسات الأخرى. والعدالة تكون، أيضا، أعلى بسيرة أهلها (رجالا ونساء) من طينة الأستاذ المحامي محمد الحلوي.
كنت قد نشرت عنه مادة صحفية، فيها بعض من نفس البورتريه عن سيرته السياسية والنضالية، بعد اللقاء الذي جمعه بالعاهل المغربي محمد السادس، صدفة بالغرفة حيث كان يرقد الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي بمستشفى الشيح خليفة منذ شهور. وهي المادة التي تفرض مناسبة تعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، استعادتها هنا، مع تفاصيل جديدة عن سيرة الرجل، اعتزازا بمنجزه كمواطن مغربي من الزمن الجميل لمعنى النضال السياسي بسقف عال للقيم الوطنية ولمعنى جعل السياسة التزاما لخدمة المصلحة العامة، بنكران هائل للذات.
الوفاء عنوان أخلاق سياسية
هكذا، فحين جاء جلالة الملك محمد السادس فجأة، مساء يوم السبت 15 أكتوبر 2016، وبدون سابق إعلام أو ترتيب، للاطمئنان على الوضعية الصحية للأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، بالطابق الثاني لمستشفى الشيخ خليفة بالدارالبيضاء، وجد جلالته أمامه بالغرفة الخاصة حيث يرقد سي عبد الرحمان، رجلا قصير القامة، في كامل أناقته، يجر وراءه سنواته السبعين ونيف، وسأله عن حال الزعيم الوطني و الاتحادي. وعلى عادته في الجواب بهدوء، وضع ذلك الرجل، جلالته في صورة الوضعية الصحية لرفيقه الكبير، قبل أن يلج بخطواته المتثاقلة قد يوقظ اليوسفي من إغفاءته قائلا له بصوت مسموع : «جلالة الملك هنا». ذلك الرجل، الوفي، السادر في طيبوبة بلا ضفاف، الجم التواضع، الهائل الأخلاق في أعلى مكارمها، هو الأستاذ المحامي والمناضل الاتحادي محمد الحلوي،
طينة تكاد تكون قد اندثرت من جيل مغاربة الوطنية والنضال من أجل مغرب متقدم وحداثي.
هذا الرجل، الذي ظل واقفا بالساعات وعلى مدار أيام، بالليل والنهار، عند سرير سي عبد الرحمان اليوسفي، يستحق أن تحكى سيرته بكل حروف المجد والتقدير والاحترام. هو الذي نسي مرضه وتغلب على آلامه، ولم يعد ملتزما بواجب أخذ أدويته، التي هو ملزم بأخذها في أوقات معينة. بل، ممنوع عليه الوقوف كثيرا والإجهاد، وملزم بالتوجه إلى الطبيب في أوقات محددة، لمتابعة حالته الصحية الصعبة جديا. هذا الرجل، ترك كل ذلك، وبقي واقفا إلى جانب رفيقه وصديقه الحميم عبد الرحمان اليوسفي. جديا، لم أر وفاء ساميا مثل الذي تعلمته من الأخ محمد الحلوي.
والرجل، بالمناسبة، ليس نكرة في تاريخ المغرب الحديث، رغم انحيازه الدائم إلى الظل، وإلى التواري عن الأضواء، بسبب طبيعة تكوينه ومعنى ما يحمله من إيمان بأن الالتزام السياسي والجمعوي والنضالي، هو اختيار حياة، وليس أبدا أداة لتحقيق غايات ذاتية، آنية، عابرة. مثلما أنه ظل دوما منتصرا للإيجابي في العلائق، وظل دوما قوة طاقة إيجابية تبني الأساسي الصلب بين إخوة النضال ورفقة الطريق. ولم يحدث يوما (ولست الوحيد في الشهادة بذلك، بل هناك إجماع على هذا الأمر)، أن تفوه الرجل بكلمة سلبية في حق أي من رفاقه في مجال السياسة أو المحاماة، حتى وإن كان مختلفا جذريا مع البعض منهم. كان دوما يدفع بالتي هي أحسن، ولعل الآية القرآنية الكريمة، تكاد تنطبق عليه أكثر من غيره: «ادفع بالتي هي أحسن، فإذا بالذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم». وفي هذا، لم أر رجلا يماثله فيه، سوى الأستاذ المرحوم محمد الحبيب سيناصر.
قيادة الأوطم بمدرسة نضالية
محمد الحلوي، هرم بكل ما للكلمة من معنى في تاريخ الحركة الاتحادية والحركة الطلابية والحركة الحقوقية بالمغرب. ومما أذكره في هذا الباب، ما قاله لي مرة الأستاذ محمد الطالبي (وهو أمر منشور في كتابي الذي أنجزته رفقة الصديق الصافي الناصري حول تجربة «أقصى اليسار بالمغرب»، الصادر ببيروت سنة 2002)، ضمن سياق حكيه عن صدمته الثقافية سلوكيا بين الاختلاف في منهجية العمل التنظيمية بين المشرق والمغرب. إذ حكى كيف أنه، وهو شاب، قد عاد من دمشق مفعما بنظريات ماركسية لينينية راسخة، وله تصورات مثالية عن النضال الطلابي، وأنه صادف مرة أن نظمت مظاهرة طلابية في الشارع العام سنة 1965، بالرباط قرب باب الأحد، فتدخلت الشرطة بعنف مما جعل جموع الطلبة تتشتت هنا وهناك، فوجد نفسه بالصدفة إلى جانب محمد الحلوي، وهو حينها رئيس للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في أحد مداخل باب الأحد بالمدينة القديمة. وفجأة فتح باب أحد المنازل وصاحت شابة إنه الحلوي وأدخلته لحمايته من الشرطة وتركته هو في الخارج. قال الأستاذ محمد الطالبي: حينها فهمت أن العمل الميداني مع الناس هو الذي يبني التنظيم وليس النظريات.
الحقيقة، إنه ليس هناك تفصيل مركزي شكل انعطافة في مسار الحركة الاتحادية، لم يكن للأستاذ محمد الحلوي أثر فيه. هو المتشرب لثقافة مدينية أصيلة، اكتسبها في دروب وأحياء مدينته فاس، التي ولد وكبر فيها، في عائلة وطنية مستورة. وليست من العائلات الفاسية المتوارثة لسلطة ما (مالية أو مخزنية أو فقهية). وهي التربية السلوكية المدينية المتأصلة، التي جعلته يستند على معنى «للترابي» أصيل لا افتعال فيه ولا ادعاء. مثلما فيه الكثير من الفطنة والذكاء وحسن التصرف بعقلانية رفيعة. ويكفي هنا التذكير بترؤسه للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في واحدة من أشد وأصعب لحظاتها بين 1963 و 1966، لندرك قيمة الرجل. هو الذي الكثير من الأرشيف المصور بمقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بزنقة لافوازيي بحي الليمون بالرباط، وكذا أرشيف الصور النائم في مخازن ذاكرة أجهزة الأمن والمخابرات المغربية، لا يمكن ألا تجد في أي مظاهرة طلابية أو نشاط علمي للطلبة، حضورا بارزا لمحمد الحلوي، فهو دوما في مقدمة الصفوف. ما جعله موضوع رصد ومتابعة دقيقة لسنوات، كان من بين نتائجها أن قرر ذات مرة أن يجمع الجنرال أوفقير قيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ويفرض عليهم الخدمة العسكرية الإجبارية، بدعوى أن «راسهم سخون وقاصح» وكانت الوجهة هي المدرسة العسكرية بأهرمومو (رباط الخير اليوم)، وهي ذات المدرسة التي أشرف على تدريبهم ومراقبتهم مديرها، اعبابو، الذي سيقود انقلاب الصخيرات سنة 1971.
من التفاصيل التي حكاها لي أكثر من مصدر وأكدها لي الدكتور فتح الله ولعلو، بصفته كان واحدا من رؤساء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في ذلك العقد الحامي والساخن بالمواجهات مع مختلف أجهزة الدولة، الذي هو عقد الستينيات، أنه حدث أن أصدرت قيادة الأوطم بلاغا في شهر أكتوبر من سنة 1963، فيه تأييد لرئيس تلك المنظمة الطلابية، المنفي بالجزائر حميد برادة، بعد موقفه من حرب الرمال بين المغرب والجزائر، فتم استدعاء تلك القيادة على وجه السرعة من قبل وزير الداخلية الحمياني ووزير التعليم العالي الطعارجي المراكشي، حيث حضر كل من محمد الحلوي وفتح الله ولعلو وعمر الفاسي إلى مقر الوزارة، التي كانت مطوقة بالجيش والدرك. وطرح عليهم وزير الداخلية سؤالا وحيدا مباشرا: «هل أنتم مع حميد برادة أم ضده؟» مذكرا إياهم أن جوابهم سيحدد شكل التعامل معهم، وأن حكم الإعدام وارد في حقهم هم أيضا مثلما صدر في حق حميد برادة. الوحيد الذي تدخل بهدوئه المعتاد، وبحصافة عالية، هو محمد الحلوي، حيث أجاب وزير الداخلية بما معناه أن برادة هو رئيسهم، لكنه بعيد الآن عنهم جغرافيا ولا يعلمون شيئا عن ظروفه وليس باستطاعتهم الجزم بشيء بخصوصه. مما يعني أن برادة هو رئيسهم تنظيميا، لكنهم لا يمكن أن يتخذوا موقفا من الرجل وهم لم يستمعوا إليه أو يلتقوه مباشرة. بقي الثلاثة من قادة الأوطم رهن الاعتقال، لساعات طوال، قبل أن يأتي القرار بالسماح لهم بالمغادرة.
علاقته بجون بول سارتر
مثلما أن الرجل، استنادا إلى ذات المصدر الثقة، ستكون له أدوار مهمة في تعزيز التنظيم الطلابي بأروبا، خاصة بباريس، وأيضا بربط الصلة بشبكة العمال المغاربة المهاجرين هناك، وكذا مع النخبة الفكرية الفرنسية. وهنا ترد تفاصيل علاقاته وبعض لقاءاته ونقاشاته في أواسط الستينات مع كل من المفكر الفرنسي جون بول سارتر ورفيقته المفكرة سيمون دوبوفوار، وأيضا مع نسيج من المسؤولين الطلابيين من الفصيل التقدمي الفرنسي، قبل وبعد حركة ماي 68 بفرنسا.
وفي سياق اشتغالي على مادة موسعة حول ذاكرة الحركة الطلابية بالمغرب، وأساسا حول تجربة المنظمة الرائدة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب (الأوطم)، منذ التأسيس إلى اليوم، كنت قد وقعت على ذخيرة من الصور النادرة بأرشيف الجريدة، تعود إلى نهاية 1959 وفترة هامة من الستينات. وكم كانت سعادتي هائلة حين وجدت بالصدفة أن تمة عددا كبيرا من الصور التي تخلد لذاكرة التجمعات والمظاهرات والمسيرات الطلابية بين 1960 و 1970، فيها أثر للأستاذ محمد الحلوي، وهو في مقدمة الصفوف بالفعل الميداني بالشارع العام. بقامته القصيرة، بنحافته التي لا تزال، بشعره الفاحم السواد الرطب دوما. وحين قمت بنسخ جزء من تلك الصور التي تسجل لحضوره ذاك، وبتواريخ مختلفة بالسنوات (حوالي 57 صورة)، ونقلت إليه «السي دي»، برقت في عين الرجل دمعة وهو يستعيد ذكرى أيام جميلة لم يكن له عنها أي وثيقة مماثلة. بل إنه حين التقينا بعدها بأيام، سألني كيف حصلت على تلك الصور النادرة، وفي بريق عينيه فرح صاف.
ستحكي لي، مصادر أخرى، ثقة، في سياقات أخرى (بعضها سيصدر قريبا مادة مفصلة ومطولة عن سيرة الرجل كقائد طلابي ضمن مؤسسة مركز محمد بنسعيد آيت يدر للذاكرة، والتي يشرف عليها الأستاذ عبد الصمد بلكبير)،أن الملك الراحل الحسن الثاني، في سياق تتبعه وتفاعله مع حيوية المنظمة الطلابية تلك، والتي كانت موضوع مواجهة دائمة مع مختلف الأجهزة الأمنية، سيكلف مدير ديوانه إدريس المحمدي في أواسط الستينيات لإتيانه بسرعة بقيادة الأوطم للنقاش معها ومحاولة إقناعها بالاكتفاء بدورها النقابي المطلبي والابتعاد عن الاصطفاف مع الحركة التقدمية. تم اللقاء بإيفران، وحضره عن «الأوطم» كل من محمد الحلوي (رئيس الاتحاد، من فصيل الطلبة الاتحاديين) وعمر الفاسي (عضو قيادة الأوطم، من فصيل طلبة التحرر والاشتراكية).
شرع الملك الراحل الحسن الثاني يتحدث عن عطفه على الأوطم وأنه أيضا قد قدم دعمه المالي حتى للفدرالية المغاربية للطلبة، من باب تقوية جانب هذا الفصيل الطلابي المغربي ضمن باقي التنظيمات الطلابية المغاربية، لكنه غير مرتاح لسماحهم ببقاء شخص محكوم بالإعدام على رأس منظمتهم الطلابية لأنه خان وطنه، وطالبهم بتنحيته. جلالته كان يقصد طبعا حميد برادة. فيما كان محمد الحلوي، حينها، رافعا رأسه، والملك يتكلم معهم، إلى سقف القاعة، مما أغضب العاهل المغربي وقال له بالحرف: «السيد ممثل الاوطم أنصت إلي». فأجابه محمد الحلوي بهدوء : «نعم، جلالتكم، أنا فقط أتأمل هذه الهندسة التي أمامي». حين غادر القصر بإيفران، عقد اجتماعا لقيادة الأوطم بالرباط، وأصدروا بيانا يؤكد تشبثهم برئيسهم المنتخب حميد برادة. مما فتح الباب لمواجهة عنيفة مع الدولة.
لقد قيض لي في مناسبات عدة، وعلى مدى سنوات، أن ألتقي الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي في بيته بالدارالبيضاء، ولم يحدث أن لم يكن محمد الحلوي حاضرا، يأتي للإطلالة والسلام والتحية على رفيقه الكبير. مما يعني أن لقاءاتهم يومية. فبين الرجلين ثقة عالية جدا، بينهما وفاء رفيع. لهذا السبب نسي محمد الحلوي مرضه الجدي (أكاد أقول أجل ألمه فيه.. هل ذلك ممكن أصلا؟)، كي يبقى واقفا من أجل رعاية رفيقه وصاحبه اليوسفي وهو على سرير المرض. من مثل هؤلاء الرجال يتعلم المرء الكثير.