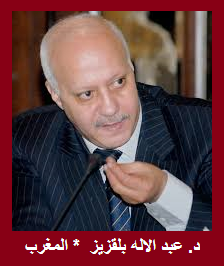… وأهلي كلَّما شيَّدوا قلعةً هَدَموها. (محمود درويش)
كثيراً ما نسيء التقدير والتحليل، مثلما نسيء التعبير، حين نذهب إلى القول إنّ حركات التطرّف والتكفير،
وفي جملتها «الجهاديات» المسلّحة، مثل «القاعدة» و«داعش» وأخواتهما، صناعةٌ غربيةٌ أو أمريكية أو صهيونية.
نسيء التحليل لأن حركات من هذا النوع، وظواهر سياسية من هذا الضرب، خرجت إلى الوجود من ديارنا العربية، والمنتسبون إليها، المقاتلون في صفوفها، جزءٌ من ساكني هذه الديار، فيما لا يُشكّل المستورَدون منهم من المجتمعات الغربية إلاّ نسبة قليلة، بل إنّ معظم أولئك المستقدَمين منهم من الغرب (هُم) من أصولٍ عربية وإسلامية. هذه واحدة، الثانية أنّ الفارق كبيرٌ بين عملية إنتاج جماعات التطرّف والتكفير، و(بين) عملية استخدامها وتسخيرها في مشروعٍ سياسي خارجي، ففيما تنتمي العملية الأولى، حكماً، إلى المجتمعات والدول التي تخرُج الجماعاتُ تلك من صلبها، يمكن للعملية الثانية أن يأتيها أيُّ صاحب مشروعٍ سياسي يستطيع تسخير الجماعات تلك في مشروعه. لا وجه يسوّغ الخلط بين الأمريْن، وليس للإلحاح على ارتباط التكفير والتطرُّف بالسياسات الأجنبية ما يعفي مجتمعاتنا ودولنا وبيئاتنا الثقافية من المسؤولية في إنجاب ظواهر من هذا النوع، وهو – في الأحوال جميعاً- في جملة عوائدنا المألوفة في تبرئة ساحتنا من كلّ بشاعاتنا وتعليقها على شمّاعة الخارج!
ونافلٌ هو القول إنّ إساءةَ التقدير والتحليل، في النظر إلى أيّ ظاهرةٍ أو مسألة، آيلةٌ بصاحبها (أصحابها) إلى إساءة طرق المعالجة وسياساتها. السياسيُّ، هنا، مثل الطبيب، يُصيب نُجْحاً في اختيار الدواء المناسب إنْ أصاب نُجْحاً في تشخيص المرض، أو يُخطئ العلاجَ إنْ أخطأ التشخيص، وقد يسبّب الخطأ في وصفةِ علاج المريض، أو علاج المجتمعات والدول، أمراضاً أخرى قد تكون قاتلة، فتصبح النتيجة طامة كبرى: انقلاب الدواء إلى داء! وهكذا قد يصرفنا بعضُ التشخيص غير الصحيح والدقيق لظواهر التطرف والتكفير، في مجتمعاتنا، إلى خيارات سياسية غير صائبة ولا مسؤولة، فيصرفنا – بالتبعة- عن جادّة المقاربة المناسبة.
يبدأ أيّ تشخيصٍ صحيح لظاهرةٍ ما من عواملها الداخلية بحسبانها العوامل الرئيسة، ولا بأس بعدها في – بل من الضروري- أن يُبْحَث في العوامل الخارجية لها بما هي عوامل مساعدة. ترجمةُ ذلك، في مسألتنا التي نتناولها، كالتالي: أن تكون مجتمعاتنا ودولنا مسؤولةً عن توليد ظواهر التطرف فهذا لا يتوقف على وجود حافزٍ خارجي لذلك التطرُّف، فلقد يخرج هذا من رحم المجتمع فيكون مرفوضاً من القوى الأجنبية: أكان محتَضَناً من السياسات الرسمية الداخلية أم محارَباً، إذِ الخارجُ، هنا، عامل ثانويّ غيرُ مقرِّر (وهو يصبح عاملاً مساعداً فقط إنِ احتضن التطرف أو دَعَمه أو مكّن له). أمّا أن يكون الخارج هو من أنجب ظواهر التكفير والتطرّف، فذلك يستحيل عليه – أو على الأقل- يتعذّر إن لم يجد في جوف مجتمعاتنا مادةً لانبثاق ذلك التطرف، أو قابليةً ذاتية للإفصاح عنه في بعض البيئات الاجتماعية أو الدينية أو السياسية. وحتى في الحاليْن هاتيْن، لا يعود للعامل الخارجي دورٌ في إنتاج قوى التطرُّف تلك، وإنما دور المساعدة في توليدها.
نتأدّى من المقدّمات السابقة إلى استنتاج نتيجتين بينهما صلاتٌ من الترابط وإن بدا أنهما منفصلتان:
أولاهما، أن البنية التحتية لظاهرة التطرّف والتكفير في مجتمعاتنا العربية هي مجتمعاتُنا نفسُها: المجتمعات الأهلية والمجتمعات السياسية على السواء، المجتمع والدولة معاً، مع تفاوُتٍ هناك وهنا في الدرجات لا يمكن الإغضاءُ عنه. وبيانُ ذلك أن جحافل المتطرفين والتكفيريين عندنا لم ينزلوا من السماء، ولا وفدوا على ديارنا من مجتمعات أخرى خارجية (باستثناء «الجهاديين» المستورَدين من خارج لمساندة نظرائهم في الداخل من «مواطني» البلاد العربية)، وإنما هُم خرجوا من بيئات مجتمعاتنا الاجتماعية والثقافية والسياسية ومؤسساتها، من الأُسر والنظام التربوي خرجوا، ومن المدارس وبرامج النظام التعليمي المطبَّقَة، ومن المساجد والجوامع والحسينيات والفتاوى الموتورة والتربية الدينية والمذهبية المغلقة والمتعصّبة، من الفقر والتهميش والبؤس والإملاق، ومن الاستبداد وانعدام الآفاق خرجوا، ومن مالٍ غبيٍّ وحسابٍ سياسيٍّ خاطئ وتملُّقٍ للمؤسسات الدينية خرجوا، من الوهم بإمكان ترويضهم وتسخيرهم جيشاً احتياطياً خرجوا، ومن أوضاع أخرى كثيرة وشبيهة خرجوا! إنهم ثمرة إخفاقاتنا، وغباوتنا، وحساباتنا الضيقة.
وثانيتهما، أنّ التطرُّف والتكفير إذ يُفْصِحان عن خَلَلٍ في الداخل العربي، الاجتماعي والسياسي والثقافي والديني، وعن ثغرات خطيرة في جدران العمران السياسي العربي، فإنّ الخلل ذلك يوفِّر المعْبَر المناسب لكل محاولةٍ خارجية لاختراق ذلك الداخل وإحداث الأذى فيه.