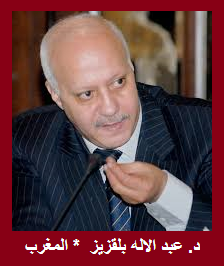يتواتر، اليوم، حديث متزايد في الولايات المتحدة الأمريكية عن تغير قادم في الأولويات الاستراتيجية لها في العالم، وعن تبدل محتمل في وجهة مصالحها الحيوية وخياراتها، وبالتالي، في مناطق حضورها السياسي وربما العسكري.
وفي سياق الإفصاح عن بعض المعلومات والسيناريوهات، المتعلقة بذلك التغيّر المحتَمل القادم، يشار إلى أنّ وجهة البوصلة الأمريكية اليوم هي الصين ومحيطها الإقليمي (كوريا، اليابان، بحر الصين). ويستتبع ذلك – حكماً- إعادة نظر أمريكا في «عقيدة الشرق الأوسط»، ومركزيته في استراتيجياتها الكونية، وسياساتها الخارجية، وانتشار قواعدها وأساطيلها. وهي إعادة النظر التي بدأ التلميح إليها منذ فترة ليست بالقصيرة، منذ أن شاع أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن بدائل للطاقة في الخليج و«الشرق الأوسط»، ليتكرس القولُ – في عهد إدارة باراك أوباما- إن أمريكا لم تعد في حاجة إلى نفط المنطقة، وإنها قد تبدأ في التخفيف من حضورها فيها، ومن تدخُّلها الكثيف في أزماتها. ولعلّ الطريقة التي انسحبت بها إدارة أوباما من إدارة الصراع الفلسطيني- «الإسرائيلي» و«رعاية» التسوية، والطريقة التي أدارت بها ملفّ البرنامج النووي الإيراني، على حساب حلفائها التقليديين في المنطقة، مؤشر دال على نوع ذلك التبدل الجاري في وجهة خياراتها الاستراتيجية.
ما يعزز الاعتقاد أن مثل هذا التغيّر الاستراتيجي احتمال راجح وليس محضَ فرضية، إن المجال الآسيوي عامة والصيني أو المحيط بالصين، بات مجالاً حيوياً في حساب المنافسة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، ويمتحن قدرة بقاءَ حال التفوّق الأمريكي لفترة أطول. في العقل السياسي الأمريكي، اليوم، هاجس جديد اسمه الصين، وهو هاجس يشبه في الحدة – أو يفوق- ما كانه الهاجس السوفييتي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية: طوال الحقبة الفاصلة بين نهاية الحرب العالمية الثانية، في منتصف أربعينات القرن الماضي، ونهاية الحرب الباردة، في خواتيم ثمانينات القرنِ عينِه. ولكن بينما كان الخطر السوفييتي عسكريًا، وكان قابلاً للاستيعاب، لصعوبة وخطورة الانزلاق إلى حرب نووية بين العظمييْن، فإن الخطر الصيني اقتصادي وتكنولوجي، وغيرُ قابل للاستيعاب لأن مبناه على المنافسة المشروعة بين الدول والاقتصادات. والحقُّ أن المخافة الأمريكية على المستقبل، وعلى مركز أمريكا الدولي المهدد من قِبل صعود المارد الصيني، ليست مخافة مصطنعة على مثال ما هي مصطنعة مخافة أمريكا ممّا تطلق عليه «الإرهاب الإسلامي»، فالصين، فعلاً، قوةٌ صناعيةٌ وعلمية وتكنولوجية وتجارية ضاربة، واقتصادها يتحكم – اليوم- في مستقبل الدولار كما تعرف أمريكا جيداً. ولم يسبق للولايات المتحدة، منذ اعتلت عرش النظام الرأسمالي الصناعي والمالي العالمي، وأصبحت فيه قائدة وحاكمة، أن ووجهت بتحد اقتصادي كبير بحجم التحدي الصيني، لا في حقبة صعود اليابان، ولا عند إنشاء «الاتحاد الأوروبي».
إنّ أي حرب اقتصادية أمريكية لعزل الصين، مثلاً، أو قطع روابطها الاقتصادية والتجارية بالعالم، تبدو مستحيلة وتدرك أمريكا، قبل غيرها، مقدار استحالتها؛ فلا البلدان المصدِّرة للطاقة تجد غنى عن الصين، بما هي زبون الطاقة الأول في العالم، ولا بلدان الاتحاد الأوروبي ولا الشركات الأمريكية نفسها مستعدة للاستغناء عن الصين بصفتها أضخم سوق استهلاك في العالم، فضلاً عن أموالها المودعة في البنوك الغربية، أو استثماراتها الضخمة في أوروبا والولايات المتحدة، ولا بلدان العالم الثالث تستطيع مقاطعة أكبر شريك اقتصادي وتجاري لها، وأكبر داعم مالي وتكنولوجي لاقتصاداتها.
ومشكلة الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين أن هذه كانت، ومنذ بداية نهضتها الصناعية قبل ما يقل قليلاً عن أربعين عاماً، قادرة على الدفاع عن مشروعها التنموي والاقتصادي في وجه التهديدات العسكرية الخارجية والحصار الاقتصادي، وطورت – مع الزمن- قدرتها العسكرية الاستراتيجية لتصبح، اليوم، ثاني دولة في العالم في الإنفاق على الصناعة الحربية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، تحافظ على تلك القدرة لأغراض دفاعية، ولم تبددها أو تستنزفها في حروب خارجية، شديدة الكلفة بشرياً ومالياً، كما يحصل للولايات المتحدة. وإلى ذلك فإن الصين لا تورط نفسها في أزمات العالم السياسية، وتتمسك بسياسة خارجية متوازنة وسلمية؛ فلا تعادي أحداً ولا تدفع أحداً إلى التهيّب منها، أو الشك في نياتها.
ما يُهمّنا من الموضوع كله، نحن العرب، هو معرفة كيف سيكون عليه مجالنا القومي والحيوي الإقليمي بعد الانسحاب الأمريكي منه أو – على الأقل- الانكفاء النسبي عنه وعن أزماته؛ وكيف يمكننا ملء الفراغ الذي سينجم من ذلك.