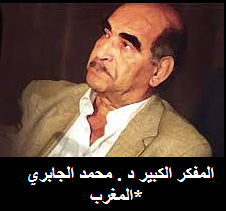السياسة التعليمية، التعليم والهوية والمجتمع… ونظام الأكاديميات
إن كثيرا من رجال الدولة “صانعي القرار” إما يتخوفون من رجل التعليم وإما يحتقرونه. وهذه الظاهرة تعكس غياب الديموقراطية، أقصد بالخصوص غياب العقلية الديموقراطية، وليس مراسيمها وفولكلورها. ومن نتائج غياب الديموقراطية القرارات الارتجالية التي تصدر لتمس التعليم وسيره أو وضعية رجل التعليم و مسيرته.
س- محور كل أبحاثكم هو ما تسمونه الاستقلال التاريخي للذات العربية. أي دور يمكن للسياسات التعليمية أن تلعبه في هذا الصدد؟
ج- لاشك أن الاستقلال الثقافي والفكري، وبالتالي استقلال الذات ككل، يتوقف إلى حد كبير على مدى استقلال المعلم والمتعلم، الكاتب والقارئ. بعبارة أخرى: الاستقلال التاريخي للذات -وأقصد الذات الحضارية لأمة من الأمم- يتوقف إلى حد كبير على مدى الاستقلالية التي تطبع التكوين التربوي والتعليمي وبالتالي السياسة التعليمية في تلك الأمة. وهنا يمكن التمييز بين الاستقلالية التي تتوافر، أو يجب أن تتوافر في السياسة التعليمية، وبين الاستقلالية التي تمنحها هذه الأخيرة وتكرسها.
الجانبان مترابطان كما هو واضح. فالسياسة التعليمية في بلد من البلدان يجب أن تعكس طموحات ذلك البلد في أن تكون له مكانته الخاصة واللائقة في هذا العالم الذي أصبحت الأشياء فيه تقترب من بعضها إلى درجة تهدد الفوارق والاختلافات الضرورية في بناء الهوية، وهي نفسها الضرورية في تحقيق الاستقلال التاريخي.
يمكن أن ننظر إلى الاستقلال التاريخي للذات العربية من مستويات متباينة ولكن متكاملة: فمن جهة يعني الاستقلال التاريخي استقلال الوعي، وبعبارة أخرى عدم استلاب الوعي. وهذا يتوقف على استقلال الفكر من جهة وعلى تبلور الخصوصية واغتنائها من جهة أخرى. وهذا وذاك هما في الحقيقة والواقع من فعل وإنتاج السياسة التعليمية. فإذا لم تكن السياسة التعليمية مستقلة وتعمل على غرس الاستقلالية في النشء، فلن يكون بالإمكان الوصول إلى ذات تتمتع بالاستقلال التاريخي.
س- تتحدثون كثيرا عن الاختراق الثقافي في زمن العولمة وتهديدها لهويتنا، ولكن البعض يرى أن طرح سؤال الهوية من جديد موقف يتسم بالنكوص. فهل حقا تهدد العولمة الهوية أم أنه لا خوف عليها من العولمة والتقدم والتحديث؟
ج- القول بأن التمسك بالهوية يعكس موقفا يتسم بالنكوص هو نوع من الحكم المجاني على الأشياء، أعني أنه لا يستند على بحث وتدقيق (هنا حديث عن هاجس الهوية في الغرب لا ضرورة لنشره لأنه لا يختلف كثيرا عما قلناه في العدد هذا الركن من العدد السابق من هذه المجلة)
ونعود إلى الموضوع الذي طرحه السؤال السابق المتعلق بالاستقلال التاريخي لنقول: إن ما يهدد الاستقلال التاريخي لذوات الشعوب هو هذا المظهر الاختراقي الذي يطبع العولمة اليوم. إنه لمن الخطأ ربط العولمة بالانفتاح والتقدم ربط علة بمعلول. إن العولمة كما تمارس اليوم هي -أو على الأقل تقوم من بين ما تقوم عليه- على تصدير أشياء اقتصادية وأخرى ثقافية وفلكلورية وإشهارية ذات طابع استلابي، إلى درجة أنها تقمع، لدى الشعوب التي تتخذها موضوعا لها، الرغبة في التقدم والتضحية من أجل تحقيقه. إن تعميم الرغبة في استهلاك مواد تنتج في بلد آخر لا يمكن منافسته في إنتاجها، كما أن خلق أذواق ورغبات لم تكن من قبل عن طريق الإشهار والاختراق الإعلامي، يجعلان قسما كبيرا من الرأسمال الوطني يصدر إلى الخارج، مما يمنع أو يعرقل عملية التراكم المطلوبة كشرط في كل تنمية. والاختراق الثقافي، والاختراق اللغوي مظهر من مظاهره، هما غزو لهوية الذي يتعرض لهما، ولكنه قد يكون وسيلة لإغناء هوية الذي يمارسه. وعلى كل، فالذي يمارس الاختراق الثقافي لا يقبل التخلي عما يعتبره جزءا من هويته.
س- ما دمتم قد أثرتم الحديث عن التراث وما دمنا نتميز نحن العرب بذلك الإرث الحضاري والفكري والفلسفي الذي تولونه الكثير من اهتمامكم، دعنا نسأل ما هي حاجتنا إلى ابن رشد؟ كيف نحققه في ثقافتنا العربية المعاصرة؟ وهل يمكن إدخاله في منظومتنا التربوية؟
ج- مادمتم قد ذكرتم ابن رشد يمكن أن أقول إن من أهم النتائج التي خرجت بها من مصاحبتي لأبي الوليد منذ أزيد من عشرين سنة، وبكيفية أخص منذ عامين بمناسبة الاحتفاء بمرور ثمانية قرون على وفاته، أقول إن من أهم النتائج التي خرجت بها هو أن ابن رشد هو المثقف العربي الوحيد الذي استطاع أن يجمع بين التخصص في التراث العربي الإسلامي والتخصص في التراث اليوناني الذي كان يشكل في عصره الثقافة العالمية، أو لنقل ثقافة المعاصرة. إنك تجد ابن رشد الفيلسوف يستحضر القرآن والحديث والفقه في كتاباته كما يستحضر أرسطو والعلوم الفلسفية من ميتافيزيقا وطبيعيات وطب الخ. لقد ألف في الفقه وفي العقيدة وفي الطب والفلسفة تأليف العالم المختص. أضف إلى ذلك طموحه إلى إصلاح فلك بطليموس الذي كان سائدا في عصره. باختصار كان ابن رشد يعرف معرفة دقيقة كلا من التراث الإسلامي والتراث الإنساني المتمثل يومئذ في علوم اليونان. وعندما أقول إنه كان الوحيد الذي جمع بين الثقافتين العربية الإسلامية واليونانية فلأنه كان كذلك بالفعل. فالكندي والفارابي وابن سينا وابن باجة وابن طفيل كانوا بالفعل على درجة ما من المعرفة بالفلسفة اليونانية، ولكن لم يكن من بينهم أحد متخصص في الثقافة العربية الإسلامية تخصص ابن رشد. كانوا يعرفون اللغة العربية بدون شك وبها كتبوا، ولكن لم يكن من بينهم من كتب في الفقه والعقيدة كما فعل ابن رشد. كان منهم من رد على فقهاء زمانه ولكن من موقعه كفيلسوف، أما ابن رشد فقد انتصر للفلسفة من منطلق الفقهاء أنفسهم لأنه يعرف ذلك المنطق معرفة بلغت به درجة الاجتهاد.
فعلا كان من بين علماء التراث العربي الإسلامي من كان ملما إلماما بجانب أو أكثر من العلوم اليونانية كالغزالي مثلا. ولكن معرفة الغزالي بالفلسفة والعلوم اليونانية كانت معرفة دارس وليس معرفة مختص. كانت مراجعه هي كتب ابن سينا. فهو باعترافه لم يعرف مؤلفات أرسطو، وهو لم يدرس الفلسفة لذاتها ومن أجل المعرفة بل من أن أجل أن يهاجم الفلاسفة وابن سينا بالتحديد. أما ابن رشد فهو لم يدرس الفقه ليهاجم الفقهاء بل درسه من أجل العلم، كما أنه لم يدرس الفلسفة من أجل الرد على أحد بل من أجل المعرفة.
وبصورة عامة كان الفقهاء يجهلون بضاعة الفلاسفة وكان الفلاسفة يجهلون بضاعة الفقهاء. والإنسان كما قيل “عدو لما يجهل”، ومن هنا كانت العداوة بين الفريقين. أما ابن رشد الذي كان متمكنا في التراث العربي الإسلامي وفي التراث الفلسفي العلمي اليوناني فقد كتب “فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال” وكتب “مناهج الأدلة في عقائد الملة”، و أيضا “تهافت التهافت” وهي كتب بين فيها أن الفلسفة والعلم لا يتعارضان مع الدين، وأن الدين بدوره لا يتعارض مع الفلسفة والعلم. بين ذلك لعلماء الدين من داخل المرجعية الدينية، وأوضح ذلك للفلاسفة من داخل المرجعية الفلسفية. كل ذلك بروح عقلانية بناءة أقرب إلى عصرنا ومشاغلنا من أية عقلانية أخرى.
وما دمنا قد بدأنا بالحديث عن الاستقلال التاريخي للذات العربية، فلا بد من القول هنا إن هذا الاستقلال كما يتوقف على الجمع بين الثقافة الوطنية، أعني التراث، وبين الثقافة العالمية، يتوقف كذلك على الاستقلال الفكري، على تعميم العقلانية والروح النقدية. وأعود إلى ابن رشد لأؤكد أني لم أصادف في كل ما اطلعت عليه في التراث أو في الثقافة العالمية مفكرا مستقلا كابن رشد. ليس هناك حكم أصدره ابن رشد إلا ويعكس جانب الاستقلال التاريخي في شخصيته، جوانب العقلانية والروح النقدية في تفكيره. فهو عندما يرد على الغزالي، في تكفيره الفلاسفة، يرد عليه كفقيه مجتهد وقاض مستقل وروح عقلانية لا تتعارض لا مع الفقه ولا مع الدين. وكذلك الشأن عندما يلاحظ أشياء على ابن سينا أو الاسكندر أو ثامسيطيوس أوغيرهما من المفسرين لأرسطو، أو على جالينوس في الطب الخ. وتتجلى استقلالية ابن رشد أيضا في كونه لم يتعصب في كتابه في الفقه لأي مذهب ضد آخر بل عرض المذاهب الفقهية بروح موضوعية نادرة المثال، كما عبر عن رأيه الخاص بكل شجاعة حتى ولو خالف في ذلك المذهب المالكي الذي كان مذهب أبيه وجده ودولته وبلده. أما ثناؤه على أرسطو وتأييد وجهة نظره فهو يرجع إلى عقلانية أرسطو وواقعيته وروحه العلمية النقدية. وتلك هي الجوانب التي كانت تربطه به.
س- أعتقد أن حديثكم عن ابن رشد بكل هذا الثقل والتنوع والإبراز الهام لاهتماماته الثقافية الفكرية والفلسفية السائدة في عصره يقودنا إلى الحديث عن الفلسفة في نظامنا التعليمي، فقد تم منذ سنوات تهميش الفلسفة في بلدنا، وكما تعلم فالفلسفة بنت الديموقراطية. فهل يمكن الحديث عن تعميق الديموقراطية وإغناء الهوية في ظل هذا التهميش؟
بالفعل همشت الفلسفة في تعليمنا الثانوي بقرار بليد، كان أصحابه يعتقدون أنه بتهميش الفلسفة سيسكتون أصوات المعارضة في صفوف الطلاب. وأنا أصف هذا القرار بالبلادة لأن النتيجة تحتم ذلك. إن ما هو سائد الآن في صفوف الطلبة، مظهريا على الأقل، ليس الفكر الإسلامي بل نزعة التطرف فيه. والقرار البليد المماثل للقرار السابق، والمصاب بقصر النظر، سيكون تهميش الثقافة الإسلامية من أجل جعل حد للتطرف. هذا خطأ لا يقل بلادته عن الخطأ الأول. ونحن إذا تأملنا الساحة الطلابية في المغرب، كما في العالم العربي عموما، فإننا سنجد التطرف أكثر انتشارا في الكليات العلمية، التي لا تدرس فيها لا الفلسفة ولا العلوم الإسلامية، منه في كليات الآداب.
لقد شغلتني هذه الظاهرة زمنا. ولم أجد ما أفسرها به سوى عاملين اثنين: أولهما الطبيعة “القانونية” للمعارف العلمية، أقصد أنها مجموعة من القوانين، فالمعرفة العلمية، الرياضية والفيزيائية الخ، هي بطبيعتها تنتهي إلى حقائق يجب الأخذ بها كحقائق، أما في الدراسات الإنسانية وخاصة في الفلسفة فليست هنا حقائق نهائية: ليست هناك قوانين بل وجهات نظر.ومعلوم أن من جملة أسباب التطرف غياب فضاء للمناقشة وتبادل الرأي ومقارعة الحجة بالحجة والتعود على الاختلاف في الرأي وعلى تعدد النتائج. أما العامل الثاني فهو يرجع إلى الإحباط الذي “لا يحتمل” والذي يتعرض له الطالب في كليات الطب والعلوم عندما يكتشف أن مصيره مجهول وأن العمل ليس مضمونا له بعد تخرجه كما كان يتخيل، رغم الحظ الذي مكنه من الالتحاق بالأقسام العلمية ورغم الجهود التي بذلها والموهبة التي منحها الخ. أما طالب الكليات الأدبية فهو يدخل الجامعة وهو شاك في الحصول على عمل أو على منزلة، وهذا مفهوم. وإذن فدرجة الإحباط التي يصاب بها طالب العلوم والطب عندما يلتحق بالجامعة ويكتشف أن مصيره هو البطالة أشد وأكثر تأثيرا في نفسية الطالب من الإحباط الذي يصاب به طالب الآداب. فإذا اجتمع العاملان كانت النتيجة التطرف.
على أن قرار تهميش الفلسفة في تعليمنا الثانوي لم يكن نابعا فقط من هذا النوع من الاعتبارات السياسية. لقد عرفت الظروف التي همشت فيها الفلسفة ولم أكن بعيدا عن وزارة التعليم، فقد عملت مفتشا للفلسفة في الثانوي لعدة سنوات. وأستطيع أن أؤكد أن قرار تهميش الفلسفة كان وراءه أيضا أمور أخرى تنتمي إلى عالم التجارة واستغلال النفوذ في مجال الكتاب المدرسي. وربما اتخذ “العداء” للفلسفة ذريعة لإخفاء الدوافع الحقيقة.
س- صدرت لكم منذ سنوات كتابات في المسألة التعليمية: “أضواء على مشكل التعليم” في أوائل السبعينات، “سياسات التعليم بالمغرب العربي” سنة 1989، وبين صدور الكتابين فترة زمنية ليست بالقصيرة زاد فيها تدهور التعليم ببلادنا إلى درجة أن المغرب أصبح يرتب في مرتبة 125 وهو ما أسميتموه “رقم زنزانة في عنق المغرب” . كيف تفسرون هذا التراجع أو التدني في النتائج، هل هو عدم الالتزام بتطبيق المبادئ الأربعة؟ أم أنه الفصل بين المدرسة وبين محيطها؟ أم أنه عدم بناء السياسة التعليمية على استراتيجية تنموية؟
ج- أريد أن أخفف من الأحكام التي تروج في هذا المجال والتي تخص مستوى التعليم في بلادنا. لقد اعتدنا سماع عبارات تحكم على مستوى التعليم بالتدني أي بالتراجع إلى الوراء بالنسبة لما كان عليه الحال في فترة ما. مثل هذه لأحكام، ولو أنها صحيحة نسبيا، أحكام ليست بريئة دائما. هناك من يشتكي من انخفاض مستوى التعليم ليصل إلى النتيجة التي يريدها وهي أن السبب هو التعريب، وبالتالي فالعلاج يكون في العدول عن التعريب!
أعتقد أنه من الضروري مراجعة مثل هذه الأحكام التي تلقى هكذا جزافا دون دراسة وبحث. صحيح أن تعليمنا هو دون طموحاتنا بكثير. وصحيح أنه كان من الممكن أن يكون أحسن مما هو عليه اليوم، خمس مرات مثلا، باستعمال نفس الوسائل والإمكانات التي استعملت. ومع هذا كله فالحكم على مثل هذه الأمور يجب أن يستند على المقارنة الصحيحة. لنأخذ مثلا طفلا عمره اليوم 17 سنة، أعني هذا العام، ولنقارنه بطفل في مثل عمره كما كان سنة 1958 وسنة 1968 . لقد كنت على صلة مباشرة بالتعليم والتلاميذ في هذه السنوات. وعندما أقارن بين المستوى الذي كان عليه طفل 1958 أو 1968 وبين طفل اليوم ألاحظ أن هناك فرقا لصالح هذا الأخير. قارن بين كتب الرياضيات وكتب المطالعة أو الأدب كما كانت في ذلك الوقت وكما هي اليوم، ستلاحظ أن هناك تطورا: فالمفاهيم التي يتعلمها الطفل اليوم تواكب التقدم الحاصل وبالتالي فهو نفسه يواكب عن طريقها هذا التقدم الحاصل. إذا كان ابنك يحب المطالعة فحاول أن تجعله يتخلى عن نصوص نجيب محفوظ مثلا وأعطه نصوص المنفلوطي التي كنا نقرأها ونعجب بها نحن جيل الخمسينات، وانظر رد فعله.
أنا لا أريد أن أقلل من خطورة المشاكل التي يعاني منها تعليمنا، ولكن لا يجوز تبني النظرة الإحباطية بدون مبرر والنظر بها إلى جميع الأشياء بشكل مسبق.
بعد هذه الملاحظة لنعد إلى مشاكل تعليمنا الراهنة. من الممكن في نظري تصنيفها إلى صنفين:
1- صنف يخص التعليم منظورا إليه من زاوية علاقته بالمجتمع.
2- وصنف يخص التعليم منظورا إليه من زاوية أجهزته الداخلية.
فيما يخص الصنف الأول يبدو أن أبرز مشكلة فيه تتمثل في كون نظام تعليمنا بأسلاكه المختلفة لا يستوعب نسبة كافية من الأطفال الذين هم في سن المدرسة أو الجامعة. وبخصوص الثانوي يمكن أن نلاحظ، زيادة على كونه لا يستوعب النسبة التي من المفروض أن يستوعبها، يمكن أن نلاحظ أن نطاقه لا يتجاوز المراكز الحضرية أو القريبة منها. وقد لا أحتاج إلى ذكر الإحصائيات لإثبات أن نصيب العالم القروي منه نصيب هزيل. والفرق بين المدن والقرى والبادية في هذا المجال يمكن أن يقبل في حدود معينة، ولكنه عندما يتسع ويتفاقم فإن نتائجه على مستقبل البلد ككل تكون خطيرة للغاية. ذلك لأن النتيجة التي تفرض نفسها هي أن النخبة المسيرة ستكون غدا، في جميع المجالات، من المدينة وحدها. وهكذا سيتعمق ذلك التصنيف الذي أقامه الفرنسيون بين “المغرب النافع” و”المغرب غير النافع”، التصنيف الذي قد يكتسي طابع “المغرب المتقدم”، “المعاصر”، و”المغرب المتخلف”، “التقليدي”. وأكثر من ذلك سنكرر الوضع الثقافي الذي عرفه المغرب منذ القرون الوسطى حيث ظلت الثقافة الرفيعة محصورة في أهل المدن، فيتكرس ويتعمق ذلك الانشطار وتلك الثنائية التي نعبر عنها اليوم بمصطلحات من قبيل الأصالة والمعاصرة، أو الحداثة والتقليد. وغني عن البيان القول إن هذه الظاهرة ستكتسي خطورة فائقة فيما يسمى بعصر العولمة. ذلك لأن عالم العولمة هو عالم المدن أما البادية فما زالت تعيش في عالم آخر. لقد اشتكى لي مؤخرا صديق من تونس طاف في بعض الجهات في المغرب عن التخلف الهائل الذي تعاني منه البادية المغربية بالمقارنة مع البادية التونسية. وهذا صحيح فالبادية المغربية تعيش في القرون الوسطى.
ومن القضايا الأخرى التي تنتمي إلى هذا الصنف من المشاكل تلك القضية التي يعبر عنها بـ”عدم اندماج التعليم في المجتمع”. هذا صحيح من جهة، ولكنه غير صحيح من جهة أخرى. ذلك أنه إذا نظرنا إلى ما نصف به تعليمنا من تخلف وقصور فسنجده إنما يعكس ما بالمجتمع من تخلف. ومن هنا يمكن القول إن المطلوب من التعليم في مثل هذه الحال ليس أن يندمج في تخلف المجتمع، بل أن يعمل على تغيير المجتمع. إن مسألة الاندماج مسألة نسبية. إن الأعداد الكبيرة التي تتخرج من التعليم الثانوي دون أن تجد مقعدا في المعاهد العليا تبقى عرضة للبطالة المحققة، وبالتالي للعودة إلى الأمية. ذلك لأن المجتمع لا يتوافر فيه من المنافذ ما يكفي لاستيعاب هذه الجموع.
أذكر أنه في أواسط الستينات كنت مديرا لثانوية كانت قد استحدثت فيها أقسام تقنية. فماذا كانت النتيجة من استحداث هذه الأقسام؟ لقد وجد التلاميذ المتخرجون منها أنفسهم بدون عمل. ذلك لأن تلك الأقسام التقنية كانت قد استحدثت في إطار التصميم الخماسي الأول 1960-1965، الذي كان يرمي إلى غرس بنيات صناعية في البلد. فلما تم العدول عن هذا الصميم، بسبب السياسة التي اختارها نوع “التناوب” الذي استحدث والذي ظل قائما منذ ذلك الوقت إلى السنة الماضية ، باتت الأقسام التقنية التي أنشئت في المدارس الثانوية لا محل لها من الإعراب، فألغيت بقرار أو تلاشت من تلقاء نفسها.
علاقة التعليم بالمجتمع علاقة ثنائية الاتجاه: فمن جهة يجب أن يكون المجتمع قادرا على استقبال نتائج التعليم، ومن جهة أخرى يجب أن يكون التعليم قادرا على تلبية حاجات المجتمع. ومن نافلة القول التأكيد على أن التخطيط للتعليم، أعني رسم سياسة أو استراتيجية له، يجب أن يتم في إطار التخطيط للمجتمع ككل. وفي بلد متخلف لا أفهم كيف يمكن تحقيق تنمية بدون نوع ما من التخطيط. فالتنمية للخروج من التخلف تتطلب إرادة وتعبئة وتضحيات، وهذه كلها أمور تتطلب التخطيط.
لنكتف بهذا في ما يخص مشاكل التعليم الراجعة إلى علاقته بالمجتمع، ولنلق نظرة على صنف آخر من مشكل التعليم في بلادنا، أقصد تلك التي تتعلق به هو نفسه. لنقل مشاكله الداخلية.
هنا سأعمد إلى المقارنة بين ما كانت عليه دار التعليم قبل عقدين أو ثلاثة وبين ما هي عليه الآن. أذكر أنه كان التعليم في بلادنا إلى حدود السبعينات قطاعا نظيفا: لم يكن مصابا بأمراض الرشوة والمحسوبية والمحاباة. وإذا كان هناك شيء منها فهو الاستثناء الذي يؤكد القاعدة. كان ما يطبع عالم رجل التعليم هو التفاني في عمله والتنافس من أجل تحسين مستواه التعليمي والتربوي عن طريق التهيؤ لامتحانات ومباريات. لم يكن هناك مرض الدروس الخصوصية ولا مرض و”أنا مالي”. أما اليوم فلا يستطيع المرء إلا أن يبدي أسفه الشديد لما يشاهد ويسمع. لقد أصيب رجال التعليم بالإحباط في طموحاتهم فانحط سلوك كثير منهم. والحديث الشريف يقول “كاد الفقر أن يكون كفرا”. وهذا التردي يرجع إلى عدة عوامل لعل أهمها العاملين التاليين: ارتفاع ما تحتاجه المتطلبات الضرورية للحياة، من مأكل ومسكن وملبس وإعالة للأهل… وفي مقابل ذلك عدم تحرك الأجور والتعويضات بوتيرة مواكبة لذاك الارتفاع.
ومن جهة أخرى هناك ظاهرة لابد من ذكرها، وهي تخوف بعض مصالح الدولة من رجال التعليم. إن كثيرا من رجال الدولة “صانعي القرار” إما يتخوفون من رجل التعليم وإما يحتقرونه. وهذه الظاهرة تعكس غياب الديموقراطية، أقصد بالخصوص غياب العقلية الديموقراطية، وليس مراسيمها وفولكلورها. ومن نتائج غياب الديموقراطية القرارات الارتجالية التي تصدر لتمس التعليم وسيره أو وضعية رجل التعليم و مسيرته.
لنأخذ مثالا واحدا هو امتحانات البكالوريا. كانت امتحانات البكالوريا إلى حدود أواخر السبعينات هو المجال الوحيد الذي تحترم فيه الديموقراطية. كانت هي “أعدل الأشياء قسمة بين الناس”، أعنى المترشحين لامتحاناتها. الجميع يتقدم لتحول إلى رقم في ورقة مجهولة المصدر والناحية، تصحح كما هي. وتستمر عملية التعامل مع المجهول إلى أن حين إعلان النتائج بصورة رسمية، وحينئذ فقط يبحث عن الاسم الذي يشير إليه الرقم. قد يكون العمل جاريا اليوم من الناحية الشكلية بهذا، ولكن ما يسمى بنظام المراقبة المستمرة والامتحانات التي تجري على مدى ثلاث سنوات، كل ذلك جعلالبكالوريا موضوعا لـ”البناء” لمدة سنوات، وبالتالي مجالا لا يمكن القول إن العدل يجري فيه ليل نهار، ولدى كل تصحيح أو تقدير أو سؤال. إن نظام الأكاديميات يجب أن يعاد فيه النظر. أنا لست ضد الأكاديميات ولا ضد اللامركزية. ولكن الأمور بنتائجها.
لنلتجئ مرة أخرى إلى المقارنة. قبل نظام الأكاديميات كان متوسط المعدل العام الذي يحصل عليه التلميذ الناجح في امتحانات البكالوريا يتحرك بين 9 و12 نقطة على عشرين، ونادرا ما كان التلميذ يحصل علة أكثر من 12 على عشرين. أما اليوم فمتوسط المعدل العام يتراوح بين 13 و14، وحصول التلميذ على 18 على عشرين صار شيئا مألوفا. لقد حصل تضخم في النقط، وهذا ليس راجعا إلى تحسن في المستوى بل إلى “كرم” في التنقيط، ليس كله من الكرم الممدوح الذي يستحقه المستفيد منه. أنا لا أقول إن النظام القديم كان مثاليا، فلقد كانت هناك تجاوزات بدون شك، ولكن يمكن أن أدعي أنه كان أكثر عدلا، كانت المساواة فيه حتى على صعيد البخل والخطأ. وفي مجال العلم والتعليم المساواة في البخل بالنقط، أفضل من اللامساواة في الكرم. على أنه لا معنى للكرم في تقدير التحصيل العلمي.
ما الذي حمل “صانعي القرار” عندنا على تغيير نظام البكالوريا؟ ما أعرفه شخصيا هو أن الذين اقترحوا نظام الأكاديميات كان هدفهم شيئا آخر غير الرفع من مستوى التعليم. إن الهدف كان التحكم في النتائج، أعني في أعداد الناجحين. فماذا كانت النتيجة؟ تعطينا المقارنة صفرا، زائد الفوضى وفقدان المصداقية. ذلك أن نسبة النجاح، وهي 50% ، بقيت مستمرة تفرض نفسها. كانت تفرض نفسها بالأمس عن حق، أما اليوم فالحق فيها أقل.
خلاصة القول عندي هي ما يلي: يجب إعادة النظر في نظام الأكاديميات ونظام امتحانات البكالوريا. إن مجال الخطأ يتسع. كانت حالات الخطأ في النظام القديم محدودة. وكانت مراجعة الأوراق والنتائج التي يشتكي أصحابها أمرا معمولا به ولو في حدود، لأن المشتكين كانوا قليلين لكون حالات الخطأ كانت قليلة. والخطأ المتعمد لإنجاح قريب أو من يُتدخل له كان نادرا. وكان مجال “اقترافه” محدودا. أما اليوم فالجميع يشتكي. وأنا أعرف حالات وشكاوى نسبة الخطأ المحتمل فيها كبيرة، ومع ذلك فمدير الأكاديمية أجاب المشتكي بأنه لا يستطيع التأكد من الأمر إلا بأمر من الوزير. وهنا أتساءل: ما هي مسئولية مدير الأكاديمية؟ فإذا كان مكتوف اليدين حقا إلى درجة أنه لا يستطيع مراجعة حالة كهذه إلا بأمر من الوزير فهذا وضع ليس فيه من الأكاديمية شيء. إن الأكاديمية في هذه الحالة لا تعدو أن تكون ديكورا. أما إذا كان الأمر ينطوي على تهرب من المسئولية لسبب من الأسباب، فالتدخل عند الوزير إذا حصل يجب أن تكون نتيجته الحكم على المعني بالأمر بأنه لا يتحمل مسئوليته، وبما يجب أن يتلو ذلك من تدبير.
وما قيل بصدد الأكاديميات يصدق أيضا على النيابات والأقسام الأخرى التابعة للوزارة، المركزية منها والخارجية. ليست جميع الأكاديميات والنيابات والأقسام على درجة واحدة من سوء الحال. ولكن إصلاح التعاليم يجب أن يبدأ بإصلاح أجهزته وتجديدها وفسح المجال أمام العناصر ذات الكفاءة والمصداقية. وهذا شأن عام يصدق على الإدارة المغربية كلها.
لنكتف بهذا بالنسبة للمشاكل الإدارية ولننتقل إلى القضايا التي لها طابع تربوي وعلى رأسها مشكلة “التعريب”.
* ننشر فيما يلي نص حوار كانت أجرته معنا في مثل هذا الوقت السنة الماضية الأستاذة ربيعة ريحان، لينشر في مجلة كان من المفوض أن ترى النور بعد شهر أو شهرين من ذلك التاريخ، ولكنها لم تصدر لحد الآن حسب علمنا. لذاك رأينا من المفيد نشره هنا قبل أن يتجاوزه الزمن.
التعريب ، وحدة الوزارة، بطالة الخريجين
وإذن فبطالة الخريجين ليست نتيجة كثرتهم بل هي نتيجة عدم الوفاء بمتطلبات التنمية، متطلبات حقوق الإنسان في هذا المجال. ومعلوم أن حقوق الإنسان ليست في حرية التعبير وسيادة القانون فقط، بل هي أيضا الحق في التعليم وفي الصحة وفي الشغل. وماذا يبقى من إنسانية الإنسان إذا حرم من المعرفة والعناية الصحية ومن العمل الذي يكسب به قوت يومه؟
التعليم حق. وهو اليوم أول حقوق الإنسان، لأن عالم اليوم والغد هو عالم العلم والمعرفة. هذا شيء نعرفه وتلوكه ألسنتنا، فلنستحضر النتائج ولنتحمل مسئوليتنا
بخصوص التعريب يجب الفصل بين شيئين: بين ما هو ثابت ومبدئي لا مجال فيه للمراجعة ولا للتراجع، وبين ما هو قابل للتغيير والتطوير.
أقصد بالثابت هنا كون اللغة العربية هي لغة المعرفة في المغرب. ليس هناك في أي مكان من العالم بلد يضع لغته موضوعا للمناقشة. اللغة هي الوعاء الذي تنصهر فيه الهوية ووحدة الوطن والمواطنة، ففي هذا الوعاء وبه تتحقق وحدة المشاعر ووحدة الفكر ووحدة الذاكرة ووحدة التطلعات. بدون هذا لن تكون هناك هوية ممتلئة وغنية، ولن تكون هناك جذور ولا ثقة بالنفس. الهوية ليست شيئا جامدا جاهزا بل هي كيان يكون ويصير، ينمو ويغتني باللغة وما تحمله وتنشره من موروث حضاري. اللغة جزء جوهري من الكيان، من كياننا كمغاربة، ومن كيان الفرنسيين كفرنسيين والإنجليز كإنجليز والأمريكان كأمريكان الخ. هناك في بلدنا من يخلط بين العلم والمعرفة وبين التكلم بالفرنسية، ربما بنغمة باريسية. وهذا جهل مركب. أستسمح البقال والمرشد السياحي، فقد قدر لي أن واجهت بعض أولئك بالقول: “حتى البقال يتكلم الفرنسية إذا كان يسكن في حي “أوربي”. والحق أن كثيرا ممن يتشدقون بالفرنسية هم خالون من العلم، هم يجهلون الفكر الفرنسي والأدب الفرنسي. هم مجرد “بقالين”.
ليس من عادتي أن أتكلم بهذه اللهجة، ولكن لابد من تنبيه الغافلين. لقد حضرت ندوات عديدة في الخارج، وكثيرا ما لاحظت أننا نحن المغاربة، بل نحن العرب، نعرف عن الثقافة الفرنسية أكثر مما يعرف عنها كثير من المثقفين الفرنسيين. وبكل تأكيد هناك مستشرقون ومستعربون، فرنسيون وغير فرنسيين، يعرفون عن الثقافة العربية والإسلامية أكثر مما يعرف كثير من العرب والمسلمين. ليست اللغة هي العلم. بل وسيلة لتحصيل العلم.
قد لا يجادل أحد في هذه الأمور، ولكن هناك بالتأكيد من يقول ويلح في القول إن تدريس العلوم باللغة الفرنسية في مدارسنا الثانوية “مسألة ضرورية تفرضها الظروف”. وهذا في نظري قلب للأمور. ومع ذلك فلن أناقش هذه الدعوى لا من الناحية المبدئية ولا من ناحية مقتضيات الهوية ولا حتى من الناحية الوطنية. سأناقشها من الناحية الإجرائية فقط.
لنطرح السؤال الذي يسبق غيره في هذا المجال: ما هو الهدف من التعليم؟ ماذا ننتظر من التلميذ في الثانوي والطالب في العالي كشخصين نعدهما لكي يصبحا متعلمين وبالتالي قابلين إلى التحول إلى أطر فنية، إلى معلمين وأساتذة؟ أنا أقصد هنا بـ “معلمين” و”أساتذة” لا تعليم الأطفال والطلاب وحسب، بل أيضا الدخول في تواصل معرفي مع المواطنين: المهندس في المعمل والحقل، والطبيب في المستشفى والمصحة الخ، وبعبارة أخرى أقصد نقل المعرفة إلى المواطنين من خلال المهنة أو من خلال وسائل الإعلام. كيف يمكن لمتعلم درس العلوم باللغة الفرنسية أو الروسية أن يقوم بهذا النوع من التواصل المعرفي مع المواطنين في المغرب إذا كان يجهل العربية، أعني لا يستطيع توصيل العلم بها؟
المسألة واضحة: إما أن نجعل المغاربة جميعا يتكلمون الفرنسية أو الروسية الخ، أو أن نجعل المتعلمين الناقلين للمعرفة إلى الشعب يتكلمون العربية، وهي اللغة التي يفهمها المغاربة لأنها لغتهم. إما أن نجعل تعليمنا عربيا وإما أن نبحث عن بشر آخرين في المغرب لغتهم الوطنية هي الفرنسية أو الروسية أو… هناك جانب آخر لا بد من الإشارة إليه: لقد أصبح من المؤكد الآن عبر دراسات دولية أن الطفل يتعلم بسرعة أكبر بلغته الوطنية مهما كانت هذه اللغة.
هذه المسألة التي عرضتها هنا بهذه الطريقة المبسطة تدخل في صميم مشكل التنمية. التنمية تبدأ من التواصل المعرفي وهذا لا يتأتى إلا بلغة البلد. من المؤسف أننا مضطرون هنا إلى ذكر هذه البديهيات.
أما المسألة التي تطرح بصدد صلاحية اللغة العربية أو عدم صلاحيتها فهذه مسألة زائفة. فجميع لغات العالم صالحة. صالحة لأهلها. ليس هناك لغة أفضل من لغة. هناك فقط معرفة جيدة أو ناقصة بهذه اللغة أو تلك. ليست العبرية ولا الصينية ولا اليابانية أفضل ولا أسهل ولا أكثر قابلية للحياة من العربية. أهل اللغة هم الذي يمكن وصفهم بمثل هذه الأوصاف.
لقد تحدثنا قبل قليل عن ابن رشد الذي احتفل العالم في السنة الماضية بمرور ثمانية قرون على وفاته. كان ابن رشد مرجعية فلسفية وعلمية في أوربا، عليها وعلى مثيلاتها قامت نهضتها. ولم يكن ابن رشد يعرف غير اللغة العربية. كانت اللغة العربية لعدة قرون لغة العلم والفلسفة في العالم أجمع، كانت بمثابة الإنجليزية اليوم. واللغة العربية لم تتراجع ولم تتقهقر بل أهلها هم الذي لم يواكبوا التطور لأسباب لا علاقة لها باللغة. وهذا التقهقر الذي أصابنا وانعكس على لغتنا ليس قدرا لا يرتفع. وفي المغرب أمثلة عشناها ومرت أمام أعيننا. كان هناك وزراء يأتون إلى البرلمان فيتكلمون العربية بصعوبة ومشقة. ولكن لم تمر عليهم سوى أشهر حتى أصبحت لغتهم العربية سهلة سلسة مبينة، يعبرون بها في مجال المال والاقتصاد والسياسة وفي إطار من الجدل والمناورات الكلامية والتعبيرية عالية المستوى، مما لا يدع مجالا للشك في أنهم يمارسون اللغة العربية بصفة تلقائية طبيعية. اللغة إذن ممارسة. فإذا مارسناها في الأدب فقط كانت لغة الأدب، وإذا مارسناها في العلم فقط كانت لغة علم، وإذا مارسناها فيهما معا كانت لغة العلم والأدب.
هذا هو المبدأ وهذا هو المنطلق.
أما المسألة التي تطرح على مستوى العلاقة بين الثانوي والعالي، وعدم إمكانية تعريب العالي لعدم توفر الأساتذة والمراجع الخ، فهذا مشكل موضوعي فعلا. ولكن ليس الحل في الفرنسة انطلاقا من الثانوي. المشكلة تعاني منها معظم دول العالم بما في ذلك فرنسا نفسها، ولو بنسب متفاوتة. العلوم اليوم على مستوى التخصص الجامعي والبحث العلمي تستعمل اللغة الإنجليزية، لسبب بسيط وهو أن اللغة التي تفرض نفسها كلغة علم هي التي يقوم أصحابها بإنتاج العلم. إذن لابد من لغة أجنبية لمواكبة تطور العلم، وهذه اليوم هي بالتحديد الإنجليزية. وإذا كنا مضطرين لاستعمال الفرنسية فذلك فقط لأنا كنا مستعمرين من طرف فرنسا، وأن اللغة الفرنسية هي الآن في بلدنا أكثر حضورا من الإنجليزية، وهذا إرث استعماري يجب أن لا نجعل منه نظارات تشوه رؤيتنا. نحن مضطرون لاستعمال الفرنسية، ولكن مؤقتا فقط لأنه لابد من الإنجليزية في المستقبل المنظور على الأقل، اللهم إلا إذا استعادت فرنسا في المستقبل مكانة الريادة في إنتاج العلم. على أن هناك من الدراسات ما يتنبأ بأن لغة العلم في المستقبل ستكون غير أوربية، غير إنجليزية.
ومهما يكن، وفيما يتعلق بالظرف الراهن، نحن مضطرون في التعليم العالي إلى المزاوجة بين اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغة العربية. ولا نقصد بالمزاوجة مجرد الحضور الشكلي، بل نقصد تدريس المواد المقررة في معاهدنا الجامعية العلمية بعضها بالعربية كتاريخ الطب و”الطب الاجتماعي” وقسما من التشريح في كليات الطب وتاريخ العلوم وقسما من الطبيعيات في كليات العلوم الخ ، خصوصا الدروس العامة، وبعضها بالفرنسية وربما الأكثرية مؤقتا، وأيضا تدريس مواد أخرى باللغة الإنجليزية خصوصا في مرحلة التخصص الدقيق والبحث العلمي.
قد يقال: هذا يتطلب أن يكون الطلاب عارفين باللغات الثلاث. والجواب: هم فعلا يعرفونها ويمتحنون فيها في البكالوريا. ولكن الذي يحدث هو أن الطالب في الكليات الأدبية والقانونية يدرس جميع المواد بالعربية فينسى الفرنسية والإنجليزية، بينما يدرس زميله في الكليات والمعاهد العلمية بالفرنسية فينسى العربية والإنجليزية.
المشكلة إذن ليست هي كيف ندرس في العالي بالفرنسية بينما درسنا في الثانوي بالعربية، بل المشكلة هي: كيف نحتفظ في العالي بما تعلمناه في الثانوي من اللغات الثلاث. الطالب الذي نمتحنه في البكالوريا لا ينجح إلا إذا كان على مستوى معين في اللغات الثلاث. قد يكون هذا المستوى على غير ما يرام. والحقيقة أن الضعف عام في اللغات الثلاث كلها. وإذن فالمسألة التي يجب أن تطرح هي الرفع من مستوى اللغات الثلاث، ولتكن اللغة الثالثة، أو الثانية، هي الأسبانية في بعض المجالات. هناك هدر على مستوى تدريس اللغات يجب أن يعالج.
أما المصطلحات العلمية فهي ليست مشكلة، فجميع لغات العالم تقتبس المصطلح الأجنبي كما هو، عندما لا يكون هناك مرادف في لغتها الوطنية ولا إمكانية للاشتقاق. وتعلم المصطلح بأكثر من لغة يبدأ من التعليم الأساسي. وليست هناك طريق جاهزة سحرية لحل هذه المشاكل، فالممارسة وحدها مبدعة.
س- ما هو تقويمكم لتجربة تقسيم الوزارة إلى إعدادي وثانوي وعالي؟
ج- أعتقد أن تخصيص وزارة مستقلة للتعليم الأساسي وأخرى للثانوي وثالثة للعالي تدبير قد ينجم عنه إهدار كبير للإمكانيات المالية والبشرية والتجهيز، هذا فضلا عن الاحتكاك بين الإدارات وبين حدود الوزارات. والأخطر من ذلك كله عدم الصدور عن نظرة واحدة في وضع الخطط والتصاميم، وحرص كل طرف على الحصول على أكبر قدر من الميزانية. وهذا وضع قد سبق أن جربناه. إن مشاكل التعليم عندنا مترابطة متشابكة: مشاكل الثانوي هي في جزء منها استمرار لمشاكل الابتدائي والإعدادي، كما أن مشاكل العالي استمرار لمشاكل الثانوي. قد يكون هذا هو الحال في جميع البلدان ولكن خصوصية المشكل في المغرب يمكن رصدها فيما يلي:
عندما يتعلق الأمر ببلد قائم على المؤسسات وعلى حدود محكومة بقوانين، فقد لا تعرف مثل هذه الظواهر التي تستشري عادة في البلدان التي هي بصدد التحول إلى دولة القانون، أعني التحول من الشفوي إلى المكتوب، من الارتجال و اللاتنظيم إلى التسيير العقلاني المنظم، من الولاء للشخص إلى الامتثال للقانون. وبلدنا مازال في مرحلة التحول. عندما يكون الحال هكذا فتجزئة المسئولية في وزارة كوزارة التعليم يمكن أن تكون على حساب الانسجام والوحدة والسرعة في حسم المشاكل. ولهذا أرى أن الوضع الأفضل هو أن يكون على رأس وزارة التعليم ككل، بما في ذلك البحث العلمي، وزير واحد يتولى الإشراف العام، وتحت مسئوليته المباشرة وزراء أو كتاب دولة يكلف كل منهم بسلك من أسلاك التعليم.
هناك بطبيعة الحال مشكل توزيع المقاعد الوزارية بين الأحزاب في الحكومات الائتلافية التي تشكل من أحزاب متعددة. ومع ذلك يمكن تحقيق الوحدة في هذه الوزارة ككل عن طريق التفاوض بالتعويض بوحدة مماثلة في وزارات أخرى. على أنه في بلد كبلدنا، وفي وضع كالوضع الذي يعاني منه التعليم عندنا، يجب أن يمنح لقطاع التربية والتعليم أكبر قدر من الاستقلال عن الاعتبارات الحزبية. إن السياسة الوطنية للتعليم يجب أن يرسمها مجلس أعلى يضم جميع الفعاليات في ميدان التربية والتعليم والبحث العلمي، وكذا ممثلين عن هيئات المجتمع المدني ذات العلاقة. ويجب أن تتفرع عن المجلس الأعلى للتعليم لجان دائمة للمتابعة والمراقبة. ويجب أن تنظم العلاقة بين هذا المجلس والوزارة بقانون، حتى يعرف كل مجال مسئوليته.
هذا من جهة ومن جهة أخرى، نحن نعرف أن مشكل التعليم في بلدنا مشكل له تاريخ يمتد إلى بداية الاستقلال، فلا بد في من يتقلد مسئولية الإشراف عليه من أن يلم بهذا التاريخ حتى يتجنب تكرار التجارب الفاشلة. إن أي إصلاح للتعليم لا يمكن إلا في إطار نوع من الاستمرارية, فالمسألة تتعلق بأجيال تقضي سنوات في إطار معين فلا يجوز القفز بها إلى إطار آخر قفزا، بل لابد من المرحلية في هذا الميدان. باستطاعة وزير المالية مثلا أن يصدر ضريبة جديدة أو يلغي أخرى وقد لا يتطلب منه ذلك سوى مراجعة أرقام سنة واحدة. أما وزير التعليم فإنه يقرر في مسيرة أجيال وأجيال. لقد سبق لبعض التدابير الارتجالية في المغرب أن أدت إلى التضحية بأجيال بدون جدوى، وعلى رأس هذه القرارات قرارات التراجع عن التعريب، إضافة إلى قرارات اتخذت “على سبيل التجربة” باسم التجديد، بينما استفادت منها جهات أخرى ربما هي الـتي أملتها لنفس الغرض.
س- توقفتم قبل قليل عند التدهور في مستوى التعليم، لكن أعتقد أن هناك ما هو أخطر، وقد أشرتم إليه، أقصد ارتفاع مستوى الأمية، فكيف تقيمون هذا الأمر وما علاقة ذلك بالتنمية وما الاستراتيجية التي تقترحونها لتجاوز هذه الأزمة؟
ج- أعتقد أن السؤال يطرح دور التعليم في بلد متخلف؟ والجواب عن هذا السؤال يقتضي منا أن نعترف بأن المغرب هو فعلا بلد متخلف، ويقتضي منا كذلك أن نستحضر في أذهاننا المقاييس التي تقاس بها التنمية. من جملة هذه المقاييس بل وعلى رأسها نسبة الأمية. ومنها كذلك الوضع الصحي والبطالة ومستوى الدخل الخ، أي ما به تقاس اليوم التنمية البشرية التي صنف المغرب فيها مؤخرا في رتبة 125. فإذا أخذنا الأمر من هذه الزاوية أمكن القول إن التنمية تتوقف أولا على الحد من انتشار الأمية لأن الجوانب الأخرى تتوقف على محو الأمية. فليس بالإمكان الرفع من المستوى الصحي للسكان دون أن يكون هؤلاء على قدر كاف من التعليم، وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالشغل وغيره. فإذا نظرنا إلى دور التعليم من هذه الناحية اتضح أمامنا أن مقولة إدماج التعليم في المجتمع، التي تعني في أذهان البعض، تقييد عدد المتخرجين من التعليم بعدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع الخاص، هي مقولة زائفة. ذلك أن الذين يقولون بذاك يقيسون الأمور بفرنسا والدول المتقدمة حيث يشكل القطاع الخاص مجالا رحبا للعمل والإنتاج يفوق المجال الذي توفره الدولة ومستقل عنها. أما في المغرب فالمطلوب في الحقيقة هو إدماج المجتمع في التعليم، أقصد تعميم التعليم والرفع من مستواه، خصوصا والعمل اليوم يتجه أكثر فأكثر ليغدو عملا فكريا في كافة القطاعات.
يجب أن نستحضر الفوارق بين الدول، ويجب أن نستحضر كذلك آفاق التطور. فالوضع الراهن في فرنسا وأوربا وأمريكا هو نتاج تطور داخلي قوامه نظام رأسمالي تغلب على مشاكله بواسطة الهيمنة الاستعمارية والإمبريالية. فلا مجال للمقارنة بين وضعنا ووضع من كانت له الهيمنة على مقدرات بلدان أخرى، فاستطاع أن يبني اقتصادا وتعليما مندمجين في بعضهما. وبالنسبة لبلد كالمغرب ليست له بعد صناعة نامية ومتطورة قادرة على توفير الشغل لأكبر عدد من الأيدي التي تطلب الشغل فلا معنى للقول بأن “الحل” هو في إدماج التعليم في المجتمع. إن المطلوب هو تعميم التعليم في جسم المجتمع لتحريك عوامل التغيير والتجديد في كيانه. أما تبرير تقليص التعليم بعدم كفاية الموارد المالية فهذا تبرير يفتقد المصداقية أمام التبذير الذي نشاهده في كثير من المجالات والمناسبات.
س- وما قولك في بطالة المتخرجين؟
ج- فعلا هناك في المغرب متخرجون عاطلون، منهم أطباء وأطر عليا في مختلف التخصصات. والذنب ليس ذنب هؤلاء، فماذا تريد من شاب كد واجتهد حتى حصل على شهادة عليا في علوم الذرة أو في فروع أخرى من الفيزياء أو الكيمياء أو تخرج طبيبا أو ذا شهادة عليا في التجارة والاقتصاد الخ؟
إن عدم اندماج هؤلاء في “سوق الشغل”، بالمغرب كما هو اليوم، يعني أن هذه السوق قاصرة في القطاع الخاص، وأن الدولة عاجزة عن توفير الحد المطلوب دوليا من الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة الخ. المجتمع المغربي يشكو من الخصاص في عدد الأطباء. نحن ما زلنا بعيدين عن النسبة المقررة دوليا، أعني عدد الأطباء الواجب لعدد سكان المغرب. وكذلك الشأن فيما يتعلق بالتعليم والتجهيز الفلاحي وغير ذلك. أما العاطلون المتخصصون في مجال العلوم الفيزيائية والكيماوية فهم ضحية غياب مؤسسات البحث العلمي، سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص.
وإلى هذا وذاك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن تعليمنا الثانوي لا ينمو بالوتيرة التي تناسب عدد الشبان. إننا لو أردنا أن نرتفع بتعليمنا الابتدائي والإعدادي والثانوي والعالي إلى المستوى الذي يتناسب مع عدد السكان، المستوى الذي بلغه الأردن مثلا، لما كفتنا الأطر المتوفرة هذا المجال ولكان هناك عجز خطير. وإذن فبطالة الخريجين ليست نتيجة كثرتهم بل هي نتيجة عدم الوفاء بمتطلبات التنمية، متطلبات حقوق الإنسان في هذا المجال. ومعلوم أن حقوق الإنسان ليست في حرية التعبير وسيادة القانون فقط، بل هي أيضا الحق في التعليم وفي الصحة وفي الشغل. وماذا يبقى من إنسانية الإنسان إذا حرم من المعرفة والعناية الصحية ومن العمل الذي يكسب به قوت يومه؟
التعليم حق. وهو اليوم أول حقوق الإنسان، لأن عالم اليوم والغد هو عالم العلم والمعرفة. هذا شيء نعرفه وتلوكه ألسنتنا، فلنستحضر النتائج ولنتحمل مسئوليتنا.
(*) الحوار منقول عن موقع “منبر الدكتور محمد عابد الجابري “