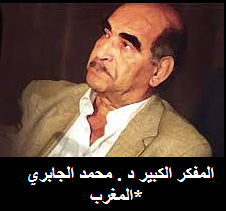نص الحوار الذي أجرته معنا جريدة “النهار” البيروتية في عددها الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 1998.
س- يلاحظ أن هناك تراجعا واضحا لدور الثقافة والفكر في الحياة العربية ، فما هي الأسباب، وكيف تفسر هذه الظاهرة؟
ج- فعلا، يمكن أن يقال إن هناك تراجعا ما على مستوى الثقافة في البلاد العربية. ولربما يكون من الدقة القول إن الحياة الثقافية العربية لم تتقدم إلى الأمام بالشكل الذي كان ينبغي أن تتقدم به، وهذا منذ أكثر من ثلاثة عقود على الأقل. ولا شك في أن هذا يعود إلى الوضع العربي العام. فالثقافة في أي مجتمع هي جزء من كل، وبالتالي فالتراجع الذي حصل في الجانب السياسي والإيديولوجي وعلى مستوى الأحلام الوطنية والقومية، كما على مستوى التنمية، خاصة منذ حرب 1967، كان من الطبيعي أن ينعكس أثره على المجال الثقافي. ولابد من الإشارة هنا إلى أن الازدهار الثقافي يتوقف أكثر على قدر كاف من الحريات الديموقراطية. فإذا غابت الحرية صعب على المفكر الحر التعبير عن رأيه وشعوره. وغياب الحرية في هذا المجال ظاهرة عمت الأقطار العربية جميعا باستثناء المغرب. فالثقافة في الأقطار العربية كانت وما تزال –إلى حد كبير- تحت إشراف الدولة التي تمارس التوجيه والرقابة عبر وزارة الثقافة أو غيرها من الأجهزة الحكومية، باستثناء المغرب الذي لم يكن فيه لوزارة الثقافة ولا لغيرها مثل هذا الدور. وهذا راجع إلى أن الثقافة في المغرب هي – تاريخيا- ثقافة معارضة، بمعنى أنها ميدان من ميادين المعارضة، وبالتالي فهي مستقلة عن السياسات الحكومية. وبطبيعة الحال يتطلب هذا الاستقلال الثقافي كثيرا من التضحيات وفي مقدمتها التضحية بمزايا الحكم. ولعل هذا ما يفسر ما يلاحظه بعض الاخوة في المشرق من وجود نوع من الازدهار الثقافي في المغرب، رغم التراجع الذي أشرنا إليه قبل.
س- إذن أنت تربط ازدهار الثقافة باستقلالها؟
ج- أنا أتحدث هنا عن تجربة، وعن معاينة للواقع المشخص. والحق أنه إذا كان هناك من ازدهار للثقافة في المغرب فهو نتيجة استقلال الثقافة، أعني استقلال المثقفين واعتمادهم على جهودهم الفردية وعلى التطوع، وعزوفهم عن مزايا الارتباط الدولة وأجهزتها. وأيضا تحملهم ما ينتج عن ذلك من حرمان أو عقاب. وواضح أن التراجع الذي نتحدث عنه هنا في مجال الثقافة في الأقطار العربية يمس الجانب التنويري للثقافة بوجه خاص. وهذا الجانب يتوقف على مدى الاستقلال الذي يحافظ عليه المثقف لنفسه، ولا أقول يعطى له. فالاستقلال لا يعطى إنما يؤخذ ويحافظ عليه. غير أن هذا التراجع ليس قدرا. ومثال المغرب يمكن أن يكون موضوع نظر وفحص. وعلينا نحن المثقفين أن لا نحمل الدولة كل شيء، بما في ذلك مسئوليتنا في الحفاظ على استقلالنا. فإذا اعتمد المثقف على نفسه وتحلى بالقناعة واعتز برأيه وتجنب التنازل عنه أمام أية ضغوط، بما فيها ضغوط العيش والحياة المترفة، فحينئذ سيكون له شأن. وفي المغرب نقول: “لا يمكن الجمع بين امتيازات الحكم وشرف المعارضة”، خصوصا في وضع غير ديموقراطي.
س- على مستوى الفكر السياسي العربي يلاحظ أيضا انكفاء واضح للفكر القومي وللسياسات القومية، أين نحن الآن في هذا المجال؟
– الفكر القومي، مثله مثل الفكر الماركسي والفكر التنويري ذي الأصول الفرنسية وفكر الإسلام السياسي، يدخل تحت مقولة الإيديولوجيا، بمعنى أن هذه الأنواع من الفكر تعبر عن مطامح وتطلعات تمليها ظروف معينة، فهي أحلام تشيد “المدينة الفاضلة”. وبما أنها ترتبط بالشروط التي تنتجها فهي تضمر بضمور تلك الشروط. وهكذا فإذا كان الفكر القومي قد أثبت حضوره في قسم واسع من الساحة الثقافة العربية، كما في الساحة السياسة، في الخمسينات والستينات، فذلك لأن ظروفا موضوعية، داخلية وخارجية، كانت مساهمة ومساعدة. هناك حقيقة علمية لابد من اعتبارها في هذا المجال، وهي أن الظروف المساعدة والمساهمة في إنضاج ظاهرة ما لا تكفي وحدها في إيجاد تلك الظاهرة، إذا لم يكن هناك في الواقع الموضوعي ما يمكن أن يكون بمثابة البيضة في عملية ظهور الدجاجة للوجود. فنحن لا نستطيع أن نحصل على دجاجة إلا إذا كانت هناك بيضة، وشروط موضوعية ضرورية. وإذن هناك عاملان في تراجع الفكر القومي: أحدهما خارجي والآخر داخلي. العامل الخارجي يتمثل في انحسار المد التحرري على المستوى العالمي، وهذا منذ أواخر الستينات، وما تلا ذلك من الهجمة الشرسة التي قامت بها الإمبريالية العالمية على شعوب العالم الثالث وقياداتها التحررية. هذا العامل الخارجي ساعد العامل الداخلي على عدم “التفريخ”، إن صح القول. فالعامل الداخلي يتمثل في كون “بيضة” الفكر القومي والسياسات القومية كان قد مر عليها وقت تكلست أثناءه موادها ولم تعد صالحة لا للتفريخ ولا للاستمرار . واليوم يحتاج الوضع العربي إلى فكر قومي جديد يختلف عن التصورات السابقة.
س- ماذا تقصد وكيف؟
ج- سأعطي مثالا. كان مفهوم الوحدة العربية في أواخر القرن الماضي وحتى أواخر الأربعينات من هذا القرن يكاد يكون مجاله محصورا في سورية الكبرى والعراق وإلى حد ما مصر. فلم يكن شعار الوحدة العربية يشمل المغرب العربي مثلا، ولا الخليج، ولا حتى السودان واليمن. وهذا مفهوم. فكثير من هذه “الأطراف” لم تكن حاضرة في الوعي التاريخي الذي كان لـ”المركز”. والوحدة العربية ارتبطت تاريخيا بالتحرر من الحكم العثماني. وهذه “الأطراف” إما أنها لم تكن تعيش تحت الحكم العثماني وإما أنها لم تكن تمثل قوة متميزة، فهي إلى واقع التبعية أقرب. وما أريد أن ألفت النظر إليه هنا هو أن النظرية القومية التي قامت على أساس أن الوحدة هي وحدة سورية الكبرى، والعراق إلى حد ما، قد فهمت من “الوحدة” وحدة الدولة، أعني الوحدة الاندماجية. وهي وحدة ممكنة إذا نحن حصرنا تفكيرنا في “سورية الكبرى”. أما إذا وسعنا أفق الوحدة إلى خارجها فإن الوحدة الاندماجية تصبح حلما يسير الواقع في اتجاه مضاد له. فالحركات الاستقلالية هي حركات من أجل إنشاء الدولة المستقلة أو بعثها، الدولة التي نسميها الآن الدولة القطرية، وليس دولة الوحدة. بعبارة قصيرة كان الفكر القومي يمارس نوعا من التعميم غير مطابق لتطور الأمور واقعيا. ومع أن هذا كان مبررا في أول الأمر، فإن استمراره في الخمسينات والستينات، إلى درجة اعتبار الحديث عن وحدة فيدرالية كفرا في حق الوحدة، كان سلوكا غير تاريخي.
س- وما هي النتائج التي ترتبت عن ذلك؟
ج- النتيجة أن شعار الوحدة الذي كان مداه محصورا في الأصل في الهلال الخصيب صار يطبق على الوطن العربي من الخليج إلى المحيط. وهذا حكم بالجزء على الكل. إن هذا يعني غياب مقولة الاختلاف والتنوع عن الفكر القومي آنذاك.
س- كيف تنظر في إطار هذا السياق إلى الدول-الكيانات اليوم؟
ج- نحن اليوم نعيش وضعا آخر مختلفا تماما. إن الدولة القطرية العربية قد أصبحت منذ مدة حقيقة دولية ونفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية، فضلا عن أن كثيرا من الدول العربية القطرية هي أصلا ذات خصوصية جغرافية وتاريخية. وبالتالي فمفاهيم الوحدة الاندماجية وإقليم القاعدة وما أشبه، هي غير مناسبة تماما بل هي منفرة ومضرة وليس واقعية. والطريق الوحيد الممكن اليوم إلى الوحدة هو الديموقراطية. أعني الديموقراطية داخل كل دولة وأيضا في المعاملة بين الدول القطرية نفسها.
س- لاشك أن ما يغيب في العالم العربي هو الحريات الديموقراطية، فكيف حل هذه المشكلة؟
ج- الحرية شيء ينتزع ولا يعطى. ومن أجل أن يكون الإنسان العربي حرا لا بد من أن يكون مستعدا لدفع الثمن. نحن في المغرب لدينا هامش كبيرا من الحرية على مستوى الصحافة والمجلة والكتاب والإعلام عموما، وهذا نتيجة مسلسل من المد والجزر استمر أربعين سنة، أي منذ الاستقلال إلى اليوم. وصحافة المعارضة في المغرب طوال هذه الأربعين سنة، وهي المعنية قبل غيرها بحرية القول، انتزعت هذه الحرية انتزاعا: بنضالها وتضحياتها وتحملها للمتابعات القضائية و للسجون والحجز المتكرر الخ. كل هذا كان جزءا من حياة الصحافة عندنا، وباستمرار النضال والتضحيات والإصرار على حرية القول بدأ المسئولون في المغرب يعتادون ويألفون خطاب المعارضة وانتقاداتها فيردون ببيانات حقيقة بدل العصا. واليوم أقول: إن التضحيات والنضالات التي استمرت أربعين ستة أنتجت مكسبا وطنيا هاما هو هذا الهامش الكبير من حرية التعبير الذي يتمتع به الجميع بما في ذلك المعارضة الحالية التي كانت بالأمس في الحكم تطارد حرية التعبير.
س- إذن أنت تدعونا إلى الأخذ بالتجربة المغربية؟
ج- أنا لا أقصد التجربة المغربية بذاتها ولذاتها، بل أقصد لفت الانتباه إلى أن ما يتمتع به المغرب اليوم من هامش عريض على مستوى حرية التعبير هو نتيجة نضال وتضحيات وتوافق وتراجع ثم توافق وتقدم.
س- لماذا فشلت الليبرالية في الأقطار العربية؟
ج- سؤال، الإجابة عنه صعبة. تحتاج إلى تفصيل القول. يمكن الإشارة مثلا إلى أن مصر شهدت نوعا من الليبرالية في الأربعينات وكذلك العراق وسورية ولبنان. ولكن هذه الأنظمة الليبرالية فسدت وأجهضت. ولربما كان العامل الخارجي هو المسئول الأول، أعني بذلك التدخلات الاستعمارية الإمبريالية ومقتضيات الحرب الباردة. ولنا في تجربة محمد علي بمصر خير دليل على ذلك.
س- إذا كانت الأصولية وجها من وجوه فشل التيار القومي وانتكاس تجربة التحديث والتطوير، فهي أيضا حالة تؤدي إلى الانقسام والاقتتال كما يحصل في بلدان عربية معروفة. ما هو رأيك؟
ج- أعتقد أنه لابد من الفصل بين عاملين فيما يسمى “الأصولية” أو “الإسلام السياسي”. العامل الأول هو الظروف الاجتماعية الاقتصادية والفكرية التي تنتج هذه الظاهرة أو على الأقل تغذيها. والعمل الثاني هو التطرف الديني. وفي جميع الأيديولوجيات هناك دوما موقع ما للتطرف والغلو. وموقعه الطبيعي هو الهامش والأطراف. غير أن الأمر يختلف تماما عندما يقع تبادل في الموقع، أي عندما يصبح التطرف في المركز والاعتدال في الأطراف. وهذا راجع أساسا إلى ظروف الظلم الاجتماعي والحرمان وعدم تكافؤ الفرص. وقد سبق لي أن قلت مرارا إنه لو كان الزمان زمان الماركسية لكان كثير من الشباب الذين يستقطبهم اليوم التطرف الديني أو الإثني يعملون في صفوف التطرف الماركسي، وهذا سبق أن حدث.
س- في مجال التحديد الدقيق لماذا هم إسلاميون؟
ج- بطبيعة الحال أنت تميز بين “مسلمين” و”إسلاميين”، وتعني هذا الصنف الأخير الذي يمارس التطرف باسم الإسلام؟ وإذن يجب النظر إلى هذه الظاهرة بوصفها ظاهرة تطرف. وفي رأيي أن من أسباب ظهور التطرف، سواء باسم الإسلام أو باسم العرق أو باسم الطائفة أو باسم أيديولوجية ما، هو أولا وقبل كل شيء غياب الديموقراطية، إضافة إلى الظروف الاجتماعية الاقتصادية التي تحدثنا عنها. فعندما يمارس الإقصاء على هذه الفئة أو تلك يكون رد الفعل هو التطرف. ونحن نعرف أن ظاهرة التطرف باسم الإسلام إنما برزت أكثر ما برزت في الأقطار التي ساد فيها الحزب الوحيد. ففي هذه الأقطار ألقي بالأغلبية في الهوامش، وكان يكفي أن يقوم داعية إسلامية ليلتف حوله هؤلاء المهمشون المقموعون ليشكوا البديل الذي يحل محل الحزب الوحيد عندما تنفجر تناقضاته. من هنا يتضح أن العلاج الصحيح لظاهرة التطرف هو فسح المجال للجميع، بما في ذلك الإسلام السياسي نفسه، ليتمتع بالحق في الانخراط في الحياة السياسية العامة·
أجرى الحوار: هاشم قاسم