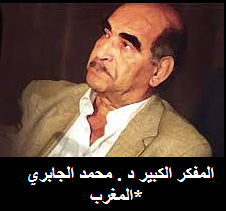نظرة إجمالية:
اسمه الأصلي جوزيف ألْوَا راتزنجير Joseph Alois Ratzinger ، مولود بتاريخ 17 أبريل 1927 : في ماركتل، بافاريا، ألمانيا. من علماء اللاهوت الكاثوليك. تولى كرسي البابوية عقب وفاة البابا جان بول الثاني في 19 أبريل 2005، ولقب بلقب بابوي ينطلق بالإيطالية Benedetto وبالإنجليزية بنيدكت benedict وبالفرنسية بينويت benoit، وهو من اللاتينية بينديكتوس Benedictus بمعنى: “المبارك”، (“باركه الله”).
ألقى البابا بينيدكتوس السادس عشر يوم في 12-09-2006 خطابا أثار زوبعة من الاحتجاج في العالم العربي والإسلامي بسبب عبارات تنم عن سوء فهمه لقضايا من صميم العقيدة الإسلامية. والآن وقد هدأت الزوبعة، أو في سبيلها إلى أن تهدأ، وصدرت ترجمات كاملة لهذا الخطاب، بالإنجليزية ثم بالفرنسية، بعد أن ظل المنشور المذاع منه باللغة العربية مجرد فقرات أو ترجمات ناقصة وسريعة، ارتأينا أن نخص قراءنا بدراسة هادئة لهذا الخطاب الذي يرقى بشكله ومضمونه إلى مستوى النصوص المبنية الهادفة، الحاملة لرؤية، الداعية إلى برنامج. لم يكن الخطاب مجرد عظة بل كان رسالة إلى الجامعات في العالم المسيحي وأهلها أولا، وإلى جميع الذين يفكرون في الشأن الديني من منظور فلسفي/سياسي. ذلك ما يشي به عنوان الخطاب الذي جعله البابا من ثلاث كلمات: “الإيمان والعقل والجامعة”، مع عنوان فرعي : ذكريات وتأملات”. كما يشتمل الخطاب على رسالة، على طريقة “إياك أعني واسمعي يا جارة”، موجهة إلى المسلمين، وإلى المعنيين منهم بحوار الأديان بصفة خاصة.
“الإيمان والعقل والجامعة”، ثلاث كلمات تحدد موضوع الخطاب وترسم آفاقه منذ البدء. وتأتي آخر جملة فيه لتعود بالقارئ إلى عنوانه، وأيضا لتنسيه –مؤقتا- أشياء كثيرة تضمنها الخطاب. لقد أسهب البابا في بيان ما أسماه تلاحم العقل والإيمان في العقيدة المسيحية ثم ختم بالإفصاح عن الجهتين اللتين يوجه خطابه إليهما؛ فقال أولا: “ذلك هو البرنامج الذي يجب أن يعتمده اللاهوت المبني على العقيدة الإنجيلية في حوارات عصرنا”، مضيفا: “وبهذه الرحابة التي للعقل ندعو شركاءنا في حوار الثقافات”، والمقصود : المسلمون الذين قال عن دينهم في مستهل الخطاب إنه لا يعتمد العقل؛ وقال ثانيا وأخيرا: “والسعي المتواصل للكشف عنها (=رحابة العقل) هو المهمة الكبرى للجامعة”، مشيرا بذلك إلى ضرورة تدريس اللاهوت المسيحي في الجامعات.
وإذن، يخاطب البابا هنا طرفين: “شركاء في حوار الثقافات” والمقصود في الأساس المسلمون من جهة، ومن جهة أخرى عمداء الجامعات وأساتذتها الذين ألقى فيهم خطابه –على شكل محاضرة- وكان يتحدث إليهم في جامعة Regensburg بألمانيا، مطالبا بالعودة إلى تدريس اللاهوت المسيحي في الجامعات بوصفه أحد العلوم الإنسانية.
وبين عنوان الخطاب وآخر كلماته تتسلسل قضايا دينية وفلسفية و”سياسية” هامة تعرضت، بنوع من الفضول، وبكثير من الاختزال، وفي إطار مسار تأويلي مرسوم بعناية، لمسائل تنتمي إلى الماضي والحاضر، إلى الدين والفلسفة والعلم: فقرات تنم عن عدم فهم (فكري وفلسفي) لأمور لها علاقة بعقيدة الإسلام (الجهاد، مسألة الجبر والاختيار)، وأخرى تقدم تأويلا لمرحلة من مراحل تكوُّن التوراة قد لا يرتاح اليهود لما أدلى به في شأنها، وفقرات تخص العلاقة بين المسيحية والفلسفة الأفلاطونية المحدثة تريد أن تعيد كتابة تاريخ العقيدة الكاثوليكية، في الوقت الذي تنال فيه بهدوء وبـ”كلام صامت” من الكنائس الشرقية. هذا مع القفز على المرحلة “المدرسية”، اللاهوتية/الفلسفية، في القرون الوسطى بأوربا، والاقتصار على بضع كلمات في موضوع الإصلاح الديني الذي انبثقت عنه البروتستانتية. أضف إلى ذلك الخوض في قضايا هي من صميم فلسفة العلوم، والشكوى من كون الفلسفة الوضعية قد ضيقت من مجال العقل عندما استبعدت من ميدانه البحث في “طبيعة الله” فأقصت الميتافيزيقا، وبالأحرى اللاهوت، من مشروعها المنطقي الفلسفي. وأخيرا، وليس آخرا، يدخل البابا في جدال مع مواطنه ومعاصره العالم المؤرخ والفيلسوف الألماني هارناك الذي دعا إلى تجريد العقيدة المسيحية من القول بألوهية المسيح والقول بأن الله ثالث ثلاثة، والرجوع بالتالي إلى المسيحية الأولى كما مارسها المسيح عليه السلام، بوصفها أخلاقا، بدون شعائر وطقوس وعبادات…
قبل أن نشرع في مناقشة هذا الخطاب قمنا بترجمته إلى العربية كاملا عن الترجمتين الإنجليزية (التي نشرها الفاتيكان في موقعه الالكتروني) والفرنسية (التي نشرتها جريدة لاكروا المسيحية). ومن أجل أن نسهل على القراء متابعة تحليلنا لهذا الخطاب -الذي ننشر هاهنا نصه الكامل موزعا على فقرات يتخللها “تفكيك الأصول وتصحيح الفصول”: الأصول التي تؤسس بنية الخطاب والفصول التي تحمل الرأي ووجهة النظر- نقدم فيما يلي محتوى فقراته من خلال العناوين التالية التي هي من وضعنا:
1) ذكريات البابا عن حياته الجامعية.
2) رأي الإمبراطور البيزنطي في موضوع الجهاد ومسألة “الجبر والاختيار” في الإسلام،
3) العقل الإغريقي واللاهوت المسيحي.
4) تأثير العقل اليوناني في التوراة من خلال الترجمة والاحتكاك.
5) القطيعة بين الروح الإغريقية والروح المسيحية في القرون الوسطى.
6) نقد النزعة المطالبة بتجريد اللاهوت المسيحي من الطابع اليوناني.
7) شروط الحوار بين الديانات.
تلك هي القضايا التي تناولها البابا في خطابه المثير. وسنقوم بتحليلها والتعليق عليها على الترتيب معتمدين نص الخطاب. كما سنتوقف خلال العرض مع القضايا التي تحتاج إلى توضيح أو تصحيح منبهين كلما كان ذلك ضروريا إلى ما سكت عنه الخطاب أو أهمله أو ضخمه الخ.
لنبدأ من البداية
استهل البابا محاضرته بالقول:
أصحاب المعالي، أصحاب السعادة ، أصحاب السمو، سيداتي سادتي:
“إنها بالنسبة لي لتجربة مؤثرة أن أعود إلى هذه الجامعة مرة أخرى وأن أقوم من جديد بإلقاء محاضرة من هذه المنصة. إنني أجدني الآن أستعيد في ذاكرتي تلك السنوات التي التحقت فيها بجامعة بون كأستاذ، بعد أن قضيت فترة من الزمن مفعمة بالهناء والسعادة في المعهد العالي لمدينة فريزينغ Freising. كان ذلك عام 1959، على عهد الجامعة القديمة، التي كان التدريس فيها يعتمد على الأساتذة كأفراد عاديين حيث لم يكن هناك لأصحاب الكراسي، لا مساعدون ولا مكلفون بالسكرتارية. ولكن كان هناك بالمقابل اتصال مباشر وواسع بين الأساتذة والطلبة وبكيفية خاصة بين الأساتذة بعضهم مع بعض. لقد كان الأساتذة يلتقون قبل الدروس وبعدها في القاعة المخصصة لهم، حيث كانت تجري مناقشات مفيدة مليئة بالحيوية، بين المؤرخين والفلاسفة واللغويين، كما بين أساتذة كليتي اللاهوت اللتين كانتا من ضمن كليات الجامعة. وكان هناك، في كل منتصف سنة دراسية، ما كان يسمى بـ”اليوم الأكاديمي” «dies academicus» حيث يتحدث جميع أساتذة الكليات أمام جميع طلابها محققين بذلك تجربة “جامعة” «universitas»، وهي ما أطلقتم عليه من قبل، أصحاب السعادة العمداء: “التجربة”. وبعبارة أخرى إنه رغم اختصاصاتنا التي تجعل من الصعب في بعض الأحيان اتصال بعضنا ببعض وتبادل الأفكار فيما بيننا فإننا كنا نشكل كلا واحدا في هذه المناسبة، نتناول كل موضوع اعتمادا على العقل بكامل أبعاده، واعين أننا نتقاسم مسؤولية الاستعمال السليم للعقل. لقد كانت فعلا تجربة حية، عشناها في جو حميمي.
كانت الجامعة فخورة بكليتيها المتخصصتين في اللاهوت. لقد كان واضحا أن هاتين الكليتين، اللتين تعملان على إضفاء الطابع العقلي على العقيدة، كانتا تساهمان بعمل كان يشكل بطبيعة الحال جزءا من كل، أعني جزءا من “كلية المعرفة” universitas scientiarum، وذلك على الرغم من أن الجميع لم يكن على درجة واحدة من الإيمان بالعقيدة التي كان اللاهوتيون يحاولون إضفاء الطابع العقلي عليها. ولم يكن هذا المعنى العميق للانسجام على مستوى عالم العقل موضوع تشويش قط، حتى عندما ترامى إلى سمعنا أن أحد زملائنا قال يوما: إن جامعتنا تنطوي على شيء غريب، وهو تخصيص كليتين لشيء لا وجود له، يعني: الله. ذلك أنه حتى إزاء شك مطلق مثل هذا فإنه من الضروري ومن المعقول القيام بالبحث العقلي في مفهوم الله، وفي إطار العقيدة المسيحية. وهذا كان مقبولا في الجامعة كلها بدون مناقشة” (ننبه إلى أن مفهوم الله في المسيحية ملفوف بـ “الأسرار”، من حيث أنه ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس، واللاهوت المسيحي مشغول أساسا بإضفاء المعقولية على هذا التركيب في الألوهية: اتحاد اللاهوت بالناسوت. وسنزيد هذه المسألة توضيحا لاحقا).
لعل القارئ يلاحظ معنا أن هذا المدخل جيد للغاية من حيث إنه يقود القارئ منذ البداية وبصورة مباشرة إلى موضوع المحاضرة (الإيمان، والعقل، والجامعة)، وبالتالي فلقد كان من المنتظر أن ينتقل البابا مبشرة ودونما أية واسطة إلى النقطة الثالثة أعلاه (العقل الإغريقي واللاهوت المسيحي).
لكن الحبر الأعظم خرج عن “الخط المستقيم” (على صعيد بنية الخطاب) لينحرف “شرقا”، ويحكي قصة حوار منسوب إلى إمبراطور بيزنطي وعالم امسلم من فارس.
حوار الإمبراطور البيزنطي والعالم الفارسي: خطأ مضاعف …
ترك البابا المقدمة الطبيعية والجيدة التي عرضناها في المقال السابق لينتقل إلى موضوع غريب عن مجال خطابه، موضوع يثير انتباه القارئ و”الرائي” لكونه قد أقحم في سحنة الخطاب إقحاما، مما يجعله يبدو للناظرين كوَرَم على أحد الفكين.
وقبل أن نعلق على محتوى “الورم” وعلى طبيعته نترك البابا يواصل إلقاء خطابه. قال، مباشرة بعد المقدمة الذي اطلعنا عليها في مقال أمس:
“تذكرت كل هذا (يقصد ذكرياته الجامعية المذكور قبل) في الأيام القليلة الماضية عندما قرأت قسما من حوار نشره البروفسور تيودور خوري من جامعة مونستر Münster، حوار كان قد جرى –ربما عام 1391 في الثكنات الشتوية لمدينة أنقرة- بين الإمبراطور البيزنطي الذي كان على نصيب من المعرفة، مانويل الثاني باليولوغوس Paleologus وبين عالم فارسي. وقد دار الحوار حول موضوع المسيحية والإسلام، وحقيقة عقيدة كل منهما. والغالب أن الإمبراطور نفسه هو الذي سجل هذا الحوار، خلال حصار القسطنطينية ما بين 1394 و1402، وهذا ما يفسر كون آرائه هو جاءت أكثر تفصيلا من أجوبة محاوره العالم الفارسي”.
نفتح هنا قوسين للتذكير بالظرف التاريخي الذي جرى الحوار في إطاره. يتعلق الأمر بحصار القسطنطينية من طرف العثمانيين. ومعلوم أن هذه المدينة التي كانت عاصمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية (أو البيزنطية نسبة إلى بيزنطة عاصمتها، والبيزنطيون هم “الروم” بالاصطلاح العربي الإسلامي)، قد جددها قسطنطين الأول عام 335 ميلادية فسُميت باسمه (القسطنطينية)، وكانت هذه الإمبراطورية قد انشقت عن الإمبراطورية الرومانية التي كانت عاصمتها روما. هذا وقد حاول المسلمون فتح القسطنطينية مرات عديدة ولكن لم يتمكنوا من ذلك، بسبب موقعها الجغرافي وتحصيناتها، إلا زمن السلطان العثماني السابع محمد الثاني، وذلك سنة 1453، فلقب بـ “محمد الفاتح”. هذا وقد جرت محاولة العثمانيين الأولى لفتح القسطنطينية في عهد السلطان با يزيد الذي حاصرها عام 1393 غير أنه اضطر إلى تخفيف الحصار عنها لينصرف إلى مواجهة المغول الذين كانوا قد اكتسحوا بلاده بقيادة تيمورلنك، فدارت بينهما معركة أنقرة التي أسر فيها با يزيد وتوفي عام 1402. وواضح أن الحصار الذي يشير إليه البابا والذي حدد زمنه ما بين 1394 و1402 هو الذي تم زمن با يزيد الذي كان مرابطا بأنقرة ، قبل أن يضطر لترك الحصار والذهاب لمواجهة جيوش تيمورلنك.
وما يهما إبرازه هنا هو أن الحوار الذي تحدث عنه البابا جرى بين الإمبراطور البيزنطي مع الرجل الفارسي المسلم زمن الحرب. وهذه الحرب لم تكن حربا دينية، فلقد كان الإمبراطور وشعبه مسيحيين، ولم يكن من الجائز في الشرع الإسلامي تحويلهم إلى الإسلام بالسيف، بل كان المطلوب منهم شيء واحد، هو الاعتراف بسلطة الدولة الإسلامية (وهي هنا الدولة العثمانية) والبقاء في أرضهم على دينهم مع دفع “جزية” هي بمثابة الضريبة التي يدفعونها لدولتهم. فالحرب التي جرى الحوار في ميدانها حرب سياسية. والعنف المرافق لها كان عنفا من سلطة سياسية وليس من طرف دعوة دينية. والحرب السياسية لم تكن خاصة بالمسلمين وحدهم فقد خاضها المسيحيون على عهد الإمبراطورية الرومانية بفرعيها الغربي والشرقي، كما خاضتها وتخوضها دول العالم وأممه منذ بداية التاريخ البشري. فهل سنحمل المسيحية كدين، مسؤولية حروب أوربا الكثيرة المتعددة، الصليبية منها، والدينية، والاستعمارية؟
إذن، لا شيء يبرر اتهام البابا للإسلام باستعمال السيف في نشر عقيدته بحجة حصار المسلمين للقسطنطينية. وإذا كان وضع الإمبراطور كملك يعاني هو وبلاده من حصار دولة إسلامية يبرر من الناحية السيكولوجية على الأقل ربطه بين الإسلام والعنف، مع محدودية معرفته بعقيدة الإسلام وشريعته، فنحن لا نرى ما يبرر اتخاذ البابا لأقوال الإمبراطور حجة على الإسلام، سوى أن تكون معرفته بالإسلام لا تتعدى حدود معرفة الإمبراطور.
لنغلق القوس ولنترك البابا يُكمل ذكراه لِما قرأه عن حوار الإمبراطور مع العالِم الفارسي المسلم. قال:
“لقد تناول هذا الحوار بتفصيل بنية العقيدة كما هي في كل من الإنجيل والقرآن، وبكيفية خاصة صورة الله وصورة الإنسان في كل منهما. وبطبيعة الحال كان لا بد أن يتعرض الحوار مرات عديدة للعلاقة بين ما كان يطلق عليه “قوانين” أو “نواميس الحياة” الثلاثة، (الشرائع الثلاثة) يقصدون بذلك: العهد القديم (التوراة)، والعهد الجديد (الإنجيل)، والقرآن”.
ويضيف البابا قائلا: “ليس في نيتي مناقشة هذه المسألة خلال هذه المحاضرة، أريد فقط أن أتحدث عن نقطة واحدة؛ ومع أنها هامشية بالنسبة لمجموع الحوار فإنني أجدها ذات أهمية خاصة في موضوع “الإيمان والعقل”، وبالتالي صالحة لأتخذ منها نقطة انطلاق لتأملاتي في هذا الموضوع”.
ويواصل البابا خطابه فيقول: “تناول الإمبراطور، في المناظرة السابعة التي نشرها البروفسور خوري، مسألة الجهاد (في الإسلام)، ولم يكن الإمبراطور ليجهل أن السورة رقم 2 (البقرة) تقول في الآية التي رقمها 256 “لا إكراه في الدين”. وحسب ذوي الاختصاص في الموضوع فإن هذه السورة هي من أوائل السور (كذا!)، وترجع إلى وقت لم يكن فيه محمد (عليه السلام) قد أصبح صاحب سلطة بل كان ما يزال معرضا للتهديد. ومما لاشك فيه أن الإمبراطور كان، على معرفة بالأحكام التي وردت فيما بعد مفصلة في القرآن، وتتعلق بالحرب المقدسة (الجهاد). وهكذا، ودون أن يدخل الإمبراطور في تفاصيل مثل تلك التي تتعلق بالفرق في المعاملة بين الذين لهم “كتاب” والذين هم “كفار” فاجأ محاوره الفارسي بأسلوب لا يخلو من حدة، فطرح عليه سؤالا حول المسألة المركزية المتعلقة بالعلاقة بين الدين والإكراه بكيفية عامة، فقال : “أرني إذن ما الذي جاء به محمد من جديد؟ إنك لن تجد غير أمور شريرة ولاإنسانية، مثل ما أمر به من استعمال السيف لنشر العقيدة التي جاء بها”.
ويضيف البابا: “وبعد أن طرح الإمبراطور هذا السؤال بمثل هذه الوضوح أخذ يشرح بالتفصيل الأسباب التي تجعل نشر العقيدة بالقوة عملا غير معقول، لأن العنف يتنافى مع طبيعة الله ومع طبيعة الروح. قال : “الله لا يحب إراقة الدماء، كما أن عدم اعتماد العقل في التصرف شيء يتنافى مع طبيعة الله. إن الإيمان منبعه الروح وليس الجسد. وكل من يريد أن يحمل الناس على الإيمان يجب أن يمتلك القدرة على الكلام المقنع والاستدلال الصحيح، ويتجنب العنف والتهديد. فمن أجل إقناع نفس عاقلة لا حاجة إلى سواعد قوية ولا إلى أي سلاح كيفما كان، ولا إلى أي نوع من أنواع التهديد بالقتل”.
ويعلق البابا على ذلك بالقول: إن القول الفصل في هذه الحجة الموجهة ضد استعمال العنف في الدعوة الدينية هو التالي: إن عدم اعتماد العقل في التصرف شيء يتنافى مع طبيعة الله”.
تلك هي الفقرات التي أثارت المسلمين، فقامت احتجاجات، واتُخذت مواقف، وطولب البابا بالاعتذار؛ غير أنه لم يعتذر، وإنما كرر القول بأن خطابه أسيء فهمه، وأنه لم يقصد الإساءة إلى الإسلام. ودون أن نكرر ما قيل في الرد عليه، وبعيدا عن محاكمة نواياه، فإننا لا نملك إلا أن نلاحظ أن الحبر الأعظم ارتكب خطأ مضاعفا:
فمن جهة لا بد أن يتساءل المرء: لماذا اختار البابا أن يقحم في خطابه الجامعي الأكاديمي الديني عبارات صدرت من إمبراطور بيزنطي في القرون الوسطى تتهم رسول الإسلام بالأمر باستعمال السيف في نشر الدعوة، وأن يتجه بهذه العبارات، بطريقة “إياك أعني واسمعي يا جارة” إلى مخاطب بعينه هو العالم الإسلامي؟ نعم هناك عنف يمارس باسم الدين في بعض أنحاء العالم الإسلامي، ولكن هل هو عنف من أجل نشر دعوة الإسلام أم أنه رد فعل ضد أنواع من التسلط والاحتلال كما في فلسطين والعراق؟
ومن جهة أخرى لماذا احتكر البابا للمسيحية وحدها التصريح بأن الفعل الذي لا يجيزه العقل مخالف لـ”طبيعة الله”، وفي القرآن ما لا يحصى من الآيات والعبارات التي تحث، بل توجب اعتماد العقل في الفكر والسلوك؟ وهل كان ما أخذته المسيحية من العقلانية اليونانية أكبر مما أخذه المسلمون، فلاسفة ومتكلمون وعلماء وفقهاء؟
سؤالان لا بد من إلقاء ما يكفي من الأضواء عليهما خدمة للحقيقة، وليس ردا على البابا. لكن لابد من القول إن تعرضه لهاتين المسألتين بالطريقة التي تعرض بها لهما خطأ ما كان يليق به أن يغامر بارتكابه وهو “الحبر الأعظم”، رجل المواعظ والطقوس المعروفة!
(ملاحظة: حصل خطأ مطبعي في المقال السابق إذ وردت كلمة “اللاهوت” في الفقرة الثالثة من الأخير مكان كلمة “الله”، في الجملة التي تبتدئ بقول البابا: “إن جامعتنا تنطوي على شيء غريب …” فوجب التنبيه للأمانة العلمية، علما بأن حاكي الكفر ليس بكافر).
لا إكراه في الدين …
ذكر البابا في خطابه أن حوار الإمبراطور البيزنطي مع العالم الفارسي (المقال السابق) تناول “صورة الله” و”صورة الإنسان” في كل من الإنجيل والقرآن، وأنه تعرض لما سماه “نواميس الحياة” الثلاثة (=الشرائع)، اليهودية والإنجيلية والقرآنية، كما أشار إلى أن الإمبراطور البيزنطي كان يعرف حكم القرآن في معاملة أهل الكتاب (ومن دون شك فالبابا يعرف ذلك أيضا)، ولكن البابا أقصى جميع هذه المسائل من حقل تفكيره، ليقتصر كما قال على مسألة واحدة قال عنها إنها أهم بالنسبة لموضوعه وأنه سيتخذ منها نقطة انطلاق لتحليلاته.
هذه المسألة هي ادعاء الإمبراطور، وبالتالي البابا، أن رسول الإسلام : “أمر باستعمال السيف لنشر العقيدة التي جاء بها”. وفي هذه المسألة بالذات عمد البابا –وليس الإمبراطور هذه المرة- إلى استبعاد قوله تعالى: “لا إكراه في الدين” (البقرة 256)، بدعوى أن “ذوي الاختصاص” قالوا إنها نزلت في وقت لم يكن رسول الإسلام قد تحول إلى صاحب سلطة (رئيس جماعة أو دولة) وإنما كان يعيش تحت تهديد قومه قريش. استبعد البابا آية “لا إكراه في الدين” ليبقي على ادعاء الإمبراطور البيزنطي أن رسول الإسلام : “أمر باستعمال السيف لنشر العقيدة التي جاء بها”، حتى يجعل من هذا الإدعاء منبرا يقدم منه الدروس للمسلمين مركزا على عبارة الإمبراطور التي قال فيها: “العنف يتنافى مع طبيعة الله ومع طبيعة الروح … وأن عدم اعتماد الإنسان على العقل في أفعاله شيء يتنافى مع طبيعة الله”، وهي العبارة التي قال عنها البابا إنها القول الفصل في موضوع استعمال العنف في نشر الدعوة الدينية.
يمكن تلخيص ما تقدم في نقطتين:
الأولى هي أن آية “لا إكراه في الدين” نزلت قبل أن يملك الرسول وسائل القوة التي تمكنه من حمل الناس على الإسلام بالإكراه. وأنه لما امتلكها أمر بالجهاد، وهو حسب فهم البابا قرين استعمال السيف في نشر الدعوة.
– أما النقطة الثانية فهي أن البابا ينصح المسلمين بأن يتخلوا عن العنف وهو عنده قرين الجهاد، وأن يحتكموا إلى العقل، لأن “العنف مخالف لطبيعة الله” كما قال. سنرجئ الكلام في هذه المسألة إلى المقال القادم، لنركز هنا على آية “لا إكراه في الدين”.
الآية كما هو معلوم من سورة البقرة (رقمها 256). وحسب جميع المفسرين فإن سورة البقرة نزلت بالمدينة والرسول على رأس الدولة التي أسسها هناك بعد هجرته إليها، فالآية مدنية وليست مكية كما يفهم من كلام من سماهم البابا بـ”ذوي الاختصاص”. وإذا كان ليس من السهل تعيين تاريخ نزولها بالضبط -فسورة البقرة نزلت بالمدينة في مدد مختلفة على مدى نحو ست سنوات- فإنه يستفاد من بعض الروايات التي تحدثت عن أسباب نزول هذه الآية أن لها علاقة بجلاء بني النضير الذي حدث في السنة الرابعة للهجرة والرسول يومئذ على رأس دولة تزداد قوة واتساعا. ومن المفسرين من يقول إن هذه الآية نزلت بعد فتح مكة.
أما مناسبة نزول هذه الآية فقد وردت فيها روايات متعددة تدور كلها حول محور واحد وهو أن شخصا (رجل وقيل امرأة) أراد أن يجبر أولاده على الإسلام فاستشار الرسول عليه السلام فنزلت الآية وهي تمنع استعمال العنف لإجبارهم على الإسلام (انظر عددا من الروايات في تفسير الطبري).
وقد ذكر القرطبي في تفسيره رواية تفيد أن عمر بن الخطاب قال لعجوز نصرانية: “أسلمِي أيتها العجوز تسلمي، إن الله بعث محمداً بالحق. قالت: أنا عجوز كبيرة والموت إليّ قريب، فقال عمر: اللهم ٱشهد، وتلا «لاَ إكْرَاهَ في الدِّينِ. وذكر الزمخشري في تفسير هذه الآية، وهو من المعتزلة المعروفين باعتماد العقل، أن معنى قوله تعالى “لا إكراه في الدين” : أي لم يُجر الله أمرَ الإيمان على الإجبار والقسر، ولكن على التمكين والاختيار، واستشهد بقوله تعالى في آية أخرى: “وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ من في ٱلاْرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ”، أي لو شاء لقسرهم على الإيمان ولكنه لم يفعل، وبنى الأمر على الاختيار.
وأوضح من ذلك ما ذكره الرازي فيلسوف الأشاعرة في تفسيره الكبير نقلا عن “أبي مسلم والقفال، وهو أليق بأصول المعتزلة –كما قال- أن معنى الآية: “أنه تعالى ما بنى أمر الإيمان على الإجبار والقسر، وإنما بناه على التمكن والاختيار، ثم احتج القفال على أن هذا هو المراد بأنه تعالى لما بيّن دلائل التوحيد بياناً شافياً قاطعاً للعذر، قال بعد ذلك: إنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفر إلا أن يُقسر على الإيمان ويجبر عليه، وذلك مما لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار الابتلاء، إذ في القهر والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان”. وأضاف: ونظير هذا قوله تعالى: “فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ (الكهف: 29) وقال في سورة أخرى “وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِى ٱلاْرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ” (الشعراء: 3، 4) وقال في سورة الشعراء “لَعَلَّكَ بَـٰخِعٌ نَّفْسَكَ (معذبها) أَلاَّ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ، إِن نَّشَأْ نُنَزّلْ عَلَيْهِمْ مّنَ ٱلسَّمَاء ءايَةً (دلالة معجزة) فَظَلَّتْ أَعْنَـٰقُهُمْ لَهَا، خَـٰضِعِينَ”. ثم أضاف: “ومما يؤكد هذا القول أنه تعالى قال بعد هذه الآية (يعنى لا إكراه في الدين) “قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيّ”: يعني ظهرت الدلائل، ووضحت البينات، ولم يبق بعدها إلا طريق القسر والإلجاء والإكراه، وذلك غير جائز لأنه ينافي التكليف” (باعتبار أن تكليف الله الناس بالعبادات مثلا يقتضي حرية المكلف).
هذا باختصار رأي المفسرين في قوله تعالى: “لا إكراه في الدين”. وهناك من قال إنها آية نسخت بآية السيف. ومسألة الناسخ والمنسوخ من المسائل المختلف فيه، وقد خلط معظم القائلين بالنسخ بين معنى النسخ وما هو من قبيل الخصوص والعموم والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه الخ، فإذا استعملنا هذه المفاهيم المنطقية ضاق مجال النسخ إلى الصفر أو ما يقرب منه. وهذا موضوع سنتناوله بتفصيل في مكان آخر.
هذا باختصار عن قوله تعالى : “لا إكراه في الدين”.
ومما تقدم يتبين أن دعوى “ذوي الاختصاص” الذين استند البابا عليهم في القول بأن هذه الآية نزلت في وقت كان النبي محمد عليه السلام في وضعية الضعيف المهدد، دعوى باطلة. إن ذوي الاختصاص في الإسلام يرَوْن أن القرآن يشرح بعضه بعضا، ما نزل منه في مكة وما نزل بالمدينة، وأن المبادئ العامة تعطيها الآيات المحكمات وهي التي لا تناقض فيها ولا لبس. أما المتشابهات فهي تتباين ألفاظها أو أحكامها حسب الظروف. والتمييز بين المحكم والمتشابه متروك للعقل. قال تعالى: “هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ” (آل عمران7). ومن يدري فقد يكون “ذوو الاختصاص”، الذين اعتمد البابا على فهمهم، من “الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ”. أما آية “ٍلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” فهي في نظر المسلمين آية محكمة لا اشتباه فيها ولا التباس، ولا تحتمل تأويلا آخر. دليل ذلك قوله تعالى بعدها مباشرة: “قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ”، بمعنى أن الأمر واضح لا أثر للبس فيه.
يبق بعد ذلك معنى الجهاد وآيات القتال.
الدعوة بالموعظة … وآيات الإذن بالقتال
“لا إكراه في الدين” : مبدأ إسلامي أكيد. وقد بينا في المقال السابق كيف فهم المسلمون بمختلف فرقهم هذا المبدأ، فهما عقلانيا أصيلا أساسه أن الإيمان لا يكون بالقسر والإجبار، وأن مِن شروط التكليف الشرعي أن يكون المكلف حرا مختارا.
هذا من ناحية المبدأ، أما من ناحية التطبيق، فالثابت بنصوص القرآن ومن خلال السيرة النبوية أن الإسلام قد استبعد استبعادا كليا استعمال السيف في الدعوة. لقد مكث الرسول عليه السلام أزيد من عشر سنوات في مكة تعرض فيها، هو والذين آمنوا به، لصنوف من الأذى والإهانة والتضييق والتعذيب والحصار مما اضطره إلى أن يطلب من أصحابه الهجرة إلى الحبشة حفاظا على أرواحهم. وكانوا قد طلبوا منه مرارا السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم بأيديهم فمنعهم عن ذلك، وحرم عليهم استعمال العنف ضد جلاديهم.
وكان موقف الرسول عليه السلام في هذا المجال وفاقا مع قوله تعالى: “ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ” (النحل 125). وسورة النحل هذه سورة مكية. ومعلوم أن القرآن المكي كله محكم، بمعنى أنه لا يطاله النسخ. والذين يقولون بأن “آية القتال” نسخت ما قبلها، هكذا بالتعميم، يجانبون الصواب لأن آية النسخ نفسها إنما نزلت في المدينة، ولأن النسخ –إذا جاز القول به- يخص مجال الأحكام وليس مجال العقيدة والأخلاق؛ والقرآن المكي كله عقيدة وأخلاق والآية السابقة تقرر سلوكا أخلاقيا وليس حكما تشريعيا.
وعندما كان النبي عليه السلام في طريقه إلى المدينة مهاجرا، أو كان يتهيأ لذلك، نزل قوله تعالى: “وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ” (العنكبوت 46). وسورة العنكبوت هي آخر سورة –أو ما قبل آخر سورة- نزلت في مكة. فهي إذن ترشد الرسول وصحبه إلى السلوك الذي يجب أن يسلكوه في المدينة مع من قد يختار أن يقف موقف الخصم لهم وهم اليهود تحديدا. أما غيرهم من سكان المدينة فقد بلغتهم الدعوة قبل الهجرة وأسلموا، وكانت تربطهم بالنبي عليه السلام بيعة العقبة.
وعلى هذا النهج نفسه حدد القرآن في المدينة، وهي تعيش مرحلة الدولة، السلوك الذي يجب أن يتبعه الرسول والمسلمون في الدعوة إلى الإسلام قال تعالى: “وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ” (فصلت 33- 34). وقد طبق الرسول عليه السلام هذا النهج فكتب رسائل إلى ملوك ورؤساء الدول المجاورة يدعوهم إلى الإسلام : إلى إمبراطور الروم وكسرى فارس وملك الحبشة، وأسقف الإسكندرية ورؤساء الإمارات العربية في شرق الجزيرة كما بعث دعاة إلى جنوبها وغربها. والذين استجابوا فعلوا ذلك برضاهم وكان ذلك مرفوقا أحيانا بمعاهدات…
منهج الدعوة في الإسلام مبني، إذن، على الموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فلا عنف لا على صعيد الكلام ولا على صعيد العمل. أما الجهاد الذي هو فرض كفاية -بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقي- فهو لا يتصور، بهذا المعنى، إلا كعمل جماعي يفرضه رد الفعل المناسب على كل ما يهدد الجماعة في وحدتها أو دينها أو مصالحها باختلاف أنواعها. وهذا لا يتصور إلا مع وجود دولة.
في حال وجود الدولة، إذن، يفرض الواجب الديني والواجب الوطني على القائمين بها الدفاع عن أرضها ومواطنيها ومصالحها، عندما تتعرض لعدوان من دولة أجنبية أو لفتنة داخلية. ذلك ما حصل عندما هاجر الرسول عليه السلام إلى المدينة فقد اشتد ضغط قريش على المسلمين في مكة فالتحق بالمدينة من استطاع منهم، بينما بقي كثير من أزواجهم وأبنائهم وأهليهم يعانون من انتقام قريش، فنزل حينئذ الإذن لهم برد الفعل فقال تعالى: “أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ (لولا أنه جعلهم يردون الفعل على المعتدين) لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ” (الحج 39- 40، جزء منها مكي والجزء الآخر مدني، وآيات الإذن بالقتال مدنية). ويقول كثير من المفسرين إن هذه الآيات كانت أول ما نزل في القتال. وواضح أن الإذن بالقتال هنا خاص بـ”الذين يقاتَلون” (بالفتح) مما يصرف معناه كلية إلى الدفاع عن النفس والأهل والمال والوطن… باعتبار مكة هي الوطن الأصلي للمهاجرين.
بعد الإذن بالقتال من الناحية المبدئية، جاءت الآية التالية تفصل شروط ذلك وكيفيته ومسوغاته، قال تعالى : “وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ” (البقرة 190-193). وواضح من ذكر “المسجد الحرام” في هذه الآيات أن الأمر يتعلق بفتح مكة.
ويقول كثير من المفسرين إن الرسول عليه السلام كان “يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه”، وذلك إلى أن نقضت قريش معاهدات كان قد أبرمها معها، وحينذاك نزلت سورة براءة، تسمح له بقتالهم بعد إخبارهم والبراءة منهم وإتمام العهد مع من لم ينقضوا المعاهدات منهم ولم يقوموا بعدوان، وقبول توبة من تاب منهم وأدى فروض الإسلام (براءة-التوبة 1- 6). وواضح أن الأمر يتعلق هنا برد الفعل على نقض قريش لاتفاقية عقدوها مع النبي وقتلهم متحالفين معه، الشيء الذي يعني إعلانها الحرب على المسلمين.
تلك إذن هي آيات القتال (أو السيف) في القرآن، وكما هو واضح فقد نزلت كلها كرد فعل على عدوان ارتكبته قريش ضد المسلمين، مما يدخل في إطار الدفاع عن النفس. ولم يكن السبب في نزولها مرتبطا بنشر الدعوة ابتداء.
أما حروب الردة التي جرت زمن أبي بكر وعمر فتدخل في إطار القضاء على التمرد. فالأعراب الذين ارتدوا لم يفعلوا ذلك انسلاخا من العقيدة وإنما ارتدوا ممتنعين عن دفع الزكاة لأبي بكر معتقدين أنها خاصة بالرسول، فالردة تعني هنا التمرد على قانون من قوانين الدولة وهو “الزكاة”، وحروب الردة بهذا الاعتبار هي حروب من أجل تطبيق القانون.
وأما ما حدث زمن الأمويين ومن جاء بعدهم من حروب أهلية وفتوحات خارجية فقد كانت في البداية رد فعل على تهديدات خارجية من الروم أو الفرس، أو من عملائهم من القبائل العربية، ولم تكن من متطلبات الدعوة. وإذا كانت الدولة الإسلامية قد عمدت إلى محاربة دول أخرى لأسباب سياسية أو غيرها فإن عملها الحربي لم يكن موجها ضد مواطني هذه الدول بل ضد جيوشها وحكامها. وقد حرم القرآن قتال من لا يقاتِل منهم، خاصة النساء والأطفال والشيوخ ورجال الدين المنقطعين إلى معابدهم وصوامعهم وغيرهم ممن لم ينخرطوا في قتال المسلمين. قال تعالى: “وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ” (البقرة 190).
هذا ولابد من الإشارة إلى قيام كثير من الفرق الإسلامية بالدعوة لمذهبها في أطراف البلاد الإسلامية مما أدى إلى إسلام جماعات كثيرة شرقا وغربا. وقد لعبت الطرق الصوفية والتجار في العصور المتأخرة دورا كبيرا في هذا المجال حيث أسلمت على أيديهم جماهير كثيرة في إفريقيا وآسيا، عن طريق الدعوة لا غير.
وقبل الختام لا بد من القول بأن البابا كان مجانبا للحقيقية –ربما عن علم- حين اتهم رسول الإسلام بأنه أمر باستعمال السيف في نشر دعوته. وهو مجانب للحقيقة حين سكت عن موقف المسيحية من استعمال السيف في الدعوة نافيا أن يكون ذلك من أعمالها. والحقيقة أن الكنيسة لم تستبعد استعمال العنف في الدعوة استبعادا مطلقا، بل إنها أجازت استعمال السيف في نشر دوعتها. فقد طرح القديس أغسطين (354-430م) مسألة استعمال السيف في الدعوة الدينية فأفتى في كتابه المشهور “مدينة الله” بأنه إذا رفض الوثنيون الاستجابة لفضائل وحقائق المسيحية عندما تعرض عليهم وجبت محاربتهم، معتمدا في هذه الفتوى على عبارة ذكرها الحواري لوقا في إنجيله ونصها: “أجبروهم على الدخول” (مثل الوليمة)، كما تعرض للمسألة نفسها، وبتفصيل القديس توما الإكويني (1225-1274)، فأجاز “الحرب العادلة” التي هي في معنى الجهاد في الإسلام.
مسألة الاستطاعة، و”تحديدات عقلنا ومقولاته”.
(*)محمد عابد الجابري
قال البابا في خطابه: “وقد لاحظ البروفسور تيودور خوري (ناشر حوار الإمبراطور البيزنطي مع العالم الفارسي) أنه بالنسبة لهذا الإمبراطور الذي تكون عقله في أحضان الفلسفة الإغريقية، فإن هذا الذي قاله هو شيء بديهي (يعني قوله: “الفعل الصادر وفق العقل لا يخالف طبيعة الله، أما التعاليم الإسلامية فهي تقرر أن الله متعال بشكل مطلق، وبالتالي فإرادته لا تخضع لتحديدات عقلنا نحن ومقولاته، بما في ذلك مقولة المعقولية”).
من المؤسف حقا أن يكون جميع ما حكاه البابا في هذه الفقرة هو من الأخطاء التي لا يمكن تفسيرها بشيء آخر غير النقص في المعرفة، وقد نعتذر له في ذلك باعتبار أنه نَقَل ما ذكره عمن يفترض فيهم الإطلاع على الموضوع. غير أن مما يضعف اعتذارنا أن البابا يعرف –وهو عالم لاهوت- أن المسألة المطروحة هنا هي، في جميع الديانات، من أهم القضايا اللاهوتية (أو الكلامية بالاصطلاح الإسلامي) كما أنها من أصعب القضايا الفلسفية، وبالتالي لا يجوز الخوض فيها بدون تدقيق وتمحيص.
لقد عرفت هذه القضية في المؤلفات الإسلامية -في “علم التوحيد”، أو “علم الكلام”، وكذا في “علم التفسير” و”علم الأصول”- باسم “مسألة الاستطاعة”؛ ويعبر عنها بلغة الجمهور بالتساؤل التالي: “هل الإنسان مسير أم مخير؟”. وعنصر الإشكال في هذه المسألة يتمثل في القضية التالية وهي أننا كلما وسعنا من دائرة الحرية والإرادة والاستطاعة في المجال البشري بدا ذلك وكأنه قد تم على حساب الحرية والإرادة والاستطاعة (أو القدرة) في المجال الإلهي، والعكس بالعكس: فالقول بأن الله مطلق الحرية والإرادة الخ يؤدي عند بعضهم إلى أن الإنسان مجبر مسير، وهنا تطرح مسألة المسؤولية والثواب والعقاب. أما القول بأن الإنسان حر ومريد لما يأتيه من الأفعال فيلزم عنه أنه “خالق” لأفعاله وأنه لذلك مسئول عنها.
والنزاع حول هذه المسألة في الفكر الإسلامي هو أساسا بين المعتزلة والأشاعرة. غير أن المسألة ليست مجرد مسألة نظرية كلامية، فهي لم تصبح كذلك إلا في مرحلة متأخرة. أما في الأصل فهي تعبير بالمصطلح الديني عن قضية سياسية. ولذلك فضلنا ونفضل طرحها انطلاقا من تاريخها السياسي، إذ بدون استحضار خلفياتها السياسية سيبقى الحديث عنها لا معنى له. وفيما يلي مقتطفات مما سبق أن كتبناه في هذه المسألة.
عندما تمكن معاوية بن أبي سفيان من انتزاع الخلافة بالقوة من علي بن أبي طالب، لم يجد ما يبرر به مشروعية عمله ذاك غير القول : إن ذلك كان في سابق علم الله، أي كان قضاء وقدرا من الله. وهكذا أسس معاوية لفكر الجبر في الإسلام. وكان من الطبيعي أن يتمسك بهذه الفكرة خلفاؤه من بعده ومعهم المؤيدون لهم والخائفون من بطشهم، والطامعون في أعطياتهم من جهة، وأن يعترض عليها منافسوهم ومعارضوهم من جهة ثانية. وكان من أوائل الذي اعترضوا على هذا “الجبر الأموي” شخص من حاشيتهم اسمه غيلان الدمشقي وكان يحظى بعطف وتقدير الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. فكتب إليه غيلان رسالة يعظه فيها كان مما ورد فيها، في الاعتراض على دعوى معاوية بأن الله هو الذي أراد له ما قام به من ظلم وعسف وغصب للسلطة، قوله: “فهل وجدت يا عمر حكيما يعيب ما يصنع، أو يصنع ما يعيب، أو يعذب على ما قضى، أو يقضي ما يعذب عليه؟ أم هل وجدت رشيدا يدعو إلى الهدى ثم يضل عنه، أم هل وجدت رحيما يكلف العباد فوق الطاقة ويعذب على الطاعة؟ أم هل وجدت عدلا يحمل الناس على الظلم والتظالم. وهل وجدت صادقا يحمل الناس على الكذب أو التكاذب بينهم؟” (ابن المرتضى ص16).
وانتشر هذا النوع من “الكلام” في الرد على الجبر الأموي، وحدَّثَ به عالم كبير محترم من الجميع هو الحسن البصري فكتب إليه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان يطلب منه مستنده الشرعي في القول بـ “القدر” أي بقدرة الإنسان على إتيان أفعاله بحريته واختياره، فرد عليه الحسن برسالة مما جاء فيها قوله : “فافهم أيها الأمير ما أقوله: فإن ما نهى الله عنه فليس منه، لأنه لا يرضى ما يسخط من العباد، فإنه تعالى يقول : “ولا يرضى لعباده الكفر وأن تشكروا يرضاه لكم” (الزمر 7)؛ فلو كان الكفر من قضائه وقدره لرضي ممن عمله”! ثم يضيف قائلا : “والقوم ينازعون في المشيئة، وإنما شاء الله الخير فقال تعالى: “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر” (البقرة 185). (نفس المرجع. ص 82-89).
وسيقوم واصل بن عطاء بالتنظير لـ”الكلام” المعارض للجبر الأموي وسيختلف مع أستاذه الحسن البصري في مسائل جزئية فيعتزل عنه فسمي هو وأصحابه بالمعتزلة. وقد حفظ لنا الشهرستاني بعض ما كان واصل يقرره في مسألة الجبر والاختيار. من ذلك قوله: “كان واصل بن عطاء يقول: إن الباري تعالى حكيم عادل لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر، ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه. فالعبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وهو المجازَى على فعله، والرب تعالى أقدره على ذلك… ويستحيل أن يخاطب -الله- العبد بـ “افعل” وهو لا يمكنه أن يفعل ولا هو يحس من نفسه الاقتدار والفعل. ومن أنكره فقد أنكر الضرورة (=العقلية : المنطق). واستدل بآيات على هذه الكلمات” (الشهرستاني. الملل والنحل ج1 ص 47).
كان واصل بن عطاء من أبرز مؤسسي مدرسة المعتزلة التي عرفت باسم “القدرية” لقولها بقدرة الإنسان على إتيان أفعاله بحرية واختيار. وقد طور متأخروهم نظرية واصل فميزوا في الأفعال بين ما يجب أن ينسب إلى إرادة الإنسان واختياره وبين ما يجب أن ينسب إلى الله. والقاعدة في ذلك عندهم “أن ننظر في الفاعل ونختبر حاله، فإن وجدنا الفعل يقع بحسب قصده ودواعيه وينتفي بحسب كراهته وصارفه حكمنا بأنه فعل مخصوص”، أي أنه مخلوق له، وأن الله قد خلق فيه القدرة على فعله. أما إن وجدنا أن الفعل “لا يجوز أن يكون مقدورا للإنسان بالقدرة فيجب أن يكون مقدورا للقادر بذاته وهو الله تعالى”. وهكذا فالسكون والحركات على اختلاف أجناسها والاعتمادات (الاهتزازات) على اختلافها والمتولدات كالتأليف والألم والصوت والكلام وكذلك النظر والندم والاعتقادات المبتدأة والظن، كل ذلك يقع بقصد الإنسان ودواعيه وهي مقدورة له بالقدرة التي يُحْدِثُها الله فيه، وبالتالي فهي أفعال له. أما الروائح والطعوم والألوان والحرارة والبرودة…. فهي غير مقدورة للإنسان بمعنى أن الله لم يمنحه القدرة على إحداثها وبالتالي فلا يستطيع فعلها وإنما هي من خلق الله مباشرة (القاضي عبد الجبار شرح الأصول الخمسة ص 325).
ويتصل بهذه المسألة قولهم بالعدل الإلهي بمعنى أن الله “منزه أن يضاف إليه شر وظلم، وفعل هو كفر ومعصية، لأنه لو خلق الظلم كان ظالماً، كما لو خلق العدل كان عادلاً”. ومن هنا قالوا: أن الله لا يفعل إلا الصلاح والخير و”يجب عليه”، من حيث الحكمة، رعاية مصالح العباد”. أي أن كونه موصوفا بالحكمة يقتضي ضرورة أن لا يفعل إلا الصلاح، وبعضهم قال: “الأصلح”. كما قالوا بوجوب تنفيذ وعده ووعيده: فـ “المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة: استحق الثواب، والعوض والتفضل معنى آخر وراء الثواب (أي زيادة عليه). وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها: استحق الخلود في النار لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار. وسموا هذا النمط: وعدا ووعيداً”. كما “اتفقوا على أن أصول المعرفة وشكر النعمة واجبة قبل ورود السمع (قبل سماع دعوة الأنبياء) والحسن والقبح يجب معرفتهما بالعقل، واعتناق الحسن واجتناب القبيح واجب كذلك”. أما وُرود التكاليف الشرعية فهي ألطاف للباري تعالى أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء عليهم السلام: امتحاناً واختباراً، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة”.
وبعد، أليس ما سبق، وهو مجرد نقطة من بحر، دليلا على خطأ –حتى لا نستعمل كلمة أخرى- ما حكاه البابا من القول عن العقيدة الإسلامية إنها تقرر أن إرادة الله “لا تخضع لتحديدات عقلنا نحن ومقولاته”؟
نعم هناك مخالفون لوجهة نظر المعتزلة، غير أن مخالفة هؤلاء هي أيضا مبنية، وبنفس القدر، على “تحديدات عقلنا ومقولاته”، كما سنرى في المقال القادم.
المضطر والمختار… والكسب!
عرضنا في المقال السابق لرأي المعتزلة في مسألة الجبر والاختيار، منطلقين من الأصل السياسي الذي يقف وراء نظريتهم في ما عرف في علم الكلام الإسلامي بمسألة “خلق الأفعال”. هناك إلى جانب آراء المعتزلة رأي الجهم بن صفوان الذي يتهمه خصومه بالقول بالجبر، في حين أنه لم يقل به كنظرية وعقيدة وإنما كوسيلة مؤقتة لإدخال سلوك المسلمين الجدد في خراسان في حكم الشرع. كان جهم من المعارضين للأمويين وقد انخرط في ثورة مسلحة ضدهم وكان أتباعه من هؤلاء المسلمين الجدد في خراسان الذين لا يعرفون العربية ولا يؤدون الفرائض والشعائر الدينية بسبب جهلهم لها. فطرح خصومه قضيتهم على أنهم ليسوا مؤمنين، فكان رد فعل جهم بن صفوان أن قال بنظرية وصفها خصومه من أنصار الأمويين بأنها تقول بالجبر. ولكي لا يسقط في هذا الذي اتهمه به خصومه ويكون مناصرا للـ”الجبر” الأموي ميز بين المجبور المضطر وبين المريد المختار. وقد نقل أبو الحسن الأشعري رأيه وعبَّر عنه كما يلي، قال: “الذي تفرد به جهم القول… أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأنه هو الفاعل، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز، كما يقال : الشجرة تحركت ودار الفلك وزالت الشمس، وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس اللهُ سبحانه، إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل وخلق له إرادة للفعل واختيارا له منفردا بذلك” (الأشعري. مقالات الإسلاميين ج1 ص 338)
ومعنى ذلك أن المسلمين الجدد الذين لا يؤدون الشعائر الدينية بسبب جهلهم هم من هذه الناحية في حالة اضطرار وبالتالي فلا تجوز مؤاخذتهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فبما أنهم بشر، خلق الله لهم القدرة على الفعل والإرادة والاختيار، فهم مطالبون بتحسين وضعيتهم والعمل للخروج من حالة الاضطرار التي هم عليها. وأما الأمويون، وهم الطرف الآخر الذي يدخل ضمن “المفكر فيه” لدى جهم، فهم غير مضطرين، يعرفون العربية (=القرآن) والحلال والحرام الخ، وبالتالي فهم يفعلون ما يفعلون بالقدرة التي جعلها الله تحت تصرف إرادتهم واختيارهم، وإذن فهم محاسبون. وإذا شئنا تلخيص وجهة نظر جهم بن صفوان من هذا المنظور قلنا : هناك الفعل الصادر عن ضرورة موضوعية كالجهل بالشيء وصاحبه في حكم “المجبور”، وهناك الفعل الصادر عن قدرة ومعرفة وصاحبه مختار ومسؤول.
أما القول بأن ما صدر عن الأمويين من عسف وظلم واغتصاب للسلطة ثم رمي الكعبة الخ، إنما كان بـ”سابق علم الله”، بمعنى أن الله كان يعلم ما سيفعلون قبل أن يخلقهم فهو قول يضعنا إزاء احتمالين: إما أن علم الله بقي كما كان قبل أن هاجموا الكعبة وبعده مثلا، وفي هذه الحالة إما أن نقول إن الله هو الذي أراد منهم ذلك قبل أن يفعلوه فيكون هو الذي حتمه عليهم، وهذا غير معقول ولا يجوز. وإما أن يكونوا قد فعلوا ما فعلوا من تلقاء أنفسهم وبمحض إرادتهم، وفي هذه الحالة نتساءل : هل عَلِمَ الله هذا الذي فعلوه أم لا؟ فإذا علِمه فسيكون علما مضافا إلى علمه السابق، وهذا لا يجوز لأن علمه كامل لا يحتمل الإضافة! وأما إذا قلنا إنه لم يعلمه فإننا سنكون قد أضفنا إليه الجهل. وإذن فالحل المعقول، الذي لا يجر إلى تناقضات ونقائض مثل تلك، هو أن نقول: إن الله خلق العالم بما فيه الإنسان حسب سنن وقوانين قدرها تقديرا، كحركة الفلك مثلا. أما الإنسان فقد خلق له، أو فيه، قدرة بها يفعل وإرادة واختيارا، وأكثر من ذلك بين له بواسطة الرسل وعن طريق العقل سبيل الخير وسبيل الشر. والإنسان هو الذي يختار هذه أو تلك فيفعل هذا أو ذاك. هنا، حين الفعل، يتدخل علم الله ليحكم بالحسن أو بالقبح، بالثواب أو بالعقاب.
هناك جانب آخر وهو أن في القرآن آيات تفيد “الجبر” وأخرى تفيد الاختيار. وحسب نظرية جهم يمكن القول : إن التي تفيد “الجبر” تعبر عن تجليات الضرورة التي خلقها الله في الكون، وإن التي تفيد الاختيار تعبر عن مظاهر حرية الإرادة والقدرة التي خلقهما الله في الإنسان.
هذا عن رأي جهم، وموقفه أقرب إلى موقف المعتزلة. أما الأشاعرة وهم الذين نظَّروا لموقف “أهل السنة والجماعة” الذين بايعوا معاوية ووقفوا إلى جانب الدولة الأموية ضدا على الخوارج والشيعة والفرق المغالية، فقد حاولوا بناء رأي وسط، فعارضوا بعض الاصطلاحات التي استعملها المعتزلة والتي تفيد ظاهريا معاني لا تتسق مع الخطاب الديني مثل استعمال كلمة “خلق” في قولهم “خلق الأفعال” و”خلق القرآن” وكلمة “يجب” في قولهم “يجب على الله فعل الأصلح” الخ. ولو تجنب المعتزلة استعمال هذه الكلمات وعبروا عن نفس المعنى الذي أرادوه منها بكلمات أخرى لا تشكل نشازا في الخطاب الديني لكان رد فعل أهل السنة والأشاعرة ضدهم أخف، خصوصا والجميع يعترف لهم بدفاعهم المستميت عن عقيدة التوحيد الإسلامية ضد الديانات الأخرى خاصة المانوية.
ينطلق أهل السنة ومن بعدهم الأشاعرة، في المسألة التي نحن بصددها هنا، من مبدأين: مبدأ “لا خالق ولا فاعل إلا الله”. ومبدأ “الثواب والعقاب”، وهما مبدآن نص عليهما القرآن الكريم في آيات كثيرة صريحة لا لبس فيها. ولكي يجمع الأشاعرة بين هذين المبدأين قالوا إن الأفعال التي يأتيها الإنسان يخلقها الله فيه، أما نتائجها فهو يكسبها، فيجازى عليها. وهكذا حافظوا على نسبة فعل “الخلق” إلى الله وحده، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعطوا لـ “الكسب” معنى واضحا محددا يبرر عقليا تحمل الإنسان مسؤولية أفعاله، تلك التي يأتيها بالقدرة التي خلقها الله فيه! ولذلك اضطروا مع الزمن إلى تطوير نظريتهم في “الكسب” حتى غدت مطابقة أو تكاد مع رأي المعتزلة. ويمكن أن نسجل ثلاث مراحل في تطور وجهة نظرهم في هذه المسألة :
أما أبو الحسن الأشعري، مؤسس المذهب، فهو يرى “أن الله تعالى أجرى سنته بأن يخلق عُقَيب القدرة الحادثة، (أي التي يحدثها الله في الإنسان) أو تحتها أو معها، الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرّد له، وسمى هذا كسبا، فيكون خلقا من الله تعالى إبداعا وإحداثا، وكسبا من العبد حصولا تحت قدرته”. يريد أن القدرة التي يخلقها الله في الإنسان، عندما يقصد هذا الأخير فعل شيء، ليست مؤثرة تأثير العلة في المعلول، لأنها لو أثرت في الأفعال وكانت علة لها، والأفعال أعراض، لأثرت كذلك في الأعراض الأخرى فخلقت الروائح والطعوم… الخ، بل ولَتعدَّى تأثيرها إلى الجواهر والأجسام كذلك” (الأشعري مقالات الإسلاميين. ح1. ص99).
أما القاضي الباقلاني مُنَظِّر المذهب فقد حاول إدخال بعض المرونة على موقف الأشعري وإعطاء معنى أوضح قليلا لمفهوم “الكسب” فقال إن القدرة التي يحدثها الله في الإنسان لا تؤثر في إيجاد الجواهر والطعوم والروائح الخ، ولكن لها مع ذلك تأثيرا في جهة من جهات الفعل هي المتعينة لأن تكون قابلة للثواب والعقاب. وبهذا تكون مؤثرة في حالة وغير مؤثرة في حالة أخرى.
ذلك ما لم يستسغه إمام الحرمين الجويني، من أكابر الأشاعرة، فهم يرى أن إثبات قدرة لا أثر لها بوجه، كما يقول الأشعري، هو كنفي القدرة أصلا، وأما إثبات التأثير لهذه القدرة في حالة دون أخرى كما يقول الباقلاني، فشيء لا يعقل، لأن القول بهذا كالقول بنفي التأثير. من أجل هذا قال: “لا بد من نسبة التأثير إلى فعل العبد وقدرته حقيقة” ولكن “لا على وجه الإحداث والخلق”، لأن الذي يخلق يشعر باستقلاله، كما أن الخلق يعني الإيجاد من العدم. والحال أن الإنسان، كما يشعر بقدرته على الفعل يشعر أيضا بعدم استقلاله في فعله، “فالفعل يستند وجوده إلى القدرة، والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخر تكون نسبة القدرة إلى ذلك السبب كنسبة العقل إلى القدرة، وكذلك يستند سبب إلى سبب حتى ينتهي إلى مسبب الأسباب، فهو الخالق للأسباب ومسبباتها”. ثم يضيف الشهرستاني الذي أورد ما ذكرنا قائلا : “وهذا الرأي أخذه (=الجويني) من الحكماء الإلهيين وأبرزه في معرض الكلام” (الشهرستاني الملل والنحل ج3 ص 97).
والسؤال الآن كيف حدث أن أضرب البابا صفحا عن مثل الآراء، -وهي معروضة في كتب المستشرقين، وقد عرضها ابن ميمون من قبل وبتفصيل في كتابه “دلالة الحائرين”- كيف جاز للبابا أن يعرض عن ذلك ليقتصر على تعليق متسرع وسطحي لناشر حوار الإمبراطور البيزنطي مع العالم الفارسي، البروفسور خوري، تعليق يقول: “أما التعاليم الإسلامية فهي تقرر أن الله متعال بشكل مطلق، وبالتالي فإرادته لا تخضع لتحديدات عقلنا نحن ومقولاته، بما في ذلك مقولة المعقولية”. ونحن نسأل صاحب هذا التعليق : أليست الآراء التي ذكرنا للمعتزلة والجهمية والأشاعرة محاولات جادة وعميقة لإضفاء المعقولية على مسألة من أصعب المسائل في الفكر الديني؟.
البابا وابن حزم : القدرة الإلهية والضرورة العقلية
في المحاضرة المثيرة التي ألقاها الباب بينديكت السادس عشر، وتعرض خلالها لمكانة العقل في الإسلام، جاء قوله: “وفي هذا الإطار يستشهد خوري بالمستشرق ر. أرلنديز R. Arnaldez الذي ذكر أن ابن “حزن” (ابن حزم) قد بالغ في هذا الأمر إلى درجة أنه يصرح أن الله ليس ملزما بتنفيذ ما يعد به (العبارة الإسلامية : لا يجب عليه تنفيذ وعده ووعيده كما سنبين)، وأنه لا شيء يلزمه على التصريح لنا بحقيقة ما يريد (بالعبارة الإسلامية : “يقدر على الكذب”). فإذا أراد لنا الله أن نعظم الأصنام، فليس لنا إلا أن نخضع لإرادته (وهذا الذي ينسبه هنا لابن حزم خطأ، كما سيتضح لاحقا).
في القرآن آيات يفيد ظاهرها معنى وأخرى يفيد ظاهرها معنى مختلفا وأحيان مناقضا. وقد ارتأى كثير من المتكلمين أن تجاوز هذا المشكل يكون برد المتشابه من الآيات إلى المحكم. لكن قد يحدث أن تتدخل ميول الفرقاء، فما يعتبره فريق محكما يعتبره فريق آخر متشابها.
من ذلك مثلا أن المعتزلة يعتبرون قوله تعالى “ليس كمثله شيء” (الشورى 11) محكما وما يتناقض معه عدوه من المتشابه. ولذلك قالوا بالتنزيه المطلق للذات الإلهية فنفوا عنه تعالى جميع الصفات التي فيها تشبيه بالإنسان سواء المعنوية منها كالعلم والإرادة أو الحسية منها كالسمع والبصر الخ، وقالوا مثلا هو عالم بذاته لا بصفة زائدة عليها أو هو عالم بعلم وعلمه ذاته. وفي إطار هذا التنزيه المطلق قالوا إنه تعالى الله منزه عن جميع أشكال النقص. وبما أن فعل القبيح (كالظلم والكذب الخ) نقص فالله منزه عنه وبالتالي لا يفعل إلا الحسن والصلاح وجوبا، مستندين في ذلك إلى آيات من القرآن كثيرة مثل قوله تعالى: “مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (فصلت 46)، وقوله: “وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا” (الكهف 49)، وقوله: “اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ” (البقرة 51. تكررت هذه الآية عدة مرات)، وقوله: “كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (الأنعام 12) الخ ومن هنا عبارتهم “يجب على الله فعل الصلاح”، وبعضهم قال: “الأصلح”.
وقد رد عليهم خصومهم من أهل السنة والأشاعرة والظاهرية بالاحتجاج بآيات كثيرة يصف تعالى فيها نفسه: بـ: “عليم”، “حكيم” “سميع”، بصير” متكلم” الخ، وأنه: “عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”، وأنه “لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ” (الأنبياء 23).
والذين يعترضون على القول بأن الله قادر على “كل شيء”، يقولون إن ذلك يستتبع أن يكون قادرا على الظلم والكذب. ويضيفون: إنه ما دام قادرا على الظلم والكذب فلما الذي يضمن لنا أنه لم يفعلهما الآن، أو أنه لن يفعلهما في المستقبل؟
هذا اعتراض ذكره ابن حزم على لسان الخصم، ليرد عليه ويفنده، وليس هو رأيه كما في خطاب البابا. وفيما يلي نص كلامه، قال: “قال ابن حزم: “فإن قال قائل: فما يُؤَمِّـنُـكم، إذْ هو تعالى قادر على الظلم والكذب والمحال، من أن يكون قد فعله أو لعله سيفعله فتبطل الحقائق كلها ولا تصح، ويكون كل ما أخبرَنا به كذباً”؟
يرد ابن حزم قائلا: “وجوابنا في هذا هو أن الذي أَمَّنََنا من ذلك ضرورةُ المعرفة التي قد وضعها الله تعالى في نفوسنا، كمعرفتنا أن ثلاثة أكثر من اثنين، وأن المُميِّز مُميِّز، والأحمق أحمق، وأن النخل لا يحمل زيتوناً، وأن الحمير لا تحمل جمالاً، وأن البغال لا تتكلم في النحو والشعر والفلسفة، وسائر ما استقر في النفوس علمه ضرورة”.
ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن قول ابن حزم بالضرورة العقلية التي ركبها الله فينا كضامن لليقين، هو عين العقلانية. فالعقل هو الذي يبرهن على وجود الله من خلال تأمل الموجودات وبديع نظامها إذ يستنتج من ذلك أنه لا بد أن يكون وراءه صانع حكيم، والعقل هو ضامن اليقين لأن اطراد نظام الكون واستقلاله عنا دليل على أن الله لا يخدعنا … فما يعبر عنه البابا بـ “العقل لا يتنافي مع طبيعة الله” يعبر الفكر الإسلامي عنه بالقول: إن سنن الكون لا تتنافى مع قواعد التمييز التي ركبها الله في عقولنا، (وبعبارة ابن رشد: “ليس العقل شيئا آخر غير إدراك الأسباب”)، وللقارئ أن يحكم بنفسه: أي القولين أكثر عقلانية؟
وأما ما نسبه البابا إلى ابن حزم على لسان المستشرق أرلنديز، ورواية عن خوري، فهو خطأ في الفهم أو النقل أو فيهما معا. ذلك أن ابن حزم لم يقل ولا يمكن أن يقول: “إذا أراد لنا الله أن نعبد الأصنام، فليس لنا إلا أن نخضع لإرادته”. ذلك أن الله يقول: “وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ” (آل عمران 80).
ليس من الممكن أن يقول ابن حزم : “إذا أراد لنا الله أن نعبد الأصنام، فليس لنا إلا أن نخضع لإرادته”. أما ما ذكره ابن حزم فهو حكاية عن قوم قالوا للمعتزلة: إذا كان الله لا يفعل إلا الصلاح، كما تقولون وبالتالي لا يشاء الكفر لعباده، فكيف تردون على من قال إن الله صرح بأنه قد يشاء أن يعود الناس إلى الكفر، وذلك بدليل قوله تعالى: “قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (حتى ولو كنا كارهين لذلك؟)، قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا، وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا … ” (الأعراف 88-89). فقوله “إلا أن يشاء الله” يفهم منه المعترض أن الله يمكن أن يشاء رجوعهم إلى الكفر؟
ولما ذكر ابن حزم ذلك جاء بجواب كان قد رد به بعض المعتزلة على ذلك الاعتراض فقالوا لا يمكن أن يرد الله المسلمين إلى عبادة الأصنام: “إلا أن يأمرنا الله بتعظيم الأصنام كما أمرنا بتعظيم الحجر الأسود والكعبة”. وفي هذه الحالة لا يكون الله قد شاء لهم الرجوع إلى عبادة الأصنام والكفر، بل يكون قد شاء المساواة في التعظيم بين الحجر الأسود، وبين الأصنام. والتعظيم لا يعني العبادة، والمسلمون يعظمون الحجر الأسود لا بمعنى أنهم يعبدونه، بل يعظمونه لما فيه من معنى الرمز، إذ يعود بهم إلى نبي الله إبراهيم الذي وضعه في موضعه كنقطة البدء في الطواف.
ويعلق ابن حزم على ذلك بالقول إذا أمرنا الله بتعظيم الأصنام كما نعظم الحجر الأسود والكعبة، فليس معناه أنه أمرنا بالكفر وبالرجوع إلى عبادة العرب للأصنام، بل معناه أنه أمرنا بما به يزيد إيماننا، فلو أمر المسلمين بتعظيم الأصنام فإن ذلك لن يتناقض مع أمره لنا بتعظيم الحجر الأسود والكعبة بل سيكون قد زاد في إيماننا بامتثالنا لأمره. ذلك، يقول ابن حزم : “أن الله لو أمرنا بذلك لم يكن عوداً في ملة الكفر بل كان يكون ثباتاً على الإيمان وتزايداً فيها”. فيكون الحال كما “قال تعالى: ” في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً”، والمرض المقصود هنا هو الكفر، والمعنى أن الله شاء لهم الزيادة في الكفر كما شاء لهم الكفر. إن مشيئة الله عند ابن حزم سارية، سواء تعلق الأمر بإيمان من آمن أو كفر من كفر أو ارتداد من ارتد” (الفصل 2 ص 186 وما بعدها مكتبة خياط بيروت د. ت).
وإذن، فالفرق كبير جدا، إلى درجة التعارض والتنافي، بين ما نسبه البابا إلى ابن حزم، وما قاله ابن حزم في حقيقة الأمر. ونحن نأخذ على البابا مثل هذه الأخطاء ليس لأنه تعمد الوقوع فيها للنيل من عقيدة الإسلام، فنحن لا نحاكم النوايا كما أسلفنا، وإنما نعجب لكونه يقتبس من مصادر غير موثقة ولا مختصة أشياء تسيء إلى علاقته وعلاقة الفاتيكان بالإسلام. في الوقت الذي ختم فيه محاضرته بالدعوة إلى حوار “عقلاني” بين الأديان”.
أعتقد مخلصا أنه قبل أن يكون هناك حوار بين الأديان يجب أن يتعرف أصحاب كل دين على حقيقة دين محاوريهم. هذا علاوة على أن يعرف أصحاب كل دين دينهم، معرفة ترتفع إلى المستوى المطلوب. ذلك أن الحوار مع الجهل ينتهي حتما إلى عداوة: وقديما قيل “الإنسان عدو ما يجهل”.
مسألة اللوغوس: ثالث ثلاثة…
بعد أن نسب البابا إلى ابن حزم ذلك الخطأ الذي كان موضوع الحلقة السابقة، يعلق من عنده بما يلي، قال: “وبقدر ما يتعلق الأمر بفهم ألوهية الإله وبالتالي الممارسة المشخصة للدين، فإننا نجد أنفسنا هنا أمام مفارقة مثيرة للحيرة، تطرح نفسها علينا اليوم. يتعلق الأمر بالمشكلة التالية: هل الاعتقاد في أن مما يتناقض مع طبيعة الله إتيان الإنسان لأفعاله على خلاف ما يقتضيه العقل هو اعتقاد صادق في نفسه دوما، أم أنه مجرد فكرة قررها العقل الإغريقي لا غير”؟ يجيب البابا : “أعتقد أننا نستطيع هنا أن نتبين الانسجام التام بين ما هو إغريقي، بالمعنى الأفضل للكلمة، وبين العقيدة الإنجيلية”.
ومن هذه النقطة يعمل على تأسيس الأطروحة المركزية التي يدافع عنها في خطابه، الأطروحة التي يردّ فيها على الداعين، من علماء اللاهوت المسيحي قديما وحديثا، إلى نزع الصبغة الإغريقية عن المسيحية. والمقصود بالصبغة الإغريقية هنا هو الاعتقاد في التثليث. وإذا كان البابا لا يصرح بـ “التثليث” فإن دفاعه عن “الصبغة الإغريقية” في المسيحية ضدا على المنادين بتحريرها منها والعودة إلى المسيحية الأولى (أو الأصلية) لا يعني شيئا آخر غير الدفاع عن “التثليث”. والذين من القراء تتبعوا ما كتبناه في هذه الجريدة عن آريوس والأريوسية، يلمحون منذ الآن ما ذا يعنيه خطاب البابا.
إن خطاب البابا دفاع عن المسيحية كما صاغتها الكنيسة الرسمية من خلال المجامع المسكونية التي عقدتها في القرنين الرابع والخامس للميلاد، وبكيفية خاصة مجمع نيقية Nicée الذي انعقد عام 325 ميلادية وحكم بالهرطقة والابتداع على مذهب أريوس التوحيدي الذي يقول بأن الله واحد وأن المسيح عليه السلام بشر وأمه مريم (على نحو قريب جدا مما ورد في القرآن الكريم). ولكي يغلق هذا المجمع المسكوني الباب أمام أي اجتهاد في موضوع العقيدة وضع ما سمى بـ “قانون الإيمان” المسيحي، ونصه: 1) “نؤمن بإلهٍ واحد آبٍ قادر على كل شيء صانع كل الأشياء المرئيّة واللامرئيّة، 2) و-نؤمن- بربٍ واحدٍ يسوع المسيح ابن الله، مولود الآب الوحيد أي من جوهر الآب، إله من إله، نور من نور، إله حق من إلهٍ حق، مولود غير مخلوق، مساوٍ للآب في الجوهر، الذي بواسطتهِ كل الأشياء وُجِدَت، تلك التي في السماء وتلك التي في الأرض، الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزلَ وتجسَّد، تأنَّس، تألَّم وقام في اليوم الثالث، صعدَ إلى السماوات، آتٍ ليدين الأحياء والأموات، 3) و-نومن- بالروح القدس. الرب المحيي، المُنبثِق من الآب، الذي هو مع الآب والابن مسجودٌ لهُ ومُمجَّد، الناطق بالأنبياء…”.
سنعود إلى هذه المسألة وغيرها بتفصيل من خلال تتبع فقرات خطاب البابا. أما الآن فإن التعليق الذي يفرض نفسه على الفقرة التي أوردناها أعلاه من هذا الخطاب فيخص العبارة الأخيرة منها التي يقرر البابا فيها “الانسجام التام بين ما هو إغريقي، وبين العقيدة الإنجيلية”، وبعبارة أخرى : التوافق بين الدين المسيحي والفلسفة اليونانية. وبقطع النظر عن ماهية هذا التوافق ومداه –الشيء الذي سنعرض له لاحقا- يجب أن نسجل أن البابا قام هنا بقفزة على التاريخ غير مبررة بالمرة، وهو يعرف أنه يفعل ذلك.
ذلك أن أول محاولة في مجال التوفيق بين الدين والفلسفة إنما قام بها الفيلسوف اليهودي فيلون الإسكندري المولود سنة 30 قبل الميلاد والمتوفى سنة 50 بعده. كان ككثير من معاصريه اليهود يقرأ ويكتب باليونانية بما في ذلك التوراة التي ترجمت إلى اليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد. وقد بلغ التداخل بين الفكر اليوناني وبين الفكر اليهودي إلى درجة صار معها من الشائع القول بأن اليونان أخذوا من التوراة. وقد سهل هذا التداخل قيام المتفلسفة اليهود بـ “شرح الدين اليهودي بالفلسفة اليونانية”، مستعملين في ذلك الطريقة الرمزية التي استعملها الفيثاغوريون والأفلاطونيون والرواقيون في شرح الأساطير اليونانية (الميثولوجيا)، فاعتبروا مثلا ما يطبع سيرة اليهود كما تحكيها التوراة، من طاعته لله والتمرد عليه، رمزا لاقتراب النفس من الله حين ابتعادها عن شهواتها وابتعادها منه حين تصرفها وفق شهواتها. وأقاموا تماثلا بين عقل الإنسان (آدم) والعقل الذي خلقه الله في عالم المثل (اللوغوس) من جهة، وبين قوة الحس المساعدة للعقل، وبين حواء المعينة لآدم من جهة أخرى، ثم بين جنوح القوة الحسية نحو اللذات من جهة وبين الحية التي جرت حواء ومعها آدم إلى الأكل من الشجرة من جهة أخرى الخ.
ومن أجل أن يكون في الإمكان اقتراب الإنسان، الذي هو مزيج من العقل والمادة والخير والشر، من الله الذي هو متعال ومنزه من الشر، يرى فيلون أنه لا بد من وسطاء: أولهم “اللوغوس” أي “الكلمة ابن الله”، وثانيهم “الحكمة”، ورابعهم آدم الأول، وخامسهم الملائكة، يلي ذلك “القوات” وهي ملائكية وجنية وهوائية الخ.
والشاهد عندنا هنا هو أن فكرة اللوغوس كأول ما خلق الله وكـ “ابن الله” وكوسيط بين الله والعالم فكرة قال بها يهود الإسكندرية قبل ظهور المسيح ومن المرجح أن يكون “بولس الرسول”، مُرَسِّم التثليث في المسيحية، قد أخذها منهم. وسكوت البابا عن ريادة يهود الإسكندرية في مجال الجمع والتوفيق بين الفلسفة الإغريقية والتوراة لا يمكن أن يكون بريئا خصوصا وهو يمنح هذه الريادة للحواري يوحنا الإنجيلي (المتوفى سنة 101 بعد الميلاد) الذي قال عنه في خطابه، مباشرة بعد الفقرة السابقة أعلاه: “لقد اقتبس يوحناJean الآية الأولى من سفر التكوين -وهي أول آية في التوراة كلها- فاستهل بها مقدمة إنجيله فقال: “في البدء كانت الكلمة (“اللوغوس logos). إنه بالضبط اللفظ الذي استعمله الإمبراطور : الله يفعل باللوغوس. واللوغوس يعني: العقل، كما يعني في ذات الوقت الكلمة، أي أنه خالق وقادر على التعبير والتواصل، وبالتحديد هو يفعل ذاك بوصفه عقلا”. ويضيف البابا: “هكذا قدم يوحنا القول الفصل المعبر عن المفهوم الإنجيلي لـ”الله”، القول الذي تجد فيه جميع معارج العقيدة الإنجيلية، المتشعبة الشاقة في معظم الحالات، التركيب الذي يجمعها. في البدء كان الوغوس، واللوغوس هو الله. ذلك: ما قاله (يوحنا) الإنجيلي”.
والملاحظ أن البابا يقوم هنا باختزال شديد، ذلك أن يوحنا الإنجيلي لم يقم فقط باستبدال لفظ بلفظ، بل أحل مسارا مكان مسار. ففي سفر التكوين (أول كتب التوراة) نقرأ ما يلي: “”فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، 2وَإِذْ كَانَتِ الأَرْضُ مُشَوَّشَةً وَمُقْفِرَةً وَتَكْتَنِفُ الظُّلْمَةُ وَجْهَ الْمِيَاهِ، وَإِذْ كَانَ رُوحُ اللهِ يُرَفْرِفُ عَلَى سَطْحِ الْمِيَاهِ، 3أَمَرَ اللهُ : «لِيَكُنْ نُورٌ». فَصَارَ نُورٌ”. أما في إنجيل يوحنا فنقرأ في مستهله: “فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ. وَكَانَ الْكَلِمَةُ هُوَ اللهُ . 2هُوَ كَانَ فِي الْبَدْءِ عِنْدَ اللهِ. 3بِهِ تَكَوَّنَ كُلُّ شَيْءٍ، وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَتَكَوَّنْ أَيُّ شَيْءٍ مِمَّا تَكَوَّنَ. 4فِيهِ كَانَتِ الْحَيَاةُ. وَالْحَيَاةُ هَذِهِ كَانَتِ نُورَ النَّاسِ. 5وَالنُّورُ يُضِيءُ فِي الظَّلاَمِ، وَالظَّلاَمُ لَمْ يُدْرِكْ النُّور”َ.
“الكلمة”ٍVerb, Verbe في التوراة ينصرف معناها إلى الأمر والفعل أو الخلق” (كما في القرآن: “إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (القرآن 82). أما في إنجيل يوحنا فالكلمة هي “العقل” وهي “الله” وهي “المسيح”، كما في “قانون الإيمان” أعلاه، وأيضا كما قال فيلون الإسكندري قبل يوحنا وقبل “قانون الإيمان”!
والإشكالية التي تطرح هنا بصدد “الكلمة” إشكالية فلسفية قبل أن تكون إنجيلية، ويرجع تاريخها إلى أفلاطون الذي اضطر إلى القول بإلهين: الإله المتعالي الذي “ليس كمثله شيء” والإله الصانع الخالق. وذلك كي يحل مشكلة العلاقة بين الله والعالم المتمثلة فيما يلي: إزاء وحدانية الله هناك التعدد في العالم! والله موجِد العالم أو خالقه، فكيف نفهم العلاقة بين تلك الوحدانية وهذا التعدد؟ وبعبارة أخرى: كيف نفهم صدور الكثرة عن الواحد؟.
حاول بعض فلاسفة الأفلاطونية المحدثة القائلين بفكرة الفيض حل المشكلة بالقول بثلاثة أقانيم : الله، العقل الكلي، النفس الكلية، (على اختلاف بينهم). وإذا كانت المسافة ما بين هذه الأقانيم الثلاثة وبين العناصر الثلاثة المؤسسة لعقيدة التثليث (الأب والابن وروح القدس)، بعيدة على المستوى المفهومي، فإن ما يجمع بينها هو أنها تقوم بوظيفة تثليث الألوهية. وسيدافع البابا عن كون التثليث المسيحي هو من صميم الدين، من قلب التوراة، وليس منقولا من الفلسفة، وإن كان ينسجم معها، كما سنرى لاحقا.
مماثلة على حساب التاريخ …!
بعد أن ربط البابا اللقاء بين اللوغوس اليوناني والعقيدة المسيحية بيوحنا الإنجيلي (وقد أبرزنا في المقال السابق ما يطبع هذا الربط من اختزال وقفز على التاريخ) عاد فيما يشبه الاستدراك، فقام أولا بربط اللقاء بين اللوغوس اليوناني والعقيدة المسيحية بالقديس بولس فقال:
1- “على أن اللقاء بين الرسالة الإنجيلية والعقل اليوناني لم يحصل بمجرد المصادفة. إن رؤيا القديس بولس الذي انسدت دونه طرق آسيا، والذي رأى في المنام رجلا من مقدونية يناديه: “تعال ساعدنا” (أعمال الرسل 16: 6- 10)، إن هذه الرؤيا يمكن تأويلها كتكثيف للقاء الداخلي الضروري بين العقيدة الإنجيلية والبحث (العقلي) اليوناني”. ومعروف أن القديس بولس ( 04-64 للميلاد)، كان في بداية أمره من اليهود الفرّسيين المتشددين، وكان اسمه شاوول، وقد حارب أتباع المسيح وكان أشد عليهم من غيره قبل أن يعتنق المسيحية. وقد اختلفت الآراء فيه اختلافا كبيرا، فمن قائل إنه لم يعتنق المسيحية عن اقتناع وإنما أظهر اعتناقه لها ليهدمها من الداخل! ومن قائل إنه هو الذي بنى المسيحية وليس المسيح، وأنه صاحب القول بألوهية المسيح وعقيدة التثليث الخ. والمؤكد أن قيامه بالتبشير في عدة بلدان منها اليونان، قد جعله يحتك عن قرب بالفكر الإغريقي ويتأثر به؛ ويكاد ينعقد الإجماع على أنه أعاد بناء المسيحية على أساس نظرية التثليث. ومن هنا صار التمييز بين “المسيحية الأولى” أو الأصلية كما يمكن نسبتها إلى السيد المسيح عليه السلام، وبين المسيحية “الرسمية” التي كرستها الكنيسة ومن ورائها الإمبراطورية البيزنطية.
2- بعد التأكيد على دور بولس في “اللقاء” بين المسيحية والفكر الإغريقي، يخطو البابا خطوة أخرى إلى الوراء ليتحدث عن لقاء سابق على بولس وزمنه فقال: “والواقع أن هذا اللقاء قد بدأ قبل وقت طويل. إن اسم “لله” المليء بالأسرار الذي كشفت عنه شجرة “العليقة المحترقة”، والذي به يتميز هذا الإله عن جميع الآلهة الأخرى المتعددة أسماؤها والذي صرح بكل بساطة قائلا “أنا هو”، يشكل تحديا لمفهوم الأسطورة، ويحمل بين طياته مماثلة داخلية مع محاولات سقراط تجاوز الأسطورة والتغلب عليها”.
وإذا كان من الممكن التسليم بالدور الذي قام به يوحنا الإنجيلي في الجمع بين اللوغوس الإغريقي والعقيدة المسيحية كما صاغها بولس على أساس نظرية التثليث، وإذا كان دور بولس نفسه في المزج بين الفكر الإغريقي والمسيحية من الأمور التي لا يمكن نكرانها، فإن المماثلة، التي يقيمها البابا بين سعي سقراط تغليب اللوغوس على الميثوس وبين لقاء موسى مع الله الذي كلمه تكليما، مماثلة غير صحيحة. وربما يكون من المفيد أن نذكر هنا الآيات التوراتية التي تتحدث عن “العليقة المحترقة” والآيات القرآنية التي تشير إلى نفس الحادثة. لقد وردت حادثة العليقة في قصة موسى في التوراة كما يلي: “وأَمَّا مُوسَى فَكَانَ يَرْعَى غَنَمَ حَمِيهِ يَثْرُونَ (أيوب) كَاهِنِ مِدْيَانَ (مدين)، فَقَادَ الْغَنَمَ إِلَى مَا وَرَاءِ الطَّرَفِ الأَقْصَى مِنَ الصَّحْرَاءِ حَتَّى جَاءَ إلى حُورِيبَ جَبَلِ اللهِ (طور سينا). 2وَهُنَاكَ تَجَلَّى لَهُ مَلاَكُ الرَّبِّ بِلَهِيبِ نَارٍ وَسَطَ عُلَّيْقَةٍ. فَنَظَرَ مُوسَى وَإِذَا بِالْعُلَّيْقَةِ تَتَّقِدُ دُونَ أَنْ تَحْتَرِقَ. 3فَقَالَ مُوسَى: «أَمِيلُ الآنَ لأَسْتَطْلِعَ هَذَا الأَمْرَ الْعَظِيمَ. لِمَاذَا لاَ تَحْتَرِقُ الْعُلَّيْقَةُ؟» 4وَعِنْدَمَا رَأَى الرَّبُّ أَنَّ مُوسَى قَدْ دَنَا لِيَسْتَطْلِعَ الأَمْرَ، نَادَاهُ مِنْ وَسَطِ الْعُلَّيْقَةِ قَائِلاً: «مُوسَى». فَقَالَ: «هَا أَنَا». 5فَقَالَ : “لاَ تَقْتَرِبْ إِلَى هُنَا: اخْلَعْ حِذَاءَكَ مِنْ رِجْلَيْكَ، لأَنَّ الْمَكَانَ الَّذِي أَنْتَ وَاقِفٌ عَلَيْهِ أَرْضٌ مُقَدَّسَةٌ. 6ثُمَّ قَالَ: «أَنَا هُوَ إِلَهُ أَبِيكَ، إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِلَهُ إسْحقَ، وَإِلَهُ يَعْقُوبَ» (التوراة. سفر الخروج .2). وقد وردت هذه القصة في القرآن كما يلي: “وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي” (طه 9- 14).
3- ثم يواصل البابا الرجوع إلى الوراء ليقول: “وهذه العملية التي بدأت مع “العليقة المحترقة” قد بلغت مرحلة جديدة من النضج داخل “العهد القديم” (التوراة) أثناء “السبي” (في بابل على عهد نبوخذنصر الثاني 587 – 538 قبل الميلاد)، وذلك حينما أخبر إله بني إسرائيل، -الذين كانوا في ذلك الوقت محرومين من أرضهم ومن القيام بتعاليم دينهم- أنه هو إله للسماء والأرض، مقدما نفسه بعبارة بسيطة تتناغم مع كلمة “العليقة المحترقة”: “أنا هو”. ويضيف الباب: “ومع هذا اللقاء الجديد الذي كشف فيه الله عن نفسه تتوضح شيئا فشيئا عملية إدانة عبادة الأصنام التي ليست شيئا آخر سوى تصاوير من صنع أيدي الناس” (قارن المزمور Ps 115 ونصه كما يلي: “1لاَ تُمَجِّدْنَا يَارَبُّ، بَلْ مَجِّدِ اسْمَكَ، مِنْ أَجْلِ رَحْمَتِكَ وَحَقِّكَ. 2لِمَاذَا تَسْأَلُنَا الأُمَمُ: أَيْنَ هُوَ إِلَهُكُمْ؟ 3إِنَّ إِلَهَنَا فِي السَّمَاوَاتِ. كُلَّ مَا شَاءَ صَنَعَ. 4أَمَّا أَوْثَانُهُمْ فَهِي فِضَّةٌ وَذَهَبٌ مِنْ صُنْعِ أَيْدِي الْبَشَرِ. 5لَهَا أَفْوَاهٌ لَكِنَّهَا لاَ تَنْطِقُ. لَهَا عُيُونٌ وَلَكِنَّهَا لاَ تُبْصِرُ. 6وَآذَانٌ لَكِنَّهَا لاَ تَسْمَعُ. وَأُنُوفٌ لَكِنَّهَا لاَ تَشُمُّ. 7لَهَا أَيْدٍ لَكِنَّهَا لاَ تَلْمِسُ. وَأَرْجُلٌ لَكِنَّهَا لاَ تَمْشِي، وَلاَ تُصْدِرُ مِنْ حَنَاجِرِهَا صَوْتاً. 8مِثْلَهَا يَصِيرُ صَانِعُوهَا وَكُلُّ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا”).
4- بعد هذا النوع من الاستدراك الارتدادي عاد البابا ليؤكد على أهمية “المرحة الهيلينية” في تاريخ الفكر المسيحي فقال: “وهكذا فعلى الرغم من الصراع المرير مع الحكام اليونانيين الذين كانوا يريدون الحصول بالقوة على انخراط الناس في نمط الحياة اليونانية وفي العبادة الوثنية الإغريقية، فإن العقيدة الإنجيلية، في المرحلة الإغريقية قد التقت مع ما كان يمثل الأفضل في الفكر الإغريقي على مستوى عميق جدا، فنتج عنه تعايش سلمي ومتبادل، تجلى بوضوح في أدب الحكمة الذي ظهر بعد”.
وبعد، فماذا يمكن استخلاصه من هذه الجولة التي يطبعها الذهاب والإياب؟
تتميز هذه الجولة كما رأينا بالتمركز في نقطة معينة هي لحظة يوحنا الإنجيلي المتوفى حوالي سنة 100 ميلادية، مؤلف الإنجيل الرابع. ومن يوحنا الإنجيلي ينتقل البابا إلى القديس بولس، ومع أنهما متعاصران فإن اعتبار التطور التاريخي كان يفرض أن يبدأ بهذا الأخير، لكونه المؤسس الفعلي للمسيحية الرسمية كما ذكرنا. لكن المثير للاستغراب هو أن يواصل البابا رحلته إلى الوراء، إلى النبي موسى وقصة الشجرة التي كلمه الله من خلالها ليقيم ممثلة بين الرسالة التي كلف الله بها نبيه موسى وبين سقراط “مولد” العقل في الفكر اليوناني. وكما أشرنا إلى ذلك قبل فإن المماثلة التي أقامها البابا بين “العقل” الذي يولده سقراط في مخاطبه بواسطة الحوار وبين كشف الله عن نفسه عند مخاطبته موسى “أنا الله”، مماثلة غير مناسبة. فوضع اللوغوس بالنسبة للميثوس ليس هو وضع “الله” بالنسبة لموسى، إلا إذا اعتمدنا ما ورد في القرآن، أعني قوله تعالى: “إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا” بدل ما ورد في التوراة: «أَنَا هُوَ إِلَهُ أَبِيكَ، إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِلَهُ إسْحقَ، وَإِلَهُ يَعْقُوبَ» ففي الآية القرآنية (“لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا”) نفي صريح لتعدد الآلهة، أصناما كانت أو غيرها، وفي نفي الوقت نفي للأساطير التي ترتبط بالآلهة وهو نفي عام يسري على كل زمان ومكان. أما عبارة التوراة “أَنَا هُوَ إِلَهُ أَبِيكَ، إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِلَهُ إسْحقَ، وَإِلَهُ يَعْقُوبَ” فلا تفيد نفي تعدد الآلهة ولا نفي الأصنام ولا نفي الأساطير وإنما تفيد شيئا واحد وهو أن الإله المتكلم (“أنا هو”) إله “قومي”، إله ذرية يعقوب (واسمه كان إسرائيل) وإذن فالإله المعني هو إله “بني إسرائيل”، وليس “رب العالمين” كما في القرآن.
لعل شعور البابا بضعف هذه المماثلة هو الذي جعله يلتمس السند لها مما سماه “اللقاء” الجديد بين بني إسرائيل وإلههم في منفاهم ببابل زمن الأسر حين تساءلوا قائلين: “2لِمَاذَا تَسْأَلُنَا الأُمَمُ: أَيْنَ هُوَ إِلَهُكُمْ؟” فكان الجواب ما ذكرنا قبل.
هنا فقط يأتي الفصل بين إله بني إسرائيل وبين الأصنام. لقد تم “تصحيح المماثلة”! ولكن على حساب التاريخ، على حساب الزمان والمكان، وبالعودة إلى ما قبل المسيحية بخمسة قرون! زمع ذلك لم يتردد البابا من القول: “وهكذا … فإن العقيدة الإنجيلية، في المرحلة الهيلينية (الإغريقية) قد التقت مع ما كان يمثل الأفضل في الفكر الإغريقي على مستوى عميق جدا، فنتج عنه تعايش سلمي ومتبادل، تجلى بوضوح في أدب الحكمة الذي ظهر بعد” (يعني أدب المزامير والأمثال المليء بالنصائح الأخلاقية المقتبسة من هنا وهناك.
آراء المتكلمين الإسلاميين تسافر إلى أوربا…
بعد أن أبرز البابا “الطابع الإغريقي” للعقيدة المسيحية من خلال مفهوم اللوغوس الذي حمَّله المعنى الإغريقي اـ”العقل” والمعنى الديني لـ”الكلمة”، يلتمس شاهدا آخر على “اللقاء” الذي حصل بينهما في ترجمة التوراة من العبرانية إلى الإغريقية، والتي يقول عنها إنها لم تكن مجرد ترجمة وإنما كانت “تأليفا” بين معاني التوراة والخطاب الإغريقي. قال: “ونحن نعرف اليوم أن الترجمة اليونانية للعهد القديم التي عملت في الإسكندرية والمسماة بـ”السبعينية” (قام بها اثنان وسبعون مترجما وأنتجت اثنتين وسبعين ترجمة)، هي أكثر من مجرد ترجمة بسيطة للنص العبري: إنها بالعكس من ذلك، شاهد نصي مستقل وخطوة هامة في تاريخ العقيدة، تحقق بها هذا اللقاء الذي كانت له دلالة خاصة بالنسبة لميلاد المسيحية وانتشارها. لقد كان لقاء عميقا بين الإيمان والعقل، لقاء بين أنوار (العقل) والدين الأصيل”.
قد يتساءل القارئ: كيف يتحول نص ديني قوامه رؤى وتفسير أحلام وسرد حكايات وأخبار وسلوكات إلى نص يجمع بعمق بين الإيمان والعقل؟ قد يصعب على المرء أن يجيب عن مثل هذا الإدعاء ولكن بالإمكان التساؤل: لماذا بقيت الميثولوجيا اليونانية خطابا للأسطورة منفصلا عن خطاب العقل؟ ولماذا تطلب الأمر قيام مدارس فلسفية وعلمية حتى يغدو في الإمكان انفصال اللوغوس عن الميثوس، مع أن اللغة ظلت هي نفسها: اللغة اليونانية؟
إذا نحن أخذنا بمبدأ “الغاية تبرر الواسطة” فإننا ربما نفهم ما يوجه فكر البابا في هذا الخطاب الذي لا يفتأ يمتدح فيه “اللقاء” بين اللوغوس اليوناني والعقيدة المسيحية. ربما…
ربما نتبين ذلك من خلال متابعة فقرات خطابه. يقول بعد الفقرة السابقة مستخلصا النتيجة من الجولة التاريخية الارتدادية التي قام بها في أزمنة التوراة: “وهكذا فلكون مانويل الثاني (الإمبراطور الذي حاور العالم الفارسي) قد انطلق من جوهر العقيدة المسيحية وفي الوقت نفسه من جوهر الفكر الإغريقي الذي كان قد امتزج مع العقيدة، استطاع أن يقول : “إن عدم اعتماد “اللوغوس” (العقل) في السلوك أمر مخالف لطبيعة الله”. إن امتزاج العقيدة المسيحية باللوغوس الإغريقي هو الذي جعل العقل المسيحي ينبذ العنف ولا يفكر في استعماله لنشر الدين. وينتج عن ذلك، بالخلف، أن الانفصال بين العقيدة الإسلامية وبين اللوغوس هو الذي جعل نبي الإسلام “يستعمل العنف” في نشر الدعوة! لكن، ألم يستعمل اليونان –أصحاب اللوغوس- العنف والسيف في تاريخهم الاستعماري وفي الحروب بين أثينا واسبرطة، وفي فتوحات الإسكندر المقدوني تلميذ أرسطو؟
يمكن للمرء أن يتساءل : إذا كانت ترجمة التوراة من العبرية إلى الإغريقية قد نقلتها من مستوى الدين إلى مستوى العقل فلماذا لم يحدث الشيء نفسه بترجمة العلوم اليونانية إلى العربية، ولماذا لم يحصل عكس ذلك بترجمة القرآن في القرن الثاني عشر الميلادي إلى اللاتينية؟
يتراجع البابا قليلا ليطلب “النزاهة” من خلال الاعتراف بأنه حصل في القرون الوسطى أن تعرض “اللقاء” بين الروح الإغريقية والروح المسيحية لعملية كسر وفصل بسب ظهور نزعة تعلى من شأن الإرادة على حساب العقل. يقول: “وإن النزاهة لتقتضي منا أن نسجل أنه خلال القرون الوسطى المتأخرة، وجدت تيارات لاهوتية كسرت هذا التأليف بين الروح الإغريقية والروح المسيحية. لقد قامت مع دانز سكوت Duns Scot نزعة تعلي من شأن الإرادة، ضدا على ما يطلق عليه “الاتجاه الروحي” لدى كل من أغسطين وتوما (الإكويني). وقد قادت هذه النزعة الإرادوية في النهاية إلى النظرية التي تقول : نحن لا نعرف عن الله إلا “الإرادة الظاهرة” Voluntas ordinata، أما ما يتجاوز ذلك فهو من مجال حرية الله التي يمكن بموجبها أن يفعل نقيض كل ما فعله حتى الآن. هنا ترتسم مواقف تقترب بوضوح من مواقف ابن حزم (كذا!) ويمكن أن تقود إلى صورة لإله متقلب المزاج، وغير ملتزم بالحقيقة والخير”. ( يعني: إله المسلمين!)
يطرح البابا في هذه الفقرة ثلاثة اتجاهات فكرية : 1) دانز سكوت، 2) القديس أغسطين والقديس توما الأكويني، 3) من يسميهم بأصحاب النزعة الإرادوية، لاهوتيين وفلاسفة (ومنهم في الفكر الفلسفي الحديث شوبنهاور ونيتشه، وفي علم النفس فوندت، وفي علم الاجتماع ويبر…).
لنسجل أولا أن صاحبنا قد اقتصر على ذكر القديس أوغسطين (354-430) St.Augustin، (مولود في سوق أهراس بالجزائر)، والقديس توما الأكويني الإيطالي (1225-1274)، ولم يقف عندهما مع أنهما من أساطين اللاهوت المسيحي في القرون الوسطى! ولا ندري ما السبب؟ هل لأنهما ينتميان معا إلى “النزعة الروحية”، وهي نزعة تعطي أهمية للإرادة، فعلا، ولكن ليس على حساب العقل (سميت بهذا الاسم، في مقابل “النزعة المادية” وليس في مقابل النزعة العقلية)!؟ أم السبب هو أن القديس أوغسطين كان أميل إلى أفلاطون ومتأثرا بابن سينا بينما كان القديس توما الأكويني أميل إلى أرسطو ومتأثرا بابن رشد؟
أما أصحاب “النزعة الإرادية” فسنتحدث عنهم لاحقا في المكان الذي تحدث عنهم البابا في خطابه. يبقى أن نركز هنا على ما ركز عليه الحبر الأعظم في الفقرة السابقة، أعني اللاهوتي والفيلسوف الاسكتلندي دانز سكوت (1266-1308). والواقع أن ما قاله البابا عن دانز سكوت شيء مبالغ فيه. وربما يكون من الجائز القول إن الخطأ الذي ارتكبه البابا في شأن ابن حزم -الذي استدعاه هنا مرة أخرى- يكرره في هذه الفقرة في شأن دانز سكوت.
وما يهمنا هنا ليس الدخول مع الحبر الأعظم في جدل في موضوع هو من ميدانه (تاريخ اللاهوت المسيحي) وإنما يهمنا أن نبين أن آراء دانز سكوت لا تتفق مع ما نسبه البابا إلى ابن حزم من قبل، بل تتفق مع التصحيح الذي قمنا به نحن في هذا المكان حين شرحنا آراء المعتزلة والأشاعرة في مسألة “الاستطاعة” وبالتالي الإرادة.
ذلك أن وجهة نظر دانز سكوت تكاد تكرر ما قاله الأشاعرة، بما فيهم الغزالي، في هذا الشأن. ولما كان المجال لا يتسع لبسط القول في هذا الموضوع فسنقتصر على ذكر الأفكار الرئيسية التي نادى بها دانز سكوت. والذين من القراء على صلة بعلم الكلام في الإسلام سيدركون كيف أن كثيرا من أفكار المتكلمين الإسلاميين قد سافرت إلى أوربا وحركت هناك حوارا أسس لفكر النهضة الأوربية.
يرى دانزكوت أن العقل يمكن أن يصل بنا إلى معرفة وجود السبب الأول (الله) من خلال تتبع سلسلة المسببات وأسبابها (بناء على مبدأ لاشيء إلا وله سبب) ولكن العقل في نظره لا يستطيع أن يعرفنا بالله (أي بحقيقة ذاته وصفاته)، ولذلك يجب الرجوع إلى الوحي (قارن مع الغزالي ومع المتكلمين السنة عموما). هو يرى أن الفلسفة واللاهوت حقلان معرفيان متميزان أحدهما عن الآخر، ولكنهما متكاملان من حيث أن الفلسفة خادمة لللاهوت أي للأخلاق. إن الموضوع الأول للاهوت هو الله منظورا إليه من حيث طبيعته الخاصة (ذاته وصفاته) بينما تنظر الفلسفة إلى الله من زاوية أنه السبب الأول للموجودات. ومن هنا يرى أن اللاهوت ليس علما (يرمي إلى قوانين) بل هو علم تطبيقى لا يهتم بالمسائل النظرية إلا من حيث أنها تساعد في خلاص الإنسان بواسطة الوحي (قارن مع ابن رشد). ويرى أنه إذا فرضنا أن الفلاسفة يستطيعون أن يتبينوا ما هو راجع إلى طبيعة الله فإنهم لا يعرفون شيئا عن أفعاله الحرة كما يجهلون وجود جوهر ثلاثي الماهية (الأب والابن وروح القدس). وأخيرا وليس أخيرا: هو يرى أن إرادة الله حرة تماما وأنها لا تتأثر ولا تتحدد بالمؤثرات الخارجية. ويقول إن الله يأمر بشيء لا لأنه يرى أن هذا الشيء حسن، بل هو يجعله حسنا بأمره به (قارن مع رأي الأشاعرة والحنابلة في الحسن والقبح!).
لقد فهمت نظريته من بعض معاصريه فهما خاطئا تماما كما فهمت نظرية ابن حزم فهما خاطئا من طرف البابا وخوري وأرلنديز! لقد نُسب إليه القول بأن الله كان قادرا على أن يجعل الدائرة مربعة أو أن يجمع المتناقضات في هوية واحدة، هذا في حين أن رأيه في هذه الأمور مخالف تماما لما نسب إليه. إنه يرى أن الله كان قادرا على أن يبدل ماهيات الأشياء الواقعية على غير ما هي عليه الآن، وأن ذلك لو حدث لتغيرت معه نواميس العالم ولتغيرت مع تغيرها قواعد الأخلاق، وبالتالي أوامر الله. وهكذا فالشخص الذي يرى أن ملكية الأشياء ليست ضرورية يمكن أن يقول إن الله كان يمكن أن لا يحرم السرقة. الله في نظره يخلق دون أن يخضع فيما يخلق لقاعدة الصلاح أو الأصلح، أي أنه يخلق الصلاح وغيره (قارن مع الأشاعرة)، وأنه أرسل “ابنه” باستقلال عن الخطيئة الأصلية. وبالجملة فدانز سكوت يولي أهمية كبرى للإرادة ولكنه يجعل لها حدودا يرسمها العقل. هو يرى أن الإنسان يستطيع بعقله أن يتوصل إلى معرفة وجود الله وبعض صفاته ولكنه لا يستطيع أن يفهم بعقله أشياء كلها أسرار مثل التثليث والتجسد والخَلق في زمان. ويرى أن الفيلسوف يستفيد، في المجال الطبيعي الخاص به، من نور فوق طبيعي. ويقول إذا كان ابن سينا قد استطاع أن يذهب في تعريف الموجود الأول أبعد مما ذهب أرسطو فإن الفضل في ذلك يرجع إلى تعاليم القرآن.
المسيحية وجدت طابعها النهائي في أوربا؟
(*)محمد عابد الجابري
واصل البابا بنديكت السادس عشر، في خطابه الشهير، حملته على التوحيد الإسلامي فقال: “إن تنزيه الله والقول بمغايرته للمخلوقات أمران قد بولغ فيهما إلى درجة أن مفاهيم العقل والحقيقة والخير تفقد وضعها كمرايا صادقة تعكس إرادة لله، وبالتالي تغدو الأسرار الثاوية وراء مشيئته الفعلية الظاهرة غير قابلة للمعرفة وخفية عنا إلى الأبد. ومقابل هذا التصوّر، فإن العقيدة التي تقررها الكنيسة تلح دائما وبقوة على حقيقة أن بين الله وبيننا، بين روحه الأبدي الخالق وعقلنا المخلوق، يوجد تماثل حقيقي: تماثل يظل معه التباين والاختلاف (بين المثل والممثول) أكبر بصورة لا نهائية –كما قرر ذلك المجمع المسكوني الرابع المنعقد في لاتران Latran سنة 1245- ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى محو التماثل وإسكات ما ينطق به. إن الله لا يصبح أكثر ألوهيةً عندما ندفع به بعيداً عنا، عندما نتبنى “نزعة إرادية” خالصة عصية عن الفهم” (أي تعلق كل شيء على إرادة الله).
ويضيف: “بدلا من ذلك فإن الإله، الإله حقا، هو الله الذي كشف عن ذاته هو نفسه بوصفه لوغوس (كلمة، عقل)، والذي بوصفه كذلك، تصرف ويواصل التصرف، ولا شيء يحمله على ذلك غير محبته لنا. وإنه لمن المؤكد، كما قال القديس بولس، فإن المحبة تسمو على المعرفة، وبالتالي فهي أقدر على الإدراك من الفكر وحده. (cf. Eph 3 :19) ومع ذلك، تبقى المعرفة هي محبة الله الذي هو لوغوس (كلمة/عقل). من أجل ذلك كانت عبادة الإله المسيحي، كما قال بولس، عبادة منسجمة مع الكلمة الأزلية ومع عقلنا‘logiké latreia’ ، (بالإغريقية في النص) (Cf.Rom 12 :1).
ويواصل قائلا: “إن هذا اللقاء الحميمي بين العقيدة الإنجيلية والتساؤلات الفلسفية اليونانية ليس حدثاً بالغ الأهمية من زاوية تاريخ الأديان فحسب، بل هو أيضا حدث حاسم بالنسبة لتاريخ العالم، وهو يهمنا اليوم أيضا. وبفضل هذا التقارب غدا من غير المدهش أن نرى المسيحية، رغم أصولها وبعض التطورات الدالة التي عرفتها في الشرق، قد وجدت في النهاية طابعها اليوناني الحاسم في أوربا”. واستطرد موضحا: “بالإمكان قول الشيء نفسه بعبارة أخرى: إن هذا اللقاء الذي انضاف إليه تراث روما قد صنع أوربا وهو يشكل في العمق ما يمكن أن يطلق عليه حقا أوربا”.
***
تشكل الفقرات التي ناقشناها لحد الآن من خطاب البابا ما يمكن اعتباره القسم الأول من خطابه، وقد خصصه كما رأينا لعرض “الشهادات التاريخية” التي تزكي الأطروحة التي انطلق منها وهي “التزاوج” بين اللوغوس الإغريقي والعقيدة المسيحية. أما هذه الفقرة فهي بمثابة جسر بين القسم الأول والقسم الثاني من نفس الخطاب.
وكما هو واضح فقد خصص البابا هذه الفقرة/الجسر للتصريح عما كان ثاويا في النصف الأول من الخطاب، على صورة أجزاء حاول إثباتها من خلال وقائع تاريخية ركز عليها تركيزا على حساب التاريخ ككل. وهكذا كشف في هذه الفقرة الجسر عن ثلاثة أركان هي قوام خطابه:
الركن الأول رفض التنزيه المطلق للذات الإلهية، وقد مهد له بما ذكره عن حوار الإمبراطور مع العالم الفارسي، ثم أفصح عنه بصورة مغلفة في ما نسبه لابن حزم. وإذن فالطرف الأول المستهدف هو التنزيه الإسلامي للذات الإلهية الذي يقوم على قوله تعالى: “لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ” (الشورى 11)، وقوله تعالى: ” َقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ” (المائدة 73).
الركن الثاني: إقصاء الفرق المسيحية الشرقية. وهذا الإقصاء كان ثاويا وراء المسكوت عنها في القسم الأول من الخطاب، ثم جاءت الفقرة/الجسر لتصرح به بكلام لا لبس فيه. قال البابا: “وبفضل هذا التقارب (بين اللوغوس اليوناني والعقيدة الإنجيلية) غدا من غير المدهش أن نرى المسيحية، رغم أصولها وبعض التطورات الدالة التي عرفتها في الشرق، قد وجدت في النهاية طابعها اليوناني الحاسم في أوربا”. هكذا يستعيد البابا من جديد ذلك الصراع، الصريح حينا والهادئ حينا، الذي عرفه تاريخ المسيحية، الصراع بين الكنائس الشرقية (النسطورية واليعقوبية)، وبين الكنيسة الغربية الرومانية المعروفة في التاريخ الإسلامي بـ “الكنيسة الملكانية” (أي المؤيدة للأمبراطور).
الركن الثالث: إقصاء الفرق المسيحية الحديثة المختلفة مع فرقة البابا (الكاثوليكية)، أعني الأرثوذكسية والبروتستانتية: ذلك ما عبر عنه البابا بقوله في نهاية الفقرة: “إن هذا اللقاء (بين العقيدة المسيحية والفلسفة اليونانية)، الذي انضاف إليه تراث روما، قد صنع أوربا، وهو يشكل في العمق ما يمكن أن يطلق عليه حقا أوربا”. هذا يعني بصريح العبارة أن أوربا “المسيحية حقا” هي أوربا تراث اليونان والرومان، أما ما عداها فبدعة وهرطقة، بما في ذلك وجهة نظر مواطن البابا ومعاصره اللاهوتي الفيلسوف الألماني هارناك كما سنرى لاحقا…
وفي مقابل هذا الإقصاء المتعددة أبعاده واتجاهاته لم يكف البابا، في القسم الأول من الخطاب، كما في الفقرة/ الجسر، عن تكرار الإحالة إلى بولس والاقتباس منه والتنويه به. وليس هناك من سبب غير كون هذا الحواري هو الذي صاغ العقيدة المسيحية على أساس التثليث وفي الوقت نفسه قطع هو وأصحابه مع الشعائر التوراتية الإبراهيمية مثل الختان، والسبت، فاستغنوا عن الأول وأحلوا الأحد مكان السبت، ومنعوا الزواج عن الرهبان إلى غير ذلك مما صار موضوع خلاف بين اليهود والنصارى. ولكي نفهم هذا المسار ومعارجه قد ينبغي فتح قوس نكشف فيه عن خلفيته التاريخية.
***
لما قام السيد المسيح عليه السلام بنشر دعوته كان على رأس الطائفة التي آمنت به بعض يهود فلسطين فكانوا هم المسيحيون الأول، وقد استندوا في تصورهم للدين الجديد على ما ورد في التوراة. كانوا يقولون بأن المسيح هو المخلِّص الذي بشرت به التوراة وأنه رسول وإنسان كسائر البشر، ولدته مريم، كما يولد سائر الناس، ولكن بدون أب، بل ولد بنفخة من روح الله، وأنه جاء لتطبيق تعاليم التوراة سواء على مستوى العقيدة أو السلوك الديني، ومن هنا حرصهم على الختان وإقامة السبت وتحريم أكل الخنزير الخ.
ومن اليهود الذي اعتنقوا المسيحية بعد أن قاوموها واضطهدوا أهلها شخص يسمى شاوول انقطع للدعوة خارج الجماعات اليهودية، أي لدى “الأمم”، وقد سمي ولقب بسبب نشاطه التبشيري بـ” بولس الرسول”. ويقول مؤرخو الفكر المسيحي إنه أول من قام بالمزج بين العقيدة التي بشر بها السيد المسيح التي تقول بإله واحد، وبين الأفلاطونية المحدثة التي تقول بضرورة الوسيط بين الله والعالم، مقيما نوعا من التوازي بين النظرية الفلسفية التي تقول بالعقل الكلي، والنفس الكلية، والهيولى أو المادة الأولى، وبين ما يعرف بعقيدة التثليث: الآب، والابن، وروح القدس.
هذا على صعيد التبشير بالدين الجديد، أما على الصعيد الفلسفي فقد كان هناك في الإسكندرية الأسقف الفيلسوف: أوريجينOrigène (Origenes), (185-254 م)، الذي تمسك بالتنزيه المطلق للإله متبنيا نظرية أفلاطون في الإله المتعالي فقال: الله روح مطلق لا علاقة له بالمادة إطلاقا، وإذا كان الكتاب المقدس (التوراة) يصف الله بصفات أو يسميه بأسماء لا تتفق مع كونه روحا مطلقا، مثل وصفه بأنه نور ونفَس وروح، فيجب في نظره أن يحمل ذلك على المعنى المجازي. أما الله في حقيقته فمستقل كل الاستقلال عن كل ما هو مادي، فهو لا يتحدد لا بالزمان ولا بالمكان، وبالتالي يمتنع علينا إدراك حقيقته أو التعبير عنها.
في ذلك المناخ الفكري، الذي عرفته مدرسة الإسكندرية الفلسفية، برز في الكنسية القبطية أسقف أصله من ليبيا واسمه آريوس Arius, Arrious (مولود سنة 270 ميلادية). تأثر بأفكار أوريجين الفيلسوف وتحمس لها وصار يدعو إليها وينشرها، فتبعه كثير من رجال الدين وجمهور الشعب فقوي مركزه. وحوالي عام323 للميلاد أعلن ثورته، على القول بألوهية المسيح، مؤكدا بشريته، مقررا أن الآب وحده هو الإله. كان يقول: “إذا كان اللـه الأب مطلق الكمال، ومطلق السمو، ومطلق الثبات، وإذا كان منشئ كل الأشياء دون أن يكون ذاته صادراً عن أي شيء آخر فإنه من الواضح أنّ كل شيء وكل شخص آخر في العالـم منفصل عن اللـه (…) وإذا كان كل شيء منفصلاً عن اللـه، فلا يمكن أن يكون هناك إلاّ إله واحد. ولهذا فلا بد أن يكون المسيح قد خلق في زمن ما. ولا بد أن يكون معرضاً للتغير والخطيئة، وأنه لا يملك معرفة حقيقة فكر اللـه”.
أحدثت آراء أريوس الجريئة هذه أزمة خطيرة على الصعيدين الديني والسياسي في العالم المسيحي. فدعا الإمبراطور “قسطنطين العظيم” إلى عقد مجمع مسكوني في نيقيه (عام 325م) Concile de Nicée، لإيجاد حل كهنوتي لهذه المسألة. وقد قرر هذا المجمع طرد آريوس وأصحابه على أساس أنهم فرقة ضالة مبتدعة، كما وضع ذلك المجمع “قانون الإيمان” الذي رسَّم عقيدة التثليث.
وغني عن البيان القول إن المسيحية التي يدافع عنها البابا في خطابه هي هذه التي تسميها المراجع الإسلامية بـ “الفرقة المكانية”، نسبة إلى “الملك”: الإمبراطور البيزنطي. فليس غريبا إذن أن يقول البابا : “إن هذا اللقاء (بين العقل الإغريقي والإيمان المسيحي) الذي انضاف إليه تراث روما قد صنع أوربا، وأنه يشكل في العمق ما يمكن أن يطلق عليه حقا أوربا”.
مسألة نزع الطابع الإغريقي عن العقيدة المسيحية
(*)محمد عابد الجابري
إذا نحن نظرنا إلى بنية خطاب البابا من منظور هيجلي وجدناه عبارة عن أطروحة وطباق وتركيب (أو إثبات، ونفي، ونفي النفي). أما الأطروحة فهي الفقرات التي حللناها وناقشناها وتشكل القسم الأول من الخطاب، وهي تدور كلها حول إثبات “الطابع الإغريقي” للعقيدة المسيحية. وأما طباقها فهي التيارات اللاهوتية الفلسفية التي نادت بضرورة نزع ذلك الطابع من العقيدة المسيحية والرجوع بها إلى بساطتها الأولى. وأما التركيب فهو الدعوة إلى الجمع بين العقل والإيمان في حوار الديانات.
لقد حللنا الأطروحة فلننتقل أولا إلى طباقها!
يقول البابا: “وفي مواجهة هذه الأطروحة (أطروحته هو) القائلة بأن الموروث الإغريقي الذي غربله النقد، يشكل جزءا لا يتجزأ من العقيدة المسيحية، تقف تلك الدعوات إلى نزع الطابع الهيليني (الإغريقي) من المسيحية، الدعوات التي صارت تهيمن أكثر فأكثر على المناقشات اللاهوتية ابتداء من بداية العصر الحديث”.
يؤرخ البابا لهذه الدعوات فيقول: “وإذا نحن فحصنا هذه الدعوات عن قرب فسنلاحظ أنها قد مرت عبر مراحل ثلاثة، متداخلة فعلا، ولكنها متمايزة بعضها عن بعض بوضوح، وذلك سواء على مستوى دوافعها أو على مستوى أهدافها”.
– المرحلة الأولى: “لقد انبثقت فكرة نزع الطابع الهيلّيني عن المسيحية بارتباط مع مبادئ الإصلاح (الديني) في القرن السادس عشر. فعندما نظر الإصلاحيون (لوثر وأتباعه)، إلى تقاليد اللاهوت المدرسي (لاهوت القرون الوسطى)، انتابهم الشعور بأنهم يواجهون نظاما من الإيمان مؤطرا كليا بالفلسفة، مقولبا ضمن نظام فكر أجنبي عنه. والنتيجة أن العقيدة لم تعد تبدو بوصفها “كلمة” تاريخية حية بل بوصفها عنصرا مقحما في منظومة فلسفية. ومن جهة أخرى فإن مبدأ “الكتاب الوحيد” sola scriptura(يعني دعوة الإصلاحيين إلى اعتماد التوراة وحدها مرجعا) كان يقتضي، بالعكس من ذلك، البحث عن العقيدة في شكلها الأصيل كما هي معطاة في كلمات التوراة. ومن هنا كانت الميتافيزيقا تبدو وكأنها نظام فكري مستورد، وبالتالي يجب تحرير العقيدة المسيحية منه كي تعود من جديد عقيدة خالصة كليا. وعندما أعلن كانط (الفيلسوف) أنه سيضع العقل الخالص جانبا كي يترك المكان للعقيدة فإنه كان يعلن عن برنامج يتسم براديكالية لم يكن الإصلاحيون يتوقعونها أبدا. لقد حصر العقيدة في العقل العملي (الأخلاق)، مانعا عليها الدخول إلى كلية الواقع”.
– المرحلة الثانية: “وجاء اللاهوت الليبرالي في القرنين التاسع عشر والعشرين، وعلى رأسه أدولف فون هارناك Adolf von Harnack، ليدشن المرحلة الثانية في الدعوة إلى نزع الطابع الهيليني من المسيحية. وفي الوقت الذي كُنتُ فيه طالبا وخلال السنوات الأولى من نشاطي الأكاديمي، كان هذا البرنامج قوي التأثير أيضا في اللاهوت الكاثوليكي. لقد اتخذ منطلقا له ذلك التمييز الذي أقامه باسكال بين إله الفلاسفة وإله إبراهيم وإسحق ويعقوب. وقد تناولت هذا الموضوع في محاضرتي الافتتاحية في بون عام 1959، ولست أريد هنا تكرار جميع ما سبق أن قلته في تلك المناسبة، ولكني أحب أن أصف باختصار على الأقل ما كان يمثل الجديد في هذه المرحلة من الدعوة إلى نزع الطابع الهيليني عن المسيحية، قياسا بالمرحلة السابقة.
كانت الفكرة المركزية التي قال بها “هارناك” هي العودة إلى المسيح بوصفه بشرا لا غير، وإلى رسالته البسيطة، السابقة لجميع عمليات إضفاء الطابعين اللاهوتي والهيليني عليها. إن هذه الرسالة البسيطة للسيد المسيح تمثل قمة التطور الديني للإنسانية. لقد استبعد السيد المسيح شعائر العبادة وأحل الأخلاق محلها. وهكذا اعتبر، في نهاية الأمر، كأب لرسالة أخلاقية مفعمة بمحبة البشر. فإذا نظرنا إلى نظرية هارناك وجدناها في عمقها تجعل المسيحية منسجمة ومتوافقة مع العقل الحديث، وذلك بتحريرها من العناصر التي تبدو بوضوح مستقاة من الفلسفة واللاهوت، مثل الاعتقاد في ألوهية المسيح وفي القول إن الله ثالث ثلاثة”.
“وهكذا فبانتظام اللاهوت في التفسير التاريخي النقدي لـ”العهد الجديد” (الإنجيل)، سيكون له الحق من جديد في الدخول إلى رحاب الجامعة. إن اللاهوت، بالنسبة لهارناك، هو تاريخي بالأساس، وبالتالي فهو حصرا من مجال العلم (=وليس من مجال العقيدة). وما يستطيع اللاهوت قوله عن المسيح، بخطاب نقدي، سيكون من إنتاج العقل العملي وبالتالي يمكن أن يحتل مكانه في الكل الجامعي. ووراء هذا النوع من التفكير يكمن ما يعبر عنه بـ”التحديد الذاتي للعقل”، وهي عبارة تجد تعبيرها الكلاسيكي عند (الفيلسوف) كانط في “نقدياته”، وقد صارت أكثر راديكالية مع مرور الزمن في النشاط العلمي المعاصر”.
ويضيف البابا: “يمكن القول باختصار إن هذا المفهوم الحديث للعقل مؤسس على الجمع بين الأفلاطونية (الديكارتية) والتجريبية، وهو تأليف أكده نجاح التكنولوجيا: فمن جهة يفترض مسبقا القول بالبنية الرياضية للمادة، أي معقوليتها الذاتية التي تجعل من الممكن فهم المادة وبالتالي استعمالها كطاقة فاعلة. إن هذه الفرضية الأساسية هي العنصر الأفلاطوني في الفهم الحديث للمادة. ومن جهة أخرى هناك قابلية الطبيعة لتكون موضوع استغلال لصالح حاجاتنا، وهنا تقدم التجربة وحدها إمكانية التحقق أو عدمه، الشيء الذي يمكننا من الحصول على يقين تام. والوزن بين هذين القطبين يمكن، حسب الظروف، أن ينتقل من جانب إلى آخر. فالمفكر الوضعي المتشدد مثل ج. مونود J. Monod قد صرح هو نفسه بأنه أفلاطوني ديكارتي باقتناع”.
“وهذا يثير مسألتين أساسيتين بالنسبة لموضوعنا هنا.
“إحداهما أن نوع اليقين الذي ينتج من التفاعل بين الرياضيات وعناصر التجربة هو وحده الذي يستحق أن يعتبر يقينا علميا، وبالتالي فكل ما يدَّعي الانتماء إلى العلم يجب أن يمتحن بهذا المعيار. ومن هنا القول بأن العلوم الإنسانية مثل التاريخ وعلم الاجتماع والفلسفة يجب أن تستجيب لمعيار العلمية هذا.
“أما ثانية المسألتين، وهي هامة بالنسبة لتأملاتنا هنا، فهي أن هذا المنهج يستبعد بطبيعته ذاتها مسألة الله، ويجعلها تبدو كمسألة غير علمية أو تنتمي إلى ما قبل العلم. والنتيجة أننا إزاء إفقار لساحة العلم والعقل، الشيء الذي يستحق منا الوقوف عنده. وسأعود إلى هذه المسألة لاحقا”.
ويضيف البابا: “وإلى أن يحين ذلك يجب أن نلاحظ أنه منذ بداية المنطلق (الذي أدى إلى هذه النتيجة) أصبحت كل محاولة للإبقاء على القضايا اللاهوتية في حقل “العلم” تؤدي إلى اختزال المسيحية إلى جزء صغير مما هي إياه. ويمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول: إذا كان العلم ككل هو وحده، هذا الذي ذكرناه (الرياضيات/التجربة)، فإن النتيجة ستكون أن الإنسان نفسه سينتهي إلى أن يختزل هو أيضا. ذلك لأن المسائل التي تختص بالإنسان، أصله ومصيره، والقضايا التي تثار في حقل الدين والأخلاق، لن يكون لها أي مكان في ميدان العقل الجمعي كما يتحدد بـ”العلم”، وبالتالي يجب أن يلحق بعالم الذات. وفي هذه الحالة سيكون على الذات (الفرد) أن تقرر بناء على تجاربها وخبراتها فيما تعتبره مقبولا في مجال الدين، فيغدو “الوعي” الذاتي حينئذ هو المعيار الوحيد لما هو أخلاقي. وبهذا يفقد كل من الدين والأخلاق قدرتهما على الانتظام في كلٍّ واحدٍ ويغدوان قضية شخصية محض، لا ضابط لها. وهذا شيء خطير بالنسبة للإنسانية، كما هو ظاهر في الآفات المثيرة للقلق التي تصيب الدين والعقل والتي تظهر، ضرورة، عندما يختزل العقل إلى الدرجة التي يصبح فيها كل من الدين والأخلاق من الأمور التي لا تهم العقل في شيء. أما المحاولات التي تهدف إلى بناء أخلاق انطلاقا من قوانين التطور أو انطلاقا من علم النفس وعلم الاجتماع فلم يكن لها ما بعدها، لسبب بسيط وهو أنها محاولات غير مناسبة”.
– “المرحلة الثالثة: وقبل أن أنتقل إلى نتائج جميع ما تقدم قوله، أريد أن أتحدث بسرعة عن المرحلة الثالثة في الدعوة إلى نزع الطابع الهيليني عن اللاهوت المسيحي، أعني المرحلة التي نعيشها الآن. يقول البعض هذه الأيام، على ضوء ما هو حاصل من تعدد ثقافي، إن الجمع بين الهيلينية والعقيدة المسيحية كان عبارة عن تلاقح (تداخل) حصل في الكنيسة “القديمة” (الأصلية) وليس من الصواب فرضه على ثقافات أخرى، وأنه من حق تلك الثقافات أن تتجنب هذا التداخل لتعود إلى الرسالة البسيطة لـ”العهد الجديد” (الإنجيل) ليتم التلاقح في بيئة هذه الثقافات. وهذه الأطروحة –يقول البابا- ليست خاطئة وحسب، بل إنها خشنة وغير دقيقة ولا واضحة. إن “العهد الجديد” مكتوب بالإغريقية ويحمل معه طابع الروح الإغريقية التي كانت قد وصلت فعلا إلى مرحلة النضج، مع تطور العهد القديم” (التوراة).
“فعلا، هناك عناصر في صيرورة الكنيسة القديمة لا يجب أن تندمج في جميع الثقافات. ومع ذلك فإن القرارات الأساسية المتعلقة بالعلاقة بين العقيدة واستعمال العقل البشري هي جزء من العقيدة. إنها تطورات تتناغم مع طبيعة العقيدة نفسها”.
تلك هي قراءة البابا للدعوات المنادية بنزع الطابع الإغريقي عن العقيدة المسيحية، والعودة بها إلى بساطتها كما كانت زمن السيد المسيح، الشيء الذي يعني تجريد البابا من اختصاصاته، وبالتالي الاستغناء عن وجوده. وإذن فموقف البابا مفهوم، ونحن نتفهمه، ولكن لا بمعنى أنا نوافقه أو نعترض عليه، فذلك ليس شأننا.
خاتمة الخطاب: مناقشة وتفكيك
نعرض في هذا الفقرة لخاتمة خطاب البابا، وهي تشكل –كما قلنا- لحظة التركيب في هذا الخطاب، بعد القسم الأول منه (الأطروحة) والقسم الثاني (طباقها). وقبل إبداء الرأي في هذه الخاتمة ندع القارئ يطلع عليها أولا.
يقول الباب: “أَصِل الآن إلى خاتمة هذه المحاضرة. إن هذه المحاولة التي رسمنا فيها الخطوط العريضة لنوع من النقد الذاتي للعقل الحديث لا علاقة لها مع إرادة العودة إلى ما قبل عصر الأنوار ورفض الإضاءات التي جاءت بها الحداثة. إن أهمية الفكر الحديث وتطوره الواسع أمر مقبول بدون قيد ولا شرط. نحن جميعا نعترف بروعة الإمكانات التي انفتحت أمام النوع الإنساني وبأنواع التقدم التي حصلت. إن أخلاقيات الروح العلمية- كما أشرتم إلى ذلك جناب العميد- تقتضي الخضوع للحقيقة، وبوصفها كذلك فهي تعبير عن موقف ينتمي إلى الاختيارات الأساسية للروح المسيحية. إن هدفنا هنا ليس القيام بعملية إفقار واختزال ولا بنقد سلبي. إن ما هدفنا إليه هو إضاءة المفهوم الذي لدينا عن العقل وعن استعماله. ذلك أننا في الوقت الذي ننشرح فيه للإمكانات الجديدة التي تنفتح أمام الإنسانية، نشاهد في الوقت نفسه أخطارا تنمو مع هذه الإمكانات نفسها، ومن الواجب علينا أن نفكر في كيفية التحكم فيها.
ولن نستطيع ذلك إلا إذا اتحد العقل والإيمان بصورة جديدة، إلا إذا تجاوزنا الحدود التي فرضها العقل على نفسه (بالتقيد بما يقبل التحقق تجريبيا)، وكشفنا الغطاء من جديد عن آفاقه الرحبة. وبهذا المعنى سيجد اللاهوت مكانه كاملا في الجامعة وفي الحوار الرحب بين العلوم، ليس فقط بوصفه مادة تاريخية من مواد العلوم الإنسانية، بل وبالتحديد بوصفه لاهوتا، بوصفه بحثا في معقولية الاعتقاد الديني. حينذاك فقط سنكون قادرين على القيام بالحوار الحقيقي بين الثقافات والديانات، هذا الحوار الذي أصبح ضروريا لا يحتمل التأجيل”.
“لقد انتشرت في العالم الغربي، انتشارا واسعا، تلك الفكرة القائلة بأن العقل الوضعي والفلسفات التي تقوم عليه هما وحدهما يتوافران على المصداقية الكلية [“الكونية”]. أما الثقافات التي ما زالت دينية في عمقها فإنها ترى في هذا الاستبعاد لما هو لاهوتي من “كونية” العقل اعتداءً على أعمق معتقداتها. إن العقل الذي يصم آذانه إزاء ما هو إلهي والذي ينفي الدين في خانة الثقافات غير المتطورة هو عقل عاجز عن الدخول في حوار الثقافات. وفي الوقت نفسه، وكما أوضحت سابقا، فإن العقل العلمي الحديث بعناصره الأفلاطونية الثاوية فيه (=الرياضيات) يحمل معه سؤالا يشير إلى أبعد منه، إلى أبعد من إمكانيات مناهجه”.
“إن على العقل العلمي الحديث أن يقبل، بكل بساطة، كمعطى واقعي البنية العقلية للمادة، تماما كما أن عليه أن يقبل التناظر بين فكرنا وبين البنيات العقلانية (الرياضية) للطبيعة بوصفها معطى واقعيا تتأسس عليه منهجيته (=العلم). أما مسألة معرفة لماذا يجب أن يكون الأمر هكذا فهي مسألة ما تزال تستحق أن تطرح، ويجب أن تحيلها العلوم الطبيعية على أشكال أخرى من الفكر، على الفلسفة واللاهوت”.
“بالنسبة للفلسفة، والأمر هنا يختلف بالنسبة للاهوت، فإن الإنصات للتجارب والحدوس الكبرى التي تنبثق من ممارسة الشعائر في الديانات الإنسانية، ومن العقيدة المسيحية بصورة خاصة، مصدر من مصادر المعرفة، وتجاهل هذا المصدر هو حصر غير مقبول لقدرتنا على الإنصات وإيجاد الحلول”.
“هنا أتذكر ما قاله سقراط لفيدون (في محاورة أفلاطون). فبعد أن نوقشت في الحوارات الأولى عدة أفكار فلسفية خاطئة، قال سقراط: “إنه سيكون من السهل فهم كيف أن الواحد منا يمكن أن يبلغ به الغضب، بسبب هذه المفاهيم الخاطئة، درجة تجعله يقرر أن يظل فيما يبقى له من عمره كارها لكل خطاب حول الموجود وساخرا منه”. غير أنه بهذه الطريقة –يقول البابا- سيصير محروما من حقيقة الوجود فيعاني من خسارة كبيرة”.
“لقد تعرض الغرب للخطر طويلا بسبب إقصائه للمسائل الأساسية التي تقوم عليها عقلانيته وهو بهذا كان لابد أن يعاني من آلام عظيمة. إن الطموح الجريء الرامي إلى توسيع مجال العقل، بدل حصره في مجال ضيق، ذلك هو البرنامج الذي يجب أن يعتمده اللاهوت المبني على العقيدة الإنجيلية في حوارات عصرنا. “إن عدم استعمال العقل في التصرف، هو شيء ضد طبيعة الله” حسب الفهم المسيحي لله، كما قال مانويل الثاني في رده على مخاطبه الفارسي. فبهذا اللوغوس الكبير وبهذه الرحابة التي للعقل ندعو شركاءنا في حوار الثقافات. والسعي المتواصل في الكشف عنه هو المهمة الكبرى للجامعة”. انتهى. (ورد في أسفل النص الانجليزي والفرنسي الذين اعتمدناهما ما يلي: “يعتزم البابا عمل صياغة جديدة لهذا النص، مع هوامش. ولذلك ينبغي اعتبار هذا النص نصا مؤقتا”، غير أننا لم نسمع لحد الآن عن أية صياغة جديدة).
وبعد، فقد كان غرضنا في هذه السلسلة التي خصصناها لخطاب البابا إطلاع القارئ العربي على نص هذا الخطاب كاملا، وفي نفس الوقت إبداء الرأي فيما بدا لنا في فقراته من أمور نخالفه فيها، مفككين ومصححين. لقد اخترنا هذه الطريقة بدل اقتباس جملة من هنا وعبارة من هناك وعزلهما عن سياقهما ثم تركيب ردود عليهما وعلى الخطاب ككل. لقد فضلنا التعريف بالخطاب ككل حتى يفهم القارئ أفق تفكير صاحبه والهدف الذي أراده منه، والذي أجمل القول فيه في خاتمته التي أوردنا نصها أعلاه.
في هذه الخاتمة جانبان:
الأول هو مناقشة البابا للعقل الأوروبي كما هو الآن في مجال التقنية وكما تفهمه وتمارسه الفلسفات الوضعية، وهذا الجانب لا يهمنا، بل يمكن أن نقول إننا معه في نفس الخط، مع هذا الفارق وهو أنه قد سبق لنا أن انتقدنا في عدة مناسبات هذا العقل التقنوي تحت الاسم الذي يطلق عليه في الفكر النقدي الفلسفي المعاصر، اسم “العقل الأداتي”، منتصرين في المقابل لـ “العقل المعياري”. أما البابا فهو إذ ينتقد “العقل العلمي” جملة ينتصر للعقل اللاهوتي، وهذا ما يفرقنا في هذه المسألة. وقد نضيف أننا لو جاز لنا أن ننتصر لطرف معين داخل اللاهوت المسيحي لشددنا بحرارة على يد هارناك الذي يدعو إلى الرجوع إلى المسيحية كما جاء بها السيد المسيح عليه السلام، والتخلي عن القول بألوهيته وعن التثليث وعن الطقوس والشعائر التي لم يأت بها…
ذلك عن الجانب الأول في خاتمة خطاب البابا، أما الجانب الثاني فلا بد، للكشف عنه، من تفكيك الثلاثية الهيجيلية التي سُبك فيها.
فإذا نحن طبقنا فعلا العلاقة بين الأطروحة والتركيب (بين الإثبات ونفي النفي) كما حددها الفيلسوف هيجل وهي علاقة “التجاوز مع الاحتفاظ”، فإننا سنجد خاتمة الخطاب الذي نحن بصدده تحتفظ فعلا بجزء من الأطروحة وتستعيده في “التركيب”. والجزء الذي يُحتفظ به ويستعاد في التركيب ليس أي جزء من الأطروحة، بل الجزء الأساسي فيها، الجزء الذي من أجل الارتفاع به إلى مستوى التركيب وضع في الأطروحة. وإذا نحن فحصنا عن الجزء المستعاد من الأطروحة في خاتمة هذا الخطاب وجدناه مصرحا به بقلم البابا نفسه عندما قال: “إن عدم استعمال العقل في التصرف، هو شيء ضد طبيعة الله” . وقد بينا قبل أن المعنيَّ هنا هو الإسلام الذي سبق أن استهدفه البابا على لسان الإمبراطور بسؤال : “أرني إذن ما الذي جاء به محمد من جديد؟ إنك لن تجد غير أمور شريرة ولاإنسانية، مثل ما أمر به من استعمال السيف لنشر العقيدة التي جاء بها”.
هذا الجزء المستعاد في الخاتمة قد ارتفع به البابا على مستوى “التركيب” إلى الصيغة التالية، قال: “فبهذا اللوغوس الكبير وبهذه الرحابة التي للعقل ندعو شركاءنا في حوار الثقافات”. وقد حدد ما يعنيه بـ “رحابة العقل” بكونه “البرنامج الذي يجب أن يعتمده اللاهوت المبني على العقيدة الإنجيلية في حوارات عصرنا”.
باختصار نقول: إننا بتطبيق منهج هيجل، مواطن البابا، على خطاب الحبر الأكبر نخلص إلى النتيجة التالية: إن الإسلام يستعمل العنف في نشر عقيدته و”نحن” (المسيحية الكاثوليكية على عهدنا نحن البابا بينديكتوس) نؤمن، كما يؤمن الإمبراطور البيزنطي، بأن عدم صدورنا في أفعالنا عن العقل لهو سلوك مناف لطبيعة الله. والعقل المقصود هنا ليس أي عقل كان، بل “اللوغوس” الإغريقي كما “هذبه” النقد اللاهوتي المسيحي، ولذلك ندعوكم أيها المسلمون إلى تبني هذا العقل “الإغريقي اللاهوتي” في الحوار بيننا وبينكم، في إطار حوار الثقافات.
هل نرفض هذه الدعوة؟ لا، ولكن من حقنا أن نطلب من البابا أن يحررها، ويحرر تحليله كله، من قيود “المركزية الأوربية”. نحن نريد حوارا بين أنداد متكافئين، يعترفون ببعضهم بعضا، كمتفقين على أشياء ومختلفين في أشياء.
وحتى لا نبقى في المجال الذي قيد به البابا نفسه، أو لعله مقيد به بحكم المربى والانتماء والوظيفة، نقدم في خاتمة هذه المناقشة عناصر رؤية بديلة لرؤية البابا نخلص بعدها إلى مشروع برنامج لحوار مثمر، بعيد عن كل مركزية.
ما تجاهله الحبر الأعظم..!
كرر البابا في خطابه مرارا قولة الإمبراطور الروماني : “إن عدم التصرف وفق العقل شيء يتنافى مع طبيعة الله”، متهما الإسلام بعدم دعوة الإنسان إلى تحكيم العقل في أفعاله وتصرفاته.
ليس غرضنا هنا الرد عليه ببيان الموقف الإسلامي من العقل كما ينص عليه القرآن في عدد كبير من الآيات، ولا بلفت نظره إلى علم الكلام في الإسلام –وهو ما يوازي اللاهوت في المسيحية- الذي رأى فيه جميع المستشرقين مجالا للعقلانية الإسلامية التي ذهب بها المعتزلة إلى حد أن جعلوا من مبادئهم أن “العقل قبل ورود السمع”، وأن “الله لا يفعل إلا الصلاح”، و”أن الإنسان “يخلق أفعاله”، وهي مبادئ لا تنكرها المذاهب الكلامية الأخرى جملة وتفصيلا وإنما تختلف مع المعتزلة في الصيغ التعبيرية وبعض الفروض النظرية المتصلة بها، هذا فضلا عن اشتراط كثير من المتكلمين -ومنهم أشاعرة- في صحة إيمان البالغ الراشد اعتماده على الاستدلال العقلي لإثبات وجود الله، حتى يخرج من “التقليد” الذي احتج به مكذبو دعوات الأنبياء حينما قالوا “إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (الزخرف 22)، كما أننا لا نريد هنا إبراز موقف ابن رشد الذي قارن إيمان المسلمين المعتمد على العقل بالطبيب الذي يبرهن على معرفته بالطب بقدرته على إبراء المريض ونجاحه في ذلك، بينما شبه إيمان غير المسلمين القائم على المعجزات “الخارقة للعادة” بمن يدعي الطب بحجة أنه يستطيع المشي على الماء…
وليس غرضنا هنا بيان كيف أن اللوغوس اليوناني وبكيفية عامة الفلسفة والعلوم اليونانية إنما بعثت فيها الحياة وأعيد لها عقلها ومجدها في الحضارة العربية الإسلامية، وأن الفيلسوف الإغريقي الأكبر أرسطو لم يجد من يشرح خطابه ومقاصده، ويحرر فلسفته مما أُقحِم فيها من عناصر لا تنتمي إلى مذهبه وعقلانيته، إلا على يد ابن رشد الذي لقبه الأوربيون بـ “الشارح الأكبر”، اعترافا بتفوقه على الشراح السابقين كثامستيوس والإسكندر الإفروديسي الخ.
لن نتجه هذه الوجهة لأننا لا نريد أن ندخل بحوار الديانات والثقافات في سجالات نحن في غنى عنها اليوم. إن ما نريد أن نلفت النظر إليه هنا، بداية، هو بضع حقائق تاريخية كشف عنها الباحثون الأوربيون تخص الدور الذي قام به الموروث الثقافي العربي الإسلامي العقلاني في تأسيس عقلانية أوربا الحديثة ليس في مجال العلم والفلسفة فحسب بل في مجال الدين أيضا.
في هذا المجال يحدثنا المؤرخ الفرنسي المشهور جاك لوكوف Jacques Le Goff في كتابه الرائد “المثقفون في العصر الوسيط” (1948)، عن الظروف والآفاق التي تمت فيها أول ترجمة للقرآن إلى اللاتينية، والدور الذي كان لها في بدايات النهضة الأوربية في القرن الثاني عشر الميلادي، فيقول : إنه في إطار التداخل والاحتكاك بين الإسلام والمسيحية قام بطرس الجليل Pierre le vénérable (1092-1156)، رئيس دير كلوني، بجولة في الحدود الفرنسية مع الأندلس بين عامي 1141-1143 فتعرف هناك على الإسلام والمسلمين, وخلص من هذه الزيارة إلى النتيجة التالية: وهي أنه لا بد من نقل الصراع مع المسلمين إلى مجال الفكر أيضا. قال: “يجب أن نقاوم الإسلام لا في ساحة الحرب بل في الساحة الثقافية”. مؤكدا أنه: “لإبطال العقيدة الإسلامية يجب التعرف عليها… ذلك لأنه سواء وصفنا الضلال المحمدي -كذا- بالنعت المشين: بدعة, أو بالوصف الكريه: وثنية, فإنه لابد من العمل ضده, لا بد من الكتابة ضده”. (لوكوف ص 20 وما بعدها).
وتحدثنا مراجع أخرى أن بطرس الجليل هذا حصل على مساعدة من أسقف طليطلة المعروف Raymond de Tolède، مما مكنه من تشكيل لجنة لترجمة القرآن كان من أبرز أعضائها المدعو بيير الطليطلي الذي كان يجيد العربية وربما كان مسلما تنصر. وتضيف هذه المراجع أنه مع أن الترجمة التي أنجزتها هذه اللجنة كانت ناقصة تعتمد التلخيص، فإنها لقيت إقبالا كبيرا؛ كما ظهرت طبعات أخرى في ألمانيا وفي سويسرا نفسها ثم في فرنسا حيث نقلت هذه الترجمة بأسلوب مبسط من طرف أندري دي ريي André du Ryer سنة 1641 بعنوان “قرآن محمد”Alcoran de Mahomet، “وقد استقبلت بترحاب كبير لأن الجمهور كان يومئذ مهتما بالعالم الإسلامي أكثر مما يتصور عادة”. وتوالى اهتمام الناس في أوربا/النهضة بالقرآن إلى درجة أنه: “خلال قرن واحد من الزمان تتابعت في فرنسا وإنجلترا وهولندا خمس طبعات من هذه الترجمة الأولى بتعديل أو بدونه، وقد ظهرت الطبعة الأخيرة منها باللغة الفرنسية في أمستردام سنة 1770. وقبل ذلك كانت قد ظهرت في بادو Padoue، المدينة العلمية الإيطالية في ذلك الوقت، ترجمة جديدة للقرآن قام بها Marracci سنة 1698، ومعها كتاب في الرد على القرآن (انظر: ريجس بلاشير ترجمة القرآن ج1. 1947 -بالفرنسية).
كان الغرض الأصلي من ترجمة القرآن هو مقاومة الإسلام، كما ذكرنا، وفي هذا الغرض استعملها رجال الدين. غير أن عبارة هيجل “مكر التاريخ” تأبى إلا أن تحقق نفسها في هذا المجال أيضا. ذلك أن هذه الترجمات التي نقلت معاني القرآن إلى اللاتينية ثم إلى اللغات الأوربية الإقليمية قد وظفت أيضا ضد رجال الدين المندمجين في نظام الكهنوت فأصبحت عنصرا أساسية في الصراع ضد الكنيسة.
هكذا سارع “الإنسانيون”، Humanistes -وهم فئة ناشئة من المثقفين في القرن الرابع عشر كانوا يفكرون ويعملون خارج نظام الكنيسة وضدا عليها- سارعوا إلى توظيف ترجمات القرآن للاستعانة بها في تعزيز موقفهم ونشر ثقافة جديدة تعتبر الإنسان غاية في حد ذاته وتعلي من شأنه كفرد حر لا يحتاج في تعامله الديني، عقيدة وسلوكا، إلى وسيط آخر (الكنيسة). وقد واصل رجال النزعة الإنسانية في القرون التالية -أمثال لوكونت دي بولانفيي Le Comte de Boulainvilliers الذي ألف كتاب “حياة محمد” (1730)- امتداح الإسلام ضدا على الكاثوليكية الرسمية، منوهين بالإسلام وموقفه من الإنسان. كما تواصل الاهتمام بالقرآن وترجمته، فظهرت سنة 1734 ترجمة جديدة له في لندن قام بهاG. Sale ، فانتشرت بسرعة في عدة بلدان أوروبية، خصوصا وقد كانت مصحوبة بمدخل حول العرب وتاريخهم الشيء الذي اهتم به الجمهور اهتماما كبيرا كما اهتم بها رجال “الأنوار” أمثال فولتير، فكانت مصدرا لمعرفتهم بالإسلام.
لقد أثرت ترجمة معاني القرآن إلى اللاتينية واللغات الإقليمية في أوربا في ما حدث من تغيير في نظرة الثقافة الأوربية إلى الإنسان، مما كانت نتيجته قيام ذلك التيار الفكر المعروف بـ “الإنسانية” Humanisme. وقد عبر عن ذلك التأثير أحد أبرز مؤسسي هذه النزعة في أوربا، الإيطالي جيوفاني بيكو ديلا ميراندولا (1486) Giovanni Pico della Mirandola، الذي ألف كتابا بعنوان “في الكرامة الإنسانية” De dignitate hominis قال فيه : “لقد قرأت في كتب العرب أنه ليس ثمة في الكون شيء أكثر روعة من الإنسان”. (في القرآن آيات عديدة تفيد هذا المعنى: ” لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ” (التين )4، “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ” (الإسراء 70).
يقول لو جوف في كتابه المذكور : لقد كان هؤلاء المثقفون “الذين ظهروا في أوروبا القرن الثاني عشر، واعين بأنهم ينتمون إلى جيل ثقافي جديد, وكان معاصروهم يسمونهم بـ “المحدثين”. غير أنهم مع وعيهم الحداثي لم يكونوا يتنكرون لفضل القدماء, بل بالعكس كانوا يعلنون أنهم يقتدون بهم ويستفيدون منهم ويقفون على أكتافهم. يقول أحد هؤلاء : “لا يمكن الانتقال من ظلمات الجهل إلى نور العلم إلا بقراءة وإعادة قراءة كتب القدماء بشغف حي ومتزايد. فلتنبح الكلاب, ولتغمغم الخنازير, فإن ولائي للقدماء سيبقى قائما, وسأظل منصرفا إليهم بكل اهتمامي, وسيجدني الفجر كل يوم منهمكا في قراءة مؤلفاتهم”! والقدماء المعنيون هنا هم العرب ومن خلالهم اليونان. ويقول آخر (وهو المعلم برنار دي شارطر، نسبة إلى أحد أهم المراكز العلمية بفرنسا في القرنين الحادي عشر والثاني عشر(Ecole de Chartre): “نحن أقزام محمولون على أكتاف عمالقة, وإذا كنا نشاهد أكثر مما شاهدوا ونرى أبعد مما رأوا, فليس ذلك لأن بصرنا أحَدُّ أو لأن أجسامنا أطول, بل لأنهم يحملوننا على أكتافهم في الهواء ويرفعوننا بكل طول قاماتهم الهائل”.
ويحدثنا الأستاذ الجامعي وأبرز المترجمين الإنجليز من العربية أديلار أوف باث (1116–1142) Adelard of Bath عن مدى ثقة الناس بالثقافة العربية في عهده فيقول: “إن في جيلنا عيب متجذر فيه. إنه يرفض جميع ما يبدو أنه صادر من عند المحدثين. ولذلك, فعندما تكون لدي فكرة شخصية أريد نشرها بين الناس… فإني أقدمها لهم بصورة تجعلهم يعتقدون أنني استقيتها من دراساتي العربية. أنا لا أريد أن أكون مرفوضا إذا كان ما أقوله لا يروق للعقول المتخلفة, فانا أعرف المصير الذي ينتظر العلماء الحقيقيين بين السوقة من الناس, ولذلك تراني أدافع, لا عن قضيتي, بل عن قضية العرب” (نفس المصدر).
الموروث العربي الإسلامي كمرجعية للحداثة في أوروبا
(*)محمد عابد الجابري
أما أن تكون ترجمة أعمال ابن رشد إلى اللاتينية والعبرية، بعد نحو نصف قرن فقط من ترجمة معاني القرآن الكريم، هي الأساس الذي قام عليه في أوربا، ذلك التيار فكري الذي عرف بالرشدية اللاتينية والذي كان له الدور الكبير في تأسيس العقلانية الأوربية… فهذا ما لم يعد في حاجة إلى إثبات أو توضيح. إن الذي يستحق لفت النظر هنا، في السياق الذي نتحرك فيه، هو ما تعرض له أتباع هذه “الرشدية” وبالتالي “المثقفون الحداثيون” في أوربا النهضة من اضطهاد من الكنيسة وأجهزتها بسبب انتمائهم الرشدي.
لقد سجل المثقفون الجدد, الحداثيون في القرن الثاني عشر الميلادي, شكاواهم من الاختناق الذي كان يسود البلاد المسيحية بسبب اضطهاد رجال الكنيسة للمفكرين الأحرار مما جعلهم يفكرون في الرحيل إلى أرض العرب, حيث الحرية الفكرية مكفولة. يقول بيير ابيلار: Pierre Abelard ( مولود عام 1079) -الذي يصفه لوكوف بأنه أكبر مثقف حداثي من بين حداثيي القرن الثاني عشر- معبرا عما كان يعانيه هؤلاء المثقفون في أوربا من اضطهاد ومضايقات، يقول: “الله يعلم كم مرة فكرت, تحت ضغط يأس عميق, في الرحيل عن الأرض المسيحية والعبور نحو الوثنيين (=المسلمين-كذا) للعيش هناك في سلام, دافعا الجزية لأعيش مسيحيا بين أعداء المسيح”.
ولم يكن اضطهاد السلطات الكنسية لهؤلاء المثقفين الحداثيين لينال من رغبتهم في الانتماء المعرفي للعرب. فلقد كان الجيل الجديد لا يثق إلا فيما يأتي من العرب أو ينسب إليهم.
ويبرز آلان دي ليبيرا Alain de Libéra الذي صدر له في العقد الماضي كتاب بعنوان “التفكير في العصر الوسيط”, أهمية الدور الذي كان لما أسماه “التراث المنسي” في الغرب -يقصد التراث العربي المترجم إلى اللاتينية- في ظهور فئة “المثقفين” في أوروبا العصر الوسيط. وإذا كان دي ليبيرا يحذو حذو لوكوف فإنه يكمله ويحاول تجاوزه بإلقائه الضوء على دور “الفلاسفة” الذين تمكنوا من اختراق أسوار الجامعات والتحول إلى مثقفين «يخاطبون الجمهور” ويتكلمون في قضايا سياسية بخطاب فلسفي مستعار من العرب ومن ابن رشد خاصة. إنها “الرشدية اللاتينية” التي يبرزها دي ليبيرا كخطاب لـ “المثقفين الجدد” الذين هيمنوا على الحياة الثقافية في أوروبا خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر.
ويبرز دي لبيرا الأصل العربي لهذا الخطاب فيقول: “إن هذا الخطاب الفلسفي/الكلامي لم يولد من تلقاء نفسه, بل لقد تعلمه أصحابه واستضمروه واستوعبوه, انطلاقا من مصادر محددة معروفة هي ذلك التصور للحياة الفلسفية الذي صاغه فلاسفة بلاد الإسلام, الورثة الأوائل للفلسفة اليونانية في القرون الوسطى. إن اقتباس المثل الأعلى الفلسفي العربي مع مقدماته الكوسمولوجية والفلكية والسيكولوجية والأخلاقية قد ساعد على نشر الفلسفة خارج الجامعة (التي كانت تحت هيمنة رجال الدين). لقد تمكن النموذج العربي الإسلامي لـ “الفيلسوف” من أن يفرض نفسه على قسم من المجتمع المسيحي بواسطة فلاسفة جامعيين, لأنه نموذج تشكل في عالم بدون جامعات كنيسية رسمية، ولأنه أيضا نموذج يجعل الدراسة تتوج بالحكمة ويَعِدُ بالاستمتاع بتجربة ثقافية خالصة (=بلذة عقلية), عند آخر مراحل اكتساب المعرفة”
ولما كان المجال لا يتسع لتفصيل القول أكثر في دور العلم العربي في نشأة الحداثة الأوربية فسنقتصر على الإشارة إلى الطريقة التي وظف بها أولئك “المثقفون الجدد” نظرية ابن رشد في الفصل بين الدين والفلسفة. لقد عمد ابن رشد -بعد المشاكل التي أثارتها محاولة الفارابي وابن سينا لدمج الدين في الفلسفة والفلسفة في الدين, وهي المحاولة التي بدت للغزالي متهافتة فتصدى لنقضها وبيان بطلان نتائجها- عمد ابن رشد إذن إلى تصحيح الوضع فبين كيف أن الدين بناء مستقل بنفسه له أصوله الخاصة, وأن الفلسفة كذلك بناء مستقل بنفسه، لها هي الأخرى مقدماتها الخاصة, وأن التقاء البناءين وتآخيهما وتكاملهما أمور يجب أن تلتمس, لا في الأصول ولا في البنائين, بل في الغاية والهدف, من حيث أن كلا منهما إنما يرمي في نهاية المطاف إلى تحقيق الفضيلة.
هذا النوع من الفصل بين الدين والفلسفة تلقفه الرشديون اللاتينيون وقرؤوه على ضوء صراعهم مع الكنيسة فقالوا بـ “نظرية الحقيقتين” ونسبوها إلى ابن رشد: الحقيقة الدينية والحقيقة العقلية, وأنه يجب الأخذ بهما معا حتى ولو تعارضتا, وفي هذه الحالة يجب القول: هذه هي النتائج التي يقودني إليها عقلي باعتباري فيلسوفا, ولكن بما أن الله لا يمكن أن يكذب, فإني أسلم بالحقيقة التي كشفها لنا بالوحي وأتمسك بها بواسطة الإيمان”. وواضح أن هذا النوع من التوظيف لنظرية ابن رشد في علاقة الدين بالفلسفة –وهو ما لم يكن ليخطر بباله ولا ليوافق عليه- كان الهدف منه إثبات سلطة العقل مستقلة عن سلطة الكنيسة ونِدًّا لها, الشيء الذي يعني إعطاء الفلاسفة نفس الشرعية التي لرجال الدين. وهكذا يتحول الفصل الرشدي, العربي الإسلامي, بين الدين والفلسفة إلى فصل “رشدي لاتيني” بين الكنيسة والفلسفة, الشيء الذي مهد الطريق إلى المناداة بالفصل بين الكنيسة والدولة، إلى اللائكية. ومن هنا نفهم هجوم اللاهوتيين المسيحيين على ابن رشد، لقد رأوا في كتبه بما في ذلك تفاسيره على أرسطو أنه يهاجم عن قصد وبحدة مسائل الدين، هذا في حين أنه إنما كان يرد على الفلاسفة والمتكلمين الإسلاميين الذين وظفوا أرسطو في تأييد الفرقة الدينية التي ينتمون إليها (الأشعرية بصفة خاصة).
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو التالي: هل تأثر مارتان لوثر Martin Luther (1483-1546) زعيم حركة الإصلاح الديني في أوروبا بهذا “التراث المنسي”، والقرآن منه بصفة خاصة، وقد كانت ترجماته شائعة رائجة في عصره؟
أما أن يكون لوثر على علم بموقف القرآن وموقف فلاسفة الإسلام من الإنسان فهذا ما يصعب الشك فيه. إذ ليس من المعقول أن يكون لوثر في منأى عن تأثير الموروث العربي، الديني والفلسفي، الذي كان قد مضى على انتشاره في الأوساط المثقفة في أوروبا ما يزيد عن ثلاثة قرون. ومع أننا نفتقد إلى شهادة تاريخية تثبت ذلك فإن مضمون إصلاحه الديني الذي يبتعد فيه عن فكر الكنيسة يلتقي في جوانب كثيرة مع المنظور الإسلامي كما ينص عليه القرآن. لقد ركز لوثر دعوته الإصلاحية ضد سلطة الكنيسة وصكوك الغفران فنادى بأنه “يجب السماح للقساوسة بالزواج وأن الطلاق أمر شرعي” الخ. وهذه أمور من صميم شريعة الإسلام. إن تيار الإصلاح الديني الذي قاده لوثر، وإن لم ينتسب رسميا إلى القرآن والترجمات التي عملت له، فإنه لا بد أن يكون قد استوحى، بصورة أو أخرى، ما تميزت به العقيدة الإسلامية من إسقاط للخطيئة الأصلية بتوبة آدم، وبنفي كل وساطة بين الله والإنسان وتأكيده أن “الإيمان” هو وحده الرابطة التي تربط بين الله والمؤمنين، وأنه لا كهنوت في الإسلام الخ، وهذه هي الأعمدة الأساسية التي قام عليها الإصلاح الديني الذي تزعمه لوثر موجها سهامه إلى الكنيسة كنظم كهنوتي اجتماعي متسلط.
ومهما يكن، فإننا نرى أن من بين الموضوعات التي يجب أن تكون حقلا للتفكير في الحوار الأخوي بين الديانات مسألة الاتصال والانفصال بين المسيحية بمختلف فرقها والإسلام بمختلف مذاهبه. إن المطلوب ليس التفكير المجرد الذي توجهه العقيدة والمذهبية بل المطلوب هو الكشف عن أنواع التلاقي وعدم التلاقي التي عرفها تاريخ العلاقات بين الديانات الإبراهيمية الثلاث. إن إعادة كتابة تاريخ هذه العلاقات عملية ضرورية لإيجاد السبل لتحقيق المؤاخاة الحقيقية بينها. ذلك أن تاريخ هذه العلاقات كما تعرضه الكتب الدعوية (التبشيرية) الرائجة، الإسلامية منها والمسيحية واليهودية، تاريخ صراع، تهيمن عليه فكرة “الفرقة الناجية” التي وحدها تدخل الجنة، بينما باقي الفرق كافرة مصيرها جهنم!
ونحن عندما ندعو إلى إعادة كتابة تاريخ العلاقات بين الديانات الثلاث لا يقودنا مجرد افتراض أن يتم الكشف عما يثبت تأثر لوثر بالقرآن، وإن كان الافتراض في حد ذاته من الأبواب المؤدية إلى الحقيقة التاريخية، بل إننا نرى، فضلا عن ذلك، أن هناك مجالا أوسع يرقى إلى مستوى إبراز الوحدة المتحققة في الجذور. هذه الوحدة التي جب أن تكون الهدف المؤطر لكل حوار حقيقي بين الديانات السماوية الثلاثة.
الحوار بين الديانات: قيم ثقافة السلام
(*)محمد عابد الجابري
خصصنا المقالين الأخيرين للإهمال الذي لا مبرر له والذي خص به البابا بينيدكتوس السادس عشر، في خطابه الشهير (12-09-2006)، الموروث العربي الإسلامي بوصفه أهم مرجعية فكرية للنهضة والحداثة في أوربا. كان غرضنا إعادة الأمور إلى نصابها وإماطة اللثام عن جانب النقص الخطير –حتى لا نقول أكثر من ذلك- في التحليل الذي تبناه الحبر الأعظم والذي قصَر فيه “العقل والعقلانية” على ما دعاه: “التلاحم” الذي حدث بين اللوغوس الإغريقي والعقيدة الإنجيلية.
ورغبة منا في تجاوز عملية “تفكيك الأصول وتصحيح الفصول”، التي جعلناها إطارا عاما لتحركنا في هذه السلسلة من المقالات، واستجابة كذلك لدعوة البابا إلى ممارسة حوار الديانات في إطار “رحابة العقل”، نقترح هاهنا –كخاتمة- نوعا من “التناول” لحوار الديانات، كنا ساهمنا به في ندوة عقدتها اليونسكو بالرباط بتعاون مع الخارجية المغربية، يوم 16/02/1998، تحت عنوان “الحوار بين الأديان التوحيدية الثلاثة: نحو ثقافة السلام”، ندوة شارك فيها بعض كبار حاخامات اليهودية وشخصيات مسيحية رفيعة المستوى من الفاتيكان والقدس …
ومع أنه قد مر الآن على تلك المداخلة نحو عقد من الزمن، فإنها ما زالت في نظرنا تحافظ على قيمتها من حيث إنها تقدم نموذجا لما ينبغي أن يكون عليه حوار الديانات –موضوعا ومنهاجا- حتى يساهم في التخفيف من مشاكل عصرنا المنسوبة، كلا أو بعضا، إلى اختلاف الديانات وتعدد المذاهب والفرق في كل واحدة منها. سأستعيد هنا –في هذا المقال والذي يليه- نص المداخلة كما هي في الأصل بدون تعديل أو تغيير يذكر.
قلت مخاطبا المساهمين في الندوة : “سأنطلق في هذه المقاربة الأولية الهادفة إلى رسم معالم القيم المشتركة بين الأديان السماوية الثلاثة، والتي من شأنها أن تساهم في إرساء ثقافة السلام في عالمنا المعاصر الذي يواجه الإنسان فيه تحديات شتى، سأنطلق من قضية أصولية، قضية تنتمي إلى علم أصول الدين في الإسلام: علم التوحيد أو أصول العقيدة من جهة، وأصول الفقه من جهة أخرى.
تدور مسائل علم التوحيد في الإسلام حول ثلاث موضوعات رئيسية: ذات الله، وصفاته، وأفعاله. والمسألة الأساسية التي يدور حولها الكلام في الموضوعين الأولين هي التنزيه : تنزيه الله عن كل مشابهة مع أي شيء آخر، انطلاقا من قوله تعالى: “ليس كمثله شيء” (الشورى: 11). والتنزيه يقتضي الكمال المطلق، وبالتالي الاستغناء المطلق عن كل شيء. وعندما انتقل المتكلمون إلى الباب الثالث في علم التوحيد، وموضوعه أفعال الله، كان لابد أن يلاحظوا أن من جملة أفعال الله، إضافة إلى كونه خلَق العالم، أنه يبعث رسلا إلى الناس تدعوهم إلى عبادته. وفي هذا المجال طرحوا السؤال التالي:
لماذا يبعث الله الرسل إلى الناس ليطلب منهم عبادته وامتثال أوامره ونواهيه، وهو المنزه عن الحاجة إلى العبادة أو غيرها كما ورد في القرآن: “الله غني عن العالمين” (آل عمران: 97).
كان هناك من قال إن هذا سؤال غير مشروع، لأن الله يفعل ما يريد ولا يجوز أن يسأل لماذا يفعل كذا أو لا يفعل كذا، بمعنى أن أفعال الله لا تُعَلَّلُ بل يجب أن تؤخذ أوامرُه ونواهيه كما هي، وعلى الإنسان أن يمتثل وليس له أن يسأل عن القصد منها.
وفي مقابل هذا الرأي كان هناك رأي آخر يقول إن جميع أفعال الله هي لِحٍكْمَة، وهو منزه عن فعل شيء لا لحكمة ولا لغاية وقصد، لأنه سيكون فعله حينئذ من قبيل العبث. والله منزه عن العبث، “حكيم”، “لطيف بعباده”. ومن هنا قال أصحاب هذا الرأي إنه لابد أن يكون هناك وراء أفعال الله، وفي مقدمتها بعث الرسل، حِكمةٌ، أي قصد وغاية. وإذا تقرر هذا عاد السؤال السابق ليطرح بشكل مشروع هذه المرة كما يلي: ما هو مقصد الشرع، أو ماذا يريد الله، من وراء إرسال رسل للناس؟
وبما أن الأمر يتعلق برسل وأنبياء تعاقبوا منذ آدم، وليس برسول واحد، وبما أن الإسلام يدعو إلى الإيمان بجميع الرسل والأنبياء وفي مقدمتهم رسل وأنبياء الديانات السماوية الثلاث، فقد عمد علماء أصول الدين في الإسلام إلى التماس الجواب عن هذا السؤال، لا من الدين الإسلامي وحده بل من جميع الأديان السماوية. وهكذا قاموا باستقراء الغايات والأهداف والمقاصد التي تشترك فيها الأديان السماوية والتي تبرر بعثة الرسل، فوجدوها ترجع إلى مبدأ واحد، وهو أن جميع الديانات السماوية إنما تهدف من وراء مختلف تعاليمها، أوامرها ونواهيها، إلى شيء واحد، هو مصلحة الناس، مصلحة البشرية كلها. ومن هنا الجواب عن السؤال الذي طرحوه: لماذا بعث الله الرسل؟ هذا الجواب هو: بعثهم من أجل أن يبينوا للناس منافعهم في الدنيا والآخرة.
هذا الجواب يطرح سؤالا آخر هو الذي سينطلق بنا مباشرة إلى موضوعنا، نعني : إذا كانت الديانات السماوية إنما جاءت لتقرير مصالح الناس، فما هي المصالح التي تشترك الديانات السماوية في تقريرها والدعوة إلى الحفاظ عليها؟
قام علماء أصول الدين إذن باستقراء المصالح التي تشترك الأديان الثلاثة في تقريرها فوجدوها ثلاثة أصناف:
1 – مصالح ضرورية لوجود الإنسان المادي والمعنوي وسموها الضروريات: ضروريات الحياة.
2 – مصالح يحتاج إليها الإنسان لاستقامة حياته ماديا ومعنويا وسموها الحاجيات.
3 – مصالح ترتقي بحياة الإنسان نحو مزيد من السعة والفضل والتحلي بكل ما هو مفيد وحسن، وسموها التحسينات.
هناك فروق واختلافات بين الأديان الثلاثة في تقرير الحاجيات والتحسينات، ولكنها تتفق كلها في تقرير الضروريات، ولذلك سنركز عليها هنا.
وجد علماء الأصول أن الديانات الثلاث تتفق كلها حول ربط الغاية من بعثة الرسل، والمصالح التي تقررها شرائعهم، بالضروريات الخمس التالية: حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال، حفظ الدين. وجعلوا من هذه الضرورات الخمس أصلا للحاجيات والتحسينات والتكميلات.
***
أعتقد أن من جملة الموضوعات التي يمكن أن يهتم بها الحوار بين الديانات السماوية الثلاث، من أجل بناء تصور مشترك لثقافة السلام، موضوع الضرورات الخمس المذكورة. ذلك لأن هذه الضروريات، أعني حفظ النفس والعقل والنسل والمال والدين هي أساس كل سلام وبدونها لا يتحقق السلام، لا السلام مع النفس ولا السلام مع الجار ولا السلام بين الأمم. وفي هذا الصدد أرى أنه بالإمكان تأسيس رؤية جديدة سلمية وسليمة للمشاكل والتحديات التي يواجهها الضمير الديني والأخلاقي في عصرنا، وذلك بالارتكاز على هذه الضرورات الخمس. وفيما يلي أمثلة:
1 – ففي مجال حفظ النفس يمكن بناء تصور جديد لمفهوم “الحفظ” يستجيب لمتطلبات عصرنا. إن الأصل في مفهوم “حفظ النفس” هو كف الأذى عنها مهما كان نوعه، والإذاية التي تلحق النفس البشرية تمتد على مسافة واسعة، لا نهائية الصغر ولا نهائية الكبر معا : من الخبر المشؤوم والمنظر القبيح والكلمة غير الطيبة والتمييز بجميع أشكاله، العرقي والديني والاجتماعي والاقتصادي والحقوقي الخ… إلى التعذيب والقتل الفردي والإفناء الجماعي الخ… لقد شرع الله في الديانات الثلاث أن النفس بالنفس، ولكن ليس انتقاما ولا ثأرا، بل كبحا للميول العدوانية وردعا لها. فليس القصد الإلهي من “النفس بالنفس” أن القاتل يجب أن يقتل انتقاما أو ثأرا، بل إن القصد الإلهي أسمى من ذلك. إنه تنبيه للناس إلى أن الذي يقتل غيره أو يهم بقتله هو كمن يقتل نفسه أو يهم بقتلها. ولذلك قرر شرع الإسلام “وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ” (النساء: 92).
يدور الحديث اليوم حول “أسلحة الدمار الشامل”. ولكن ما هو “الدمار الشامل”؟ هل هو الذي تقوم به القنبلة الذرية وحدها كتلك التي ألقيت على هيروشيما ونكازاكي مثلا، أم أنه القتل الجماعي سواء كان بقنبلة تلقى باليد أو تطلق من الطائرة أو من الصواريخ الموجهة البعيدة المدى التي تطلق من البواخر الحربية، أو كان بالغاز أو بالجراثيم الخ… على أن “حفظ النفس” يجب أن يشمل، ليس فقط نفس الفرد البشري من القتل الذي من هذا النوع الفردي والجماعي، بل يجب أن يشمل في نظرنا توقيف العمل بعقوبة الإعدام، وهي عقوبة صار من الممكن الآن أداء القصد منها بالسجن المؤبد. فالسجن المؤبد لم يكن ممكنا في الأزمنة القديمة ولا في جميع المجتمعات، لأنه يتطلب وجود دولة تتصف بالاستمرارية في مؤسساتها وقوانينها مما يجعل من عقوبة السجن المؤبد حكما بالإعدام مؤجل التنفيذ إلى حين حلول الأجل المحتوم. ويجب أن يشمل مفهوم حفظ النفس ليس فقط نفس الفرد البشري الواحد، بل أيضا نفوس الجماعات والشعوب والأمم. ومن هنا ضرورة منع الأسلحة التي تؤدي إلى القتل الجماعي مهما كان مستواها ونوعها.
باختصار تقرر الديانات السماوية الثلاث أن “الله خلق الإنسان على صورته”. وحفظ النفس يجب أن يرقى إلى مستوى حفظ صورة الله، حفظها في الأفراد والجماعات والشعوب والأمم.
عرضنا في المقال السابق لما نعتقده موضوعا صالحا لحوار الديانات في الأفق الذي أنهى به البابا خطابه الشهير، أعني بذلك الحوار من أجل إعطاء مضمون معاصر للضرورات الخمس التي تتفق عليها الديانات السماوية الثلاث. وقد بدأنا بتحليل الضرورة الأولى وهي “حفظ النفس”، واليوم نتحدث عن الضرورات الأربع الباقية وفي مقدمتها “حفظ العقل”، فنقول:
2 – هذا النوع من الفهم لـ”حفظ النفس” (انظر المقال السابق يتطلب عقلا سليما، عقلا يعقل، يكبح ويحبس، الميول العدوانية في الناس مهما كان نوعها. ومن هنا ضرورة بناء فهم جديد لـ“حفظ العقل”.
العقل في أصل معناه هو القدرة التي تمكن الإنسان من التمييز بين الأشياء، بين الخير والشر، بين الحسن والقبح، بين الصواب والخطأ. وكلمة “عقل” في اللغة العربية، كما في لغات أخرى، تفيد الكبح والتقييد، وعندما يوصف بها الإنسان فالمعنى ينصرف إلى أنه قوة كابحة للميول العدوانية، مقيدة للشهوات الخ… بعبارة قصيرة العقل معيار يمكن الإنسان من التمييز بين الصواب والخطأ على صعيد المعرفة، وبين الخير والشر على صعيد الأخلاق، وبين الحسن والقبح على صعيد الفن والجمال.
ومن خلال التمييز بين الصدق والكذب أو الصواب والخطأ، وبين الخير والشر، وبين الحسن والقبح تبرز وظيفة أخرى للعقل تأتي في الحقيقة كنتيجة، وظيفة التمييز بين النافع وغير النافع، بين المفيد وغير المفيد، بين ما يؤدي إلى النجاح وبين ما ينتهي إلى غير نجاح. وهكذا فالنافع في الأصل هو المبني على الصواب والصحة والخير والحسن. وغير النافع هو المبني على عكس هذه. ذلك هو العقل المعياري، العقل كما يذكره الدين ويمجده وتتحدث عنه الأخلاق وتشيد به، وهو الذي كانت له القيمة الأسمى في العصور الماضية.
أما اليوم فنحن نشاهد العقل يتحول من معيار منطقي وأخلاقي إلى مجرد أداة حتى أصبح يوصف بالعقل الأداتي : مهمته تحقيق النجاح بدون اعتبار لأي شيء آخر، فأصبح النافع هو الحق وليس العكس. وبعبارة أخرى : العقل الأداتي هو العقل الذي يربط الحق والخير والحسن بالمنفعة والنجاح، شعاره : كل ما يحقق النجاح فهو حق وصواب وجميل. ومن الطبيعي أن ينساق هذا “العقل الأداتي” مع شعار “الغاية تبرر الوسيلة”.
حِِفظ العقل عملية يجب أن ترمي إلى إعادة الاعتبار للعقل المعياري الذي شعاره: الحق هو النافع وليس العكس.
الإنسان حيوان عاقل، بالعقل ينفصل عن الحيوان، ولكن في أي مجال؟ هل في مجال العمليات الحسابية الراقية وحدها التي يعجز الحيوان عن القيام بها، وقد أصبح الحاسوب يقوم بها؟ هل في المهارات اليدوية التي تبتدئ من الأكل باليد والفرشاة بدل تناول الطعام بالفم كما يفعل الحيوان؟ الروبوات تفعل ذلك وأكثر؟
3 – أعتقد أن أول واقعة سلوكية يتحقق بها انفصال الإنسان عن الحيوان هي الواقعة الطبيعية الأولى المعبر عنها بـ “حفظ النسل”. الإنسان وحده يميز بين أولاده وإخوته وآبائه وبين غيرهم. الإنسان وحده يقال عنه إنه ابن فلان. إذن يمكن القول الإنسان حيوان له نسب. أجل، على الإنسان وحده تصدق المفاهيم التالية “النسب” “الأرحام” “الوالدين” “الحفدة” الخ… والإنسان وحده يبني لنفسه “مدينة” فهو حيوان مدني، اجتماعي، سياسي. كل ذلك يدخل في مجال الضرورة الثالثة ضرورة “حفظ النسل”. ولكي ندرك أهمية هذه الضرورة في عالمنا المعاصر قد يكفي أن نتصور ما أصبح بإمكان التقدم العلمي القيام به في مجال البيولوجيا والطب. من أطفال الأنابيب إلى التدخل في الهندسة الوراثية إلى ما يعرف اليوم بالاستنساخ. ومنذ سنين ارتفعت أصوات بضرورة وضع أخلاقيات للبيولوجيا والطب، وأعتقد أن ضرورة “حفظ النسل” تتطلب فعلا وضع أخلاقيات في هذا المجال مجال حفظ النسل.
4 – حفظ المال. والمقصود: الخيرات المادية بمختلف أنواعها والتي هي ضرورية لحياة الإنسان. وحفظها يعني حمايتها من الضياع والتبذير والاحتكار وسوء الاستعمال الخ. لقد سنت الديانات السماوية قوانين لذلك بعضها على سبيل الأمر الملزم، وبعضها على سبيل الحث والندب والترغيب. ومعلوم أن الديانات السماوية تقرر أن المال مال الله، باعتبار أنه وحده خالق كل شيء ومالك كل شيء. وغني عن البيان القول إن الحث على التوزيع العادل للثروة أمر تشترك فيه الديانات السماوية، وقد شرعت لتطبيقه بأساليب متنوعة ومرنة بحيث يمكن تطبيقها في كل عصر حسب معطياته الخاصة.
وما يتحدى عصرنا اليوم، على صعيد المال والاقتصاد، هو هذه الظاهرة التي يكثر عنها الكلام الآن، ظاهرة العولمة. العولمة ظاهرة حضارية جديدة، وهي كجميع الظواهر الحضارية لها إيجابيات ولها سلبيات. وأخطر سلبياتها في نظرنا هو ذلك المبدأ الاقتصادي الذي تقوم عليه والذي يتلخص في الشعار التالي: “أكثر ما يمكن من الربح بأقل ما يمكن من العمال”. ومن هنا ظاهرتان خطيرتان: تسريح العمال وانتشار البطالة من جهة، وتشغيل الأطفال والنساء في الدول “النامية” بأقل أجر من جهة أخرى.
يمكن القول بصفة عامة إن اقتصاد العولمة يتجاهل الأخلاق إن لم يكن يتنكر لها. لقد ظهر ذلك واضحا في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد بسنغافورة في ديسمبر 1996، حيث رفضت معظم الوفود مناقشة قضية تشغيل 250 مليون طفل في العالم، أغلبهم بين السادسة والرابعة عشرة من أعمارهم. وقد انتهت المناقشات في هذا الموضوع بالمناداة بضرورة “الفصل بين التجارة والسوق، وبين معايير العمل والقيم الثقافية والاجتماعية”.
نحن إذن أمام تنكر صريح للجانب الأخلاقي وللتعاليم الدينية، في ميدان العولمة الاقتصادية. يجب إذن “حافظ المال” والاقتصاد من هذا الاتجاه الخطير الذي يكرس مبدأ المال من أجل المال. ومن هنا ضرورة التفكير في صياغة أخلاق للعولمة يطلب لها الإلزام من ثقافة السلام.
5 ـ حفظ الدين: وحفظ الدين من منظور ثقافة السلام يقتضي أولا وقبل كل شيء حفظ المنطلق الذي انطلقنا منه: أعني كون الديانات السماوية إنما تقصد إلى مصلحة الناس. ومن هنا يكون حفظ الدين معناه حفظ الضرورات الأربع السابقة: حفظ النفس والعقل والنسل والمال. وهكذا فإذا كنا قد وضعنا حفظ الدين في المرتبة الخامسة فمن أجل أن نجعل من الضرورات الأربع الأولى موضوعا له، وهل يهدف حفظ الدين إلى شيء آخر غير حفظ النفس والعقل والمال والنسل وما تفرع عن ذلك؟
ولكي يقوم الدين بوظيفته هذه يجب حفظه من داء الغلو والتطرف: التطرف في الدين يلغي وظيفة الدين التي هي حفظ المصالح ويجر إلى توظيفه في غير ما وضع له، بل إلى استعماله ضد النفس والعقل والنسل والمال.
تلك في نظرنا هي القيم الأساسية المشتركة بين الديانات السماوية الثلاثة والتي يمكن انطلاقا منها تشييد ثقافة للسلام، تضمن السلام للإنسان مع نفسه ومع نسله وجيرانه، وتضمن للشعوب والأمم السلام والعيش المشترك في إطار من التعاون والتضامن.
وأخيرا، دعوني أؤكد: ثقافة السلام هي، أولا وقبل كل شيء، ثقافة للسلام مع الله، وبالتالي فهي ثقافة للسلام مع خلقه، أفرادا وجماعات، ثقافة ضد التطرف سواء بدافع القوة الغاشمة، قوة السلاح وأساليب الهيمنة، أو باسم الدين، أعني ادعاء احتكار حقيقته.
وإذا كان لكل مقام مقال، كما يقال، فإن مقامنا هنا في هذه الأيام، وفي هذه القاعة التي رفعت فيه لافتة “ثقافة السلام”، يستحثني على استحضار اسم مدينتين تُلَقَّبان في اللغة العربية بلقب “السلام”.
أولاهما “مدينة السلام”، القدس مهد الديانات السماوية التوحيدية، التي يدعونا تاريخها ومستقبلها للعمل معا من أجل أن تصبح فعلا مدينة للسلام: لا تزهق فيها نفس، ولا تنتزع فيها أرض، ولا تشرد فيها عائلة، ولا يهجر عنها ساكن. إن ثقافة السلام في الديانات التوحيدية الثلاث يجب أن تنطلق من مدينة السلام: من توحيدها والاشتراك في إدارة شؤونها واحترام حق الجميع فيها.
ثاني المدينتين العربيتين اللتين تلقبان في الثقافة العربية بـ”السلام” هي “دار السلام”: بغداد التي تتعرض اليوم (1998) لتهديدات هي أبعد ما تكون من ثقافة السلام. فلنصل جميعا من أجل حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ الدين في “دار السلام”، و”مدينة السلام”.