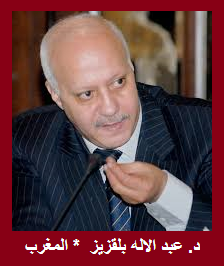إذا حكمنا على «الثورات» والانتفاضات انطلاقًا من المُعْلَنَات والملفوظات (من أهدافٍ صيغت في شعارات)؛ من قبيل الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية…، فلن يكون الحكم عليها في صالحها قطعًا؛ فليس كلّ ما يريدُ المرءُ يدركه،
لوجود الفجوة الموضوعية بين الرغبات وموارد القوة المتاحة لتحقيقها، بين الينبغيات والممكنات، أو – اختصاراً- لامتناع ميزان القوى المناسب. هذه واحدة، الثانية أن أهدافًا كبيرة، من حجم الديمقراطية والعدالة، لا تكفي الإرادةُ – والرغبة فيها- كي تتحقق، حتى وإن أسعفت موارد القوّة (وميزان القوى) بذلك، فهي – مثل سواها من الأهداف النهضوية الكبرى- تتوقف على تولُّدٍ تاريخي طويلٍ لشروطها التحتية؛ وليس في جوف البنى الاجتماعية والسياسية والتنموية والثقافية العربية، اليوم كما أمس، ما يُفْصِح عن علائمها ومؤشراتها.
وليس من مشمولات هذا النصّ الحديثُ في تلك الشروط التحتية، ولا مقدّماتها، ولكن من المناسب التشديد على أنها لا تتحقق دفعةً واحدةً، ونهائيًا، بضربةِ ساحر، وإنما تنمو ببطءٍ في النسيج المجتمعي الشامل، وعلى نحوٍ من التوازن، والاعتماد المتبادل، بين مجالات نموّها تلك.
ولقد يكون مفيداً أن تُلْحَظ ظاهرةٌ جديرةٌ بالانتباه، في مجرى الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، في العالم كله وفي بلادنا العربية خاصة، هي ظاهرة الفجوة الكبيرة بين المُعْلَنَات (الشعارات) وموارد القوّة لتحقيقها، بين التوقعات والنتائج المنجَزَة والمتحصّلة. هذه فجوة طبيعية في تجربة أيّ حركة اجتماعية، وقلّما نجحت حركةٌ في جسْرها إلاّ إذا كانت قد صمَّمت مطالبها، منذ البداية، على مقتضى الممكن (وذلك ما يمكن أن ينطبق، جزئيًا على تجربة الحركة الاجتماعية في المغرب وسلطنة عُمان: المطالِبة بإصلاحات داخل النظام) هي فجوة طبيعية كالفجوة التي يمكن أن تنشأ في التفاوض، مثلاً، بين أهداف عليا يطلُبُها المفاوِض من خصمه و(بين) نتائج دونَها: بكثير أو قليل، يُسْفِر عنها التفاوض. والحقّ أن الاحتجاج، عن طريق الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر أو الانتفاض، هو – بمعنى ما- تفاوُضٌ بوسائل أخرى مع القوّة المحتَجّ عليها (السلطة، النخبة الحاكمة…). وفي مثل هذا «التفاوض» في الغرف المغلقة أو في الساحات العامة – لا يُكْتَب النجاح، عادةً، إلاّ للمطالب الواقعية، أي لتلك التي يتحمّلها واقعُ التوازن في القوى بين أطراف الصراع؛ فكما يحكُم نتائجَ أيّ تفاوضٍ ميزانُ القوى، كذلك أيُّ صراع في الشارع محكوم بميزان القوى.
على أنه كلّما أمكن إدراكُ الحقيقة الموضوعية لتلك الفجوة مبكِّرًا، وصِيرَ – في الأثناء- إلى ترجمة ذلك الإدراك تكييفًا للشعارات والمطالب وتعديلاً لها، وربّما إعادةَ مَرْحَلَةٍ أو جدولةٍ لها: من الأدنى إلى الأعلى (عملاً بقاعدة: «خُذ وطالب»)، أمكن – بالتّبِعة- إنقاذ الحركة الاجتماعية من تناقضاتها الذاتية، ومن إنقاذها، وإنقاذ المجتمع معها، من النتائج الكارثية التي يمكن أن تؤول إليها الخيارات القصووية أو المتطرفة، والنتائج النفسية القاسية التي قد يولّدها الفشل في تحقيق الأهداف، ومنها الخيبة والحُبوط واليأس… الخ. ولكنّ مثل هذا الإدراك يفترض وجود قيادة منظمة للحركة الاجتماعية تُحْكِم الإمساك بأزمَّة الحراك النضالي، وبوسائل توجيه نحو أهداف محدَّدة، وتمتلك الوسائط التنظيمية الكافية لربط فعاليات الحركة الاجتماعية بتلك الأهداف. وإذا كان وجود مثل تلك القيادة المنظمة، في تجارب احتجاجية عدّة في العالم، ما يفسّر نجاح تلك التجارب في بلوغ أهداف التغيير – ومجتمعات أوروبا الشرقية آخر الأمثلة- فإنّ غيابها، كما في حال تجارب «الربيع العربي»، هو ما يفسر أيلولتها إلى الإخفاق أو التعثر.
علينا، في هذه المسألة بالذات، أن نعترف بحقيقتين متلازمتين: أن الحركات الشبابية الاحتجاجية لم تكن مسؤولة – مسؤولية مباشرة- عن قصووية مطالبها وشعاراتها، وبالتالي، عن سعة الفجوة بين تلك المطالب، وما اقترن بها من كبير توقعات، وأن القيادات السياسية الحزبية المنظمة – وقد انضمت إلى الحراك بعد انطلاق موجاته- لم تخطئ فقط في عدم نهوضها بمهمة التقليص من تلك الفجوة، وإنما أخطأت، أيضًا، في تعميقها وتوسيعها إيّاها من طريق ركوبها الشعارات عينِها! فأما عدم مسؤولية الحركات الشبابية فمأتاها من حداثة عهدها بالعمل العام والسياسي، وضَعف خبرتها في التنظيم الاجتماعي، فضلاً عما يقترن بفئاتها العمرية من منازع رومانسية ثورية (طبيعية للغاية)، على الرغم ممّا كان في إمكانها من ترشيد عملها أكثر في مواجهة ما كان يتولّد، في غضون الحراك، من فوضى وتعدُّدٍ في الخيارات. وأمّا مسؤولية القيادات الحزبية فمتعددة؛ فإلى أنها تحتاز خبرةً عريقة في العمل التنظيمي والعمل العام المنظّم، لم تُبْد ميْلاً نحو أي مبادرة قيادية – ما خلا جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر- بل (وهذا هو الأنكى) انساقت مع الجموع وراء مطالب تعرف، سلفًا، أنها صعبة التحقيق، وتصرفت معها على نحوٍ انتهازي. ففيما كان الشباب يهتف «الشعب يريد إسقاط النظام»، وهو يقصد من أجل بناء نظامٍ ديمقراطي، كانت الأحزاب تبغي رحيل النظام فحسب وهي تعلم أن النظام الديمقراطي ليس على الأبواب، فيما انفرد «الإخوان»، ونظراؤهم في الحركات الإسلامية، بإيهام الجميع أن الديمقراطية تساوي نتائج صناديق الاقتراع. هكذا زادتِ الفجوةُ اتساعًا بين انتظارات الناس والنتائج الهزيلة التي تمخضت عنها التضحيات الجِسام!
سيكون من باب إنكار الحقائق حسبان وقائع مثل سقوط نظام حسني مبارك في مصر، ونظام زين العابدين بن علي في تونس، ونظام العقيد معمّر القذافي في ليبيا، وإزاحة علي عبد الله صالح من السلطة في اليمن، وقائع عادية في يوميات السياسة والحياة العامّة و، بالتالي، لا تنطوي على أيّ وجهٍ من وجوه التغيير في المشهد السياسي.
ونحن لا نمنع أنفسنا، في هذا المعرض، من إبداء الاعتقاد بأنّ أنظمةَ ومعارضات بلدان «الربيع العربي» الأخرى دفعت جميعُها – وعلى تفاوُتٍ في الأنصبة- ثمن الافتقار إلى تينك الواقعية والحكمة التي ميّزت قوى النظام والمعارضة في المغرب وعُمان، فوفّرتْ على الأولى (قوى النظام) ركوب رأسها، ووفّرت على الثانية ركوب المطالب القصووية. ولا يحسبنّ أحدٌ أن المكتسبات المحصّلة من تواضُع المطالب وواقعيتها في المغرب وعُمان مكتسباتٍ «هزيلةً» (وكأنها لا تكون جزيلةً إلاّ بسقوط النظام: من دون التدبُّر في سؤال: وماذا بعد سقوطه؟!)، ذلك أنّ ما قدّمه النظام في المغرب – مثلاً- من تنازلات سياسية في موضوع توزيع السلطة، في بحر شهور معدودات (مارس/ يوليو 2011)، تعادل – بل تفوق- مجموع التنازلات التي قدّمها للمعارضة خلال أربعين عامًا.
*عن “اكسير “
نشر بها 31 يناير 2016