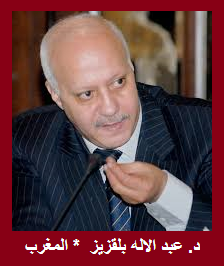هل بقيَ، ثمة، من مستقبلٍ ممكن للتغيير في الوطن العربي بعد هذه التجربة المرة من المعاناة والدماء. التي أسفرت عنها حقبة «الربيع العربي»؟
هل في نهاية هذا الأفق الكالح والمديد ضوءٌ يفتح الطريق إلى المستقبل، ويُنْصِف التضحيات الجسيمةَ التي قدمتها المجتمعات العربية وحركاتها الاجتماعية طوال هذه الحقبة المزدحمة بالملاحم والدماء والآمال والخيبات؟ وإن كان، هناك، من مستقبلٍ للتغيير، فما السبيل إليه، وما المداخل إليه؟
سؤال مشروع جداً، ليس فقط لأن نتائج التغيير، الذي حصلت وجوه منه في بعض البلاد العربية، أتت دون نسبة التوقعات والانتظارات العمومية، وإنما لأن سقف المطالب والطموحات – أيضاً – انخفض إلى حدود ما قبل «الثورات» نفسها، حيث تواضعت -أو تكاد أن تتواضع- إلى مطلبٍ واحدٍ وحيد هو: عودة الأمن والاستقرار ومعهما عودة الدولة إلى الوجود بعد غيابٍ أو انكفاء! ولكنه مشروع، أيضاً، من زاوية ملاحظة درجات النضج النسبي في الوعي السياسي لدى قطاعات اجتماعية عدة، في المجتمعات العربية، ودرجات التقدم الحاصل في الحركات الاجتماعية وخبراتها الحركية في الميدانين المطلبي والتعبوي، فضلاً عما باتت تُفصح عنه من جرأةٍ في المواقف، وفي التعبير عنها. وأخيراً، هو سؤال مشروع لأن وطأة الأوضاع الاجتماعية والسياسية، في الأعم الأغلب من البلاد العربية، لم تعُد تُطاق، وأن اشتداد تلك الوطأة يُنذر بانفجارات اجتماعية كبيرة يُخْشى من ألا يكون استيعابُها واحتواؤُها من مستطاعات أحدٍ: إن لم تنجح النخب الحاكمة في تدارُك الأمر، بسياسات عاقلة تتجاوب مع المطالب (الاجتماعية-السياسية)، وإنْ لم تنجح القوى والحركات الفاعلة في تأطير جموع الناقمين على تلك الأوضاع، وصوْغ أفقٍ برنامجي لها يجنبُ مجتمعاتنا الفوضى ومغامرات العنف.
ننطلق، في رؤيتنا مستقبل التغيير، من الاعتقاد أن أحداث ما يسمى «الربيع العربي» لم تُغْلِق ملفّ التغيير، بما أثمرتْه – إيجاباً أو سلباً- من نتائج سياسية، وإنما هي فتحتْه على مصراعيْه، وحولتْه إلى مسألةٍ عمومية في البلاد العربية كافة، وإن على درجات مختلفة ومتفاوتة من الشروط الموضوعية والاستعدادات الذاتية في كل بلد عربي.
إن الحصيلة المرة لأحداث «الربيع العربي» – في نطاقها الإجمالي – لا يمكن أن يُراهَن عليها كي تصير عائقاً كابحاً لأي تغيير، ولأي تفكير في التغيير، على الرغم من كل فداحاتها. قد يكون ذلك ممكناً بالنسبة إلى قوى أحبطتها تجربة التغيير ومآلاتُها الدراماتيكية، ولكنها- قطعاً – لن تمنع مَن وجدوا فرصة في «الربيع العربي»، وفوضاهُ المسلحة، للتمدد والتقوى من أن يستأنفوا ما بدأ من موجات، منذ أعوامٍ خمسة، فينقلونه من ساحة لأخرى.
التغيير قادم لا محالة؛ فهذه سنة التاريخ أولاً، وهذه علامات المرحلة ثانياً، ولكن: في أيّ اتجاه؟ وكيف يمكن أن يحدث من دون خسائر كبيرة تلحق الدولة والمجتمع والوحدة الوطنية منه؟ وكيف ينبغي الإعداد له من قِبَل جميع مَن يستشعرون المسؤولية من مصير مجتمعاتهم ودولهم؟ وما السبل إلى الإمساك بخيوطه والتحكم فيه لتوجيهه الوجهة الإيجابية المنتجة؟ هذا هو السؤال الذي يُفْتَرض أن يصبحَ موضع تفكيرٍ عميقٍ وهادئ من قبل القوى العاقلة والمسؤولة في المجتمعات العربية. ومن نافلة القول إن المعنيين بالتفكير في هذا السؤال (هذه الأسئلة) كُثرٌ: من المثقفين والباحثين الأكاديميين – في ميادين العلوم الاجتماعية – إلى السياسيين والحزبيين ورجال الدولة، من المعارضة والسلطة على السواء، إلى الفاعلين في الميدان النقابي والمنظمات الشعبية، إلى الناشطين في جمعيات المجتمع المدني ومؤسساته…الخ. وقد لا يكون الجواب المناسب عن تلك الأسئلة عند فريقٍ واحدٍ من هؤلاء حصراً، بل قد تكون عناصرُه موزعة بين هؤلاء وأؤلئك بحيث تحتاج إلى تأليفٍ وتجميع إنْ قر العزم على تحقيقٍ تحولٍ متوافَقٍ عليه، وإلا كان في وُسع الفاعلين، من هذا الموقع ومن ذاك، أن يعتمدوا الجواب ذاك مستحضرين غيرهم، ومصالحَ غيرهم، ممن قد يكونون شركاء لهم – غيرَ معلنين- في تحقيق ذلك التحول.
لسنا، هنا، بصدد رسم برنامج للتغيير، لا نزعُم ذلك، ولا هو من مهماتنا ومشمولات عملنا؛ فالبرنامج من صميم عمل المؤسسات السياسية – المعارِضة والرسمية – لا مما يُنْتَظَر من المثقفين. ولكنا- من موقع النظر كما من موقع الالتزام الوطني والديمقراطي- نملك أن ننبه إلى أشياء، وأن ننبّه على أشياء أخرى في الوقت عينه. والهاجس الحاكم، هنا، هو: كيف يمكن لأي تغييرٍ قادم أن يتحاشى الوقوع في أخطاء ارتُكبت أثناء أحداث «الربيع العربي»، وأن يستفيد من دروس التجربة الماضية الاستفادةَ الضرورية من أجل تجنيب مجتمعاتنا – ودولنا- العربية الهزات الدراماتيكية والمساراتِ الدموية والتفكيكيةَ التي شهدتْها في الأعوام الماضية.
في سبيل ذلك كله، لا مهْرب من التشديد على المبادئ والمنطلقات التالية:
أ- إن أي عملية تغيير، خاصة إذا كان هدفها البناء الديمقراطي، لا يمكن أن تكون إلا بالوسائل السلمية المدنية. هذه وحدها تؤمن حولها إجماع الشعب، وتُحيطُها بحزام الأمان المجتمعي. وأي جنوح للعنف – حتى بدعوى الدفاع عن النفس في مواجهة عنف السلطة – سيحْرف التغيير عن مساره وهدفيته، ويُفقدُهُ نصابَه الشعبي، ويُدخلُه في متاهة المواجهات المدمرة المفتوحة على الاحتمالات كافة: بما فيها احتمال الفتنة والحرب الأهلية: في مجتمعات (عربية) يتميز نسيجُها المجتمعي بالهشاشة والنقص الحاد في الاندماج الاجتماعي. لا يُحْمَل السلاح إلا في وجه المحتل الأجنبي، أما في الداخل فهو – قطعاً- سلاح الفتنة والحرب الأهلية. ومَن يحمله في الداخل، لا ينخرط في التغيير بل في التدمير. وهذا – من أسفٍ شديد – ما وقعت فيه حركاتٌ معارِضة عدة في تجربة «الربيع العربي»، فكان له الأثرُ السلبي البالغ في إجهاض الحَرَاك الاجتماعي المدني.
ب- أي تغييرٍ يحتاج إلى رؤية تسترشد بها قواهُ الاجتماعية، وتشْتَق منها برنامج عمل. ومثل هذه الرؤية يمكن اشتقاقُها من إنتاجات المفكرين والباحثين، في شؤون الاقتصاد والاجتماع والسياسة (ممن تُهمِل السياسةُ – عادةً – إنتاجاتهم)، كما يمكن اشتقاقُها من المصادر الفكرية التي يعتمدها العمل السياسي ويبني عليها. غير أن الأهم من هذا المسلك ومن ذاك أن يُصار إلى بناء مثل تلك الرؤية على أساس حوارٍ عميق، بين القوى كافة، في المسائل العامة (نظام الحكم، التنمية، الديمقراطية، توزيع الثروة…) تتولد منه تفاهمات، بل توافقات، على خيارات مشتركة وجامعة. كلما نتجتِ الرؤيةُ من تفاهُمٍ مشترَكٍ عريض، أو متسِع النطاق، أتت مستجيبَة لطلبٍ اجتماعي عام و، بالتالي، حظِيت بالتفافٍ اجتماعي أوسع حولها. وحينها ستكون شعارات التغيير وأهدافُه واضحةً في الأذهان، أو -على الأقل – ستتقلص مساحةُ الالتباس وتنازُع الخيارات. وفي الأحوال جميعِها، لا تغيير يمكن من دون رؤية سياسية إليه. ولا نضيف شيئاً حين نقول إن من بين أسباب إخفاق معظم حركات «الربع العربي» غياب، أو انعدام، مثل تلك الرؤية السياسية.
ج- كل تغييرٍ يفترض، حكمًا، قدرًا من التنظيم والقيادة للحركة الاجتماعية (الاحتجاجية، المطلبية، السياسية) التي تقوم به. العفويةُ ليست امتيازاً هنا، كما قد يُظَن، ولا مَبْعَثَ يفاخُر؛ فهي ليست رديفاً لاستقلالية الحركة الاجتماعية عن قوًى سياسية منظمة مطعونٍ في تمثيلها: على نحو ما يحلو لكثيرين أن يعرفوها، العفوية رديفٌ للفوضى، وتعبيرٌ عن نقصٍ حاد في التنظيم وفي العقلانية الاجتماعية. إن التنظيم عقلُ المجتمع ومبدأُ تماسُك أي حركةٍ اجتماعية، وفي غيابه – أو انعدامه – سببٌ لانفراط تلك الحركة. والتغيير مهما كان عفوياً، لا تَقْوى على الإمساك به والتحكم في مجرياته سوى القوى المنظمة من أحزاب وجماعات سياسية أو ميليشيات(؟) (ماذا حصل في أحداث «الربيع العربي» غير هذا؟). لا بد من نقد ظاهرة تقديس العفوية، لأن ذلك التقديس يعادل إسقاط إمكانية التغيير، ولأنه رديفٌ لتقديس الفوضى، ولا بد – في المقابل – من ضرورة انتباه الحركات الاجتماعية المطلبية لضرورة تنظيم صفوفها، وإنتاج قيادات لها، حتى يكون في وسعها الوصول إلى تحقيق أهدافها أو بعض من أهدافها. يمكن لحَرَاكٍ اجتماعي أن يبدأ عفوياً- وهو غالباً ما يبدأ كذلك – لكنه لن يبلغ أي هدفٍ بعفويته إن لم يتداركها بتنظيم نفسه.
د- يحتاج كل فعلٍ للتغيير إلى أن يُقلص من دائرة خصومه، وأن يقلل من الجبهات التي يمكن أن يخوض فيها. ولا يملك أن يفعل ذلك إلا من طريق تحييدهِ مَن لا مصلحة له في مواجهته اقتصاداً للقوى، وتجنباً للوقوع في معارك تستنزفه. وأول ما عليه تحييدُه أجهزةُ الدولة ومؤسساتها، من جيشٍ، وقضاء، وحتى أجهزة الأمن إنْ أمكن. نجح، في ذلك، التونسيون والمصريون – نسبياً- فوفّروا الكثير على أنفسهم، لكن غيرهم لم ينجح، فدَفَع كلفةً ثقيلة، ودفع المجتمع والوطن أضعافَ أضعافها!
*عن موقع “اكسير”
الاربعاء 27 يناير 2016