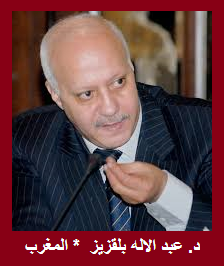ليس من دولةٍ في العالم تَقْبل بالتفاوض مع جماعات إرهابية أو مسلّحة تحمل السلاح في وجهها. التفاوض معها تسليمٌ بشرعيتها وبحقّها في ممارسة التمرد بالقتل والذبح، والسطو على ممتلكات الدولة والشعب!
والتفاوض معها طعنٌ في شرعية الدولة نفسِها، وتسليمٌ من الأخيرة بأنها ليست الكيان السياسي للشعب، وإنما مجرّد فريقٍ سياسي وميليشياوي في جملةِ فرقاء آخرين تتساوى حقوقُه مع حقوق المتمردين عليه، وتتكافأُ حظوظ شرعيته مع حظوظ شرعية الآخرين!
لا يمكن لدولةٍ تحترم نفسها، مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين، أن تفعل ذلك وإلاّ غامرت بإسقاط شرعيتها.
الحالة الوحيدة التي قد تتفاوض فيها دولةٌ مع جماعة مسلّحة، هي الحالة التي تكون فيها تلك الجماعةُ المسلّحة حركةً قومية انفصالية تطالب بالاستقلال؛ حينها تتفاوض الدولة – باسم الشعب والأمّة- لمعالجة موضوع العلاقة بين الجماعة الوطنية (القومية) الكبرى والجماعات القومية الصغرى أو الفرعية، إما بغية ثنيها عن فكرة الانفصال من طريق تقديم التنازلات الضرورية التي تُطَمْئِنها على حقوقها الخاصة (مثل توسيع نظام اللامركزية أو تطوير نظامٍ اتحادي فيدرالي)، وإمّا من طريق تنظيم استفتاء تقرير المصير. فعلت ذلك بريطانيا مع إيرلندا و«الجيش الجمهوري الإيرلندي»، ومع اسكتلندا، مثلما فعلت ذلك إسبانيا مع منظمة «إيتا».هذه الحالة لا تشبه غيرها من حالات التمرّد المسلّح، التي شهدتها المجتمعات الغربية في النصف الثاني من القرن العشرين، وهزّت استقرارها الأمني والسياسي؛ فحين نشأت ظاهرة «الإرهاب الثوري» وانتشرت في الغرب، انتشار النار في الهشيم، سنوات الستينات والسبعينات من القرن المنصرم، لم تُفاوِضِ الدولةُ الإيطالية – بشيوعييها ومسيحييها الديمقراطيين المتناوبين على السلطة فيها- منظمة «الألوية الحمراء» المسلحة التي أرهقتها بضرباتها الأمنية، ولم تُفاوِض ألمانيا الغربية منظمة «بادر- ماينهوف» الثورية، ولا فاوضت فرنسا منظمة «العمل المباشر» كما لم تقبل الدولة اليابانية مفاوضَةَ «الجيش الأحمر الياباني». وهذا عينُه ما حصل في بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية («فرابوندو مارتي»، «الضوء المضيء»…) وآسيا «جبهة مورو»… وأوراسيا (الحركات المسلّحة في الشيشان…). أما رفض التفاوض مع تلك المنظمات المسلّحة فمأتاهُ من أن مفاوضتها تُكرِّس في السياسة عُرفًا مناقضًا للقانون ولمنطق الدولة، هو الاعتراف بحق أيّ جماعة معارضة بممارسة الاعتراض عبر السلاح، والتمرّد المسلّح على الدولة. وفي هذا إنهاءٌ للسلم المدني والاستقرار، بل إنهاء للسياسة!
ولا يتعلق الأمرُ في رفض التفاوض مع الجماعات المسلَّحة – الإرهابية خاصةً- تلك التي تقع في الدائرة الوطنية؛ أي بتلك التي يُصنّفها الخطاب السياسي الرسمي بالجماعات المسلحة المتمردة على الدولة والمجتمع، بل يتعلق بالمنظمات المسلّحة، والإرهابية، العابرة للحدود، والمتخذةِ شكلَ شبكات تنظيمية مسلّحة دولية. فهذه، أيضًا، ترفض الدول – غربية وغير غربية- مفاوضَتَها: حتى على رهائنها المختطفين من قِبلها، لأن في التفاوض معها اعترافًا بها، وتسليمًا بشرعية أسلوبها في العمل. لو أخذنا تنظيم «القاعدة» مثالاً لهذه المنظمات، لوضعنا في حوزتنا فائضًا من الأدلة على ما ذهبنا إليه. ضربت منظمة «القاعدة» مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في نيروبي ودار السلام والخُبَر، ثم ضربت قلب أمريكا (نيويورك، واشنطن)، وأخيرًا في اليمن والعراق بعد غزوه واحتلاله. وضربت في قلب بريطانيا وإسبانيا، ثم في السعودية واليمن والمغرب العربي «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، والصومال ومالي… الخ. لكنّ أيًّا من الدول، التي أصاب مصالحها ورعاياها ما أصابها من ضربات «القاعدة»، لم تَقْبل بالتفاوض مع «القاعدة»، أو بعقد هدنة معها، أو دفع ديّة، أو ما شاكل ذلك، وكان الجواب الأمني ردًّا على عملياتها يترافق مع تبريرٍ سياسي لم يفتأ يردّده الجميع: لا تفاوُضَ مع الإرهاب، أو لا يمكن مكافأة الإرهاب على جرائمه بالتنازل له.
وما أغنانا عن القول إن هذا الإجماع الدولي، الذي انعقد على فكرة تجريم الإرهاب، ومكافحته بالوسائل كافة، وعدم مفاوضة قواه وتنظيماته أو التنازل لها، أو الاعتراف بشرعية وجودها… تَرجَم نفسَه في نظام العلاقات الدولية في سلسلة من القوانين التي تجرّم الإرهاب، وفي سلسلة من القرارات التي تقضي بوجوب تجفيف منابعه المالية والثقافية والإعلامية، ومنع الدول الداعمة له من توفير ملاذات له، أو تقديم العون المادي واللوجيستي لقواه. ولقد أصبحت هذه القوانين والقرارات، بقوةِ الأشياء وبمرجعية القانون الدولي وحاكميته، ملزِمةً لدول العالم كافة، ومدعاةً لتكييف الدول تلك قوانينَها الوطنية بحيث تتلاءَم منظوماتُها التشريعية والقانونية مع أحكام تلك القوانين والقرارات. ولم يكن مستغرباً أن يلجأ عددٌ كبير من دول العالم إلى إصدار قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب في ضوء القوانين والقرارات الدولية تلك، وانسجامًا مع أحكامها؛ ليس من باب الوفاء لالتزاماتها تجاه القانون الدولي، والمنظمة التي أصدرته فحسب، بل من باب الحاجة إلى قوانين من هذا الجنس تحميها وتحمي المجتمع والمواطنين من غائلة هذا الوحش الضاري.
وإذا كان من المشروع، تماماً، أن تنشأ مخافةٌ واسعةُ النطاق من أن يكون إصدارُ بعض الدول قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب توطئةً للتضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان، فإن من المشروع أيضاً أن يُنْظر إلى تلك القوانين بما هي حاجة، لدى تلك الدول، إلى حماية المجتمع والدولة من آفةٍ مُرعبة، على أن تشتد – في الوقتِ عينِه- الرقابة الشعبية الداخلية والرقابة الحقوقية الدولية على كيفيات تطبيق تلك القوانين وإنفاذ أحكامها، بما يؤمِّن سلامة ذينك التطبيق والإنفاذ. ولعلّ المخافة تلك (من سوء تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على صعيد كلّ دولة) هي عينُها، اليوم، المخافة من سوء التطبيق على الصعيد الكوني (الدولي) للقوانين ذاتِها، ومن مبرّراتها وجود نيّةٍ مبيّتة في الخلط المقصود بين الإرهاب والمقاومة، بين عملٍ مسلّح أعمى وإجرامي لا قضية له سوى الفتك بأرواح الأبرياء، و(بين) عملٍ مسلّح لطرد المحتل الغاصب واسترداد الوطن، بين عملٍ تقوم به عصابات القتل الإجرامية وعملٍ تنهض به حركات التحرر الوطني، وأخيرًا – بين عملٍ تُجرّمه القوانين الدولية وتلاحق القائمين به وعليه، وعملٍ يجيزُهُ القانون الدولي للشعوب التي وقَع على أراضيها وأوطانها فعلُ الاحتلال العسكري. وغيرُ خافٍ أنه الخلطُ الذي سعت فيه – وما زالت تسعى- الدولةُ الصهيونية ورُعاتُها الغربيون.
على أنّ الأغرب من دعوةِ دولٍ بعينها إلى مفاوضة جماعاتها الإرهابية، بغية التوصل إلى «تسويةٍ سياسية» تُشرِك تلك الجماعات في السلطة، أن يُصار إلى التمييز الجهير بين جماعات إرهابية «معتدلة» وأخرى متطرفة، وأن يُبْنى على التمييز شرعنةٌ للأولى في الصيرورة شريكًا في التفاوض والتسوية! ليس في القَتَلة والمجرمين معتدل ومتطرف، وليس من ميزانٍ توزَن به الأشياء على هذا النحو الخارج عن أيّ معيارٍ عقلي! حين يكون بين القنافذ أملس، سيكون – حينها- بين الإرهابيين معتدل ومتطرف. لكن الأخطر من ذلك أن تبرئة الإرهاب، على هذا النحو من التمييز الخاطئ، سيصبح سابقةً خطرة سيوجَد من سيبني عليه غدًا ضدّ من يدافع، اليوم، عن هذا التمييز!
*الاحد 3 يناير 2016
عن التجديد العربي