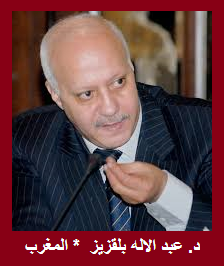المجتمعات الإسلامية هي الحواضن الطبيعية للدين، لأن الدين ملك للمؤمنين به، وتجسيد مادي له فيهم، الإسلام ليس نصاً بين دفتي المصحف فحسب، وإنما هو أيضاً الناس الذين يعتنقون تعاليم ذلك النص وينزلونها إلى التاريخ، ويمددون مفعوليتها في الزمان والمكان. والمجتمعات تلك هي التي حفظت الإسلام في الماضي، وليست الدولة والفرق والمذاهب، وهي عينها التي تحفظه اليوم: في ديارها وفي داخل الجماعات المسلمة التي تعيش في المهاجر.
لا مشروعية لأي ادعاء بأن نفوذ هذه المؤسسة أو تلك من مؤسسات السياسة على الإسلام إنما يرمي إلى حمايته، لم يكن الإسلام، في تاريخه، في حاجة إلى مؤسسة تحميه وتذب عنه، حتى حينما كانت أرض الإسلام تسقط في قبضة غير المسلمين من المحتلين (في العهد الصليبي أو في العهد الكولونيالي الحديث مثلاً)، لم يكن المسلمون في حاجة إلى من ينقذ دينهم من سلطة برانية عن الملة، فهم وحدهم من كانوا يحمونه لمجرد إيمانهم به، وتلك هي، كذلك، حال ملايين المسلمين ممن يقطنون بلداناً فيها أنظمة غير إسلامية أو علمانية أو مسيحية، فلا يجدون حاجة إلى من يحمي دينهم من التبديد في وسط اجتماعي مختلف.
كانت الدولة، في الماضي، تدعي أنها القوة الذابة عن الإسلام، الحادبة عليه، الحاملة إياه إلى الآفاق، لكننا نعرف، أن الإسلام لم ينتشر في العالم بالسيوف والرماح، فحتى إبان الفتوح الكبرى، في القرن الهجري الأول، لم يفرض الفاتحون دينهم بالقسر على سكان البلاد الموطوءة، فبقي أكثر سكانها على دينهم، وفرضت عليهم الجزية ضريبة أمان، ولقد مر زمن طويل، بعد الفتح، كان فيه المسلمون قلة في العراق والشام ومصر وبلاد فارس، في المقابل نهض التجار والمتصوفة بأدوار كبرى في نشر الإسلام، في آسيا وإفريقيا، على أوسع النطاقات بما لم تستطعه الدولة أو الحركات السياسية، وحين انكفأ سلطان «دولة الإسلام» في الحقبة الاستعمارية، وقامت دولة الاحتلال بإدارة المجتمعات الإسلامية، لم يتعرض الدين للتصفية أو الاجتثاث، حتى على الرغم من حملات التبشير الكاثوليكية والبروتستانتية المكثفة، والمسكوت عن حرية حركتها من الإدارات الاستعمارية! ولم يكن تحقق الأمن الديني (الإسلامي) ثمرة «تحضر» الاستعمار، وإنما أتى نتيجة رسوخ الإيمان الإسلامي في نفوس المسلمين. والمثال الأجلى عن عدم حاجة الدين إلى من يحميه من خارج المجتمع (هو) مثال الجزائر، فلقد خضعت أربعة أجيال أو خمسة من الجزائريين لاحتلال فرنسي بغيض، جرب، بالوسائل كافة، تذويب الشخصية الوطنية والدينية للسكان في أفق استيعابهم ضمن مشروع إدماج «الجزائر الفرنسية» في الكيان الفرنسي، والنتيجة أن جزائر الستينات المستقلة خرجت أكثر تمسكاً بإسلاميتها من أي فترة أخرى سابقة في تاريخنا.
غير أن التشديد على عدم وجود تلازم بين الدين، من جهة، والدولة والجماعات السياسية، من جهة أخرى، و(التشديد) على أن المجتمع والأمة كلاهما حاضنة الدين ومرجعه التاريخي، يجد من يستثمره، عكس منطقه مؤداه، قصد الدعوة إلى فك الدولة وارتباطها بالدين فكاً نهائياً، وإعادته إلى أهله الطبيعيين (يقصدون بهم الجماعات الدينية) بحسبانه شأناً خاصاً بهم، وما من شك لدينا في أن الأمر، في هذه الدعوى، يتعلق بتأويل زائف للفكرة القائلة بتلازم الدين والمجتمع.
ولدينا على هذه الدعوى ملاحظتان نقديتان مترابطتان موضوعياً، تتعلق الأولى بنوع الصلة التي ينبغي أن تقوم بين الدولة والدين، وتتعلق الثانية بمعنى الحاجة إلى عودة الدين إلى حضنه الطبيعي: المجتمع والأمة.
في المسألة الأولى نعرف أن العلاقة بين الدولة والدين، في تاريخ الإسلام الكلاسيكي والحديث والمعاصر، لم تستقم على النحو الذي يحفظ للإسلام تعاليه الروحي عن المنازعات السياسية، ظلت الدولة، بمساعدة فقهائها، تستلحق الدين بها وتستغله في صراعاتها مع خصومها السياسيين في الداخل، وكثيراً ما لجأت السلطة فيها إلى تبرير قرارات سياسية، مطعون في شرعيتها، باسم الدين (والأدق باسم مذهب من مذاهبه)، وفي الأغلب على حساب جماعات مذهبية أخرى (ماذا فعل المهدي بن تومرت الموحدي في المغرب، وماذا فعلت الأسرة الصفوية في إيران غير ذلك؟)، ولقد استمر العمل بالنزعة الإلحاقية للدين في الدولة الحديثة والمعاصرة، وخاصة في الدول التي تدعي تطبيق الشريعة الإسلامية في أحكامها القانونية، ولكن مقابل هذه النزعة، نشأت أخرى نقيضاً، هي النزعة الإقصائية للدين، بتأثير من نماذج ثلاثة: النموذج اليعقوبي الفرنسي، والنموذج البلشفي الروسي، والنموذج الكمالي التركي، ونجد لهذه النزعة تطبيقات في تونس البورقيبية وإيران الشاهنشاهية، والنزعتان معاً، الإلحاقية والإقصائية، كانتا من السوء، على تفاوت في الدرجة) بحيث ترتب عليهما النتيجة عينها: صعود «الإسلام السياسي» ومنازعته الدولة على الرأسمال الديني.
مقابل تينك النزعتين، لا مهرب من إعادة هندسة علاقة جديدة بين الدولة والدين: علاقة لا تستلحق فيها الأولى الثاني، كما يبغي المحافظون، ولا تستبعده وتقصيه، كما يبغي قسم من العلمانيين، إذا كان على الدولة أن تعترف بأن الدين ملكية جماعية للشعب والأمة، فعليها ألّا تصادر تلك الملكية ممن يبتغى انتزاعها من الناس باسم «تمثيل» الدين «القويم».
سميت مثل هذا التدخل، في دراسة سابقة، باسم التدخل المحدود (في مقابل تدخل مذموم)، وعنيت به إحاطتها حقوق الأمة في دينها بالضمانات القانونية والدستورية بما يكفلها ويمنعها من المصادرة: الحق في التدين وممارسة الشعائر الدينية، الحق في الاجتهاد وكفالته، إقرار مبادئ التسامح مع المخالفين، منع استغلال الدين وأماكن العبادة لأغراض سياسية… إلخ، الدولة، في هذه الحال لا تحتكر الدين، مثلما كانت تفعل في الماضي، ولكنها تحتكر الإشراف الدستوري والقانوني على حقوق المجتمع فيه بما هو ملكية عامة. والفارق كبير بين احتكار الدين، وفرض الرأي الواحد (الرسمي) فيه، و(بين) احتكار سلطة ردع الانتهاكات لحقوق المجتمع في الدين، وهي، بطبيعتها، حقوق مختلفة ومتنوعة بتنوع الجماعات المؤمنة،
أما في المسألة الثانية فإن عودة الدين إلى حضنه الطبيعي (المجتمع والأمة)، الذي ندعو إليه وندافع عنه، لا تعني، بحال، ما تعنيه لدى جماعات «الإسلام الحزبي» الناقمة من علاقة الدولة القائمة بالدين، فالقول الذي عنينا ليس ترخيصاً بإقدام أي جماعة اجتماعية على وضع يدها على الإسلام بزعم حق المجتمع فيه، لأن في ذلك مصادرة له من المجتمع، وتأسيساً لسلطة أخرى عليه، إن استيلاء أي جماعة «دينية»، سياسية على الإسلام يعادل، بل يفوق خطراً، استيلاء سلطة سياسية ما عليه، إنه رديف النزعة الإلحاقية التي انتقدناها قبلاً، مع فارق كبير بين الاستلحاقين: بين استلحاق تقوم به دولة لها، على الرغم من أي اعتراض، قدر من التمثيل الاجتماعي، واستلحاق تقوم به جماعات لا تمثل إلّا نفسها، وخاصة حينما يقع مثل ذلك الاستلحاق في مجتمعات متعددة التكوين الطائفي والمذهبي، مثل بعض مجتمعات المشرق العربي، أو إيران، أو باكستان، أو نيجيريا… إلخ.
عودة الدين إلى حضنه الطبيعي ليست تسويغاً لخصخصته (أو خوصصته)، وإنما إنفاذ لمبدأ تأميمه بحسبانه ملكية جماعية للشعب والأمة، وعلى ذلك، فإن من يبتغون فتح دكاكين سياسية من طريق الاستثمار في الرأسمال الديني، بدعوى أن ذلك حق محقوق للمجتمع في الدين، إنما هم، بذلك، ينتهكون ذلك الحق انتهاكاً ساخراً بمصادرتهم ذلك الحق من أهله، إن استيلاءهم على الدين أقصر سبلهم إلى الاستيلاء على السلطة، وفي ذلك تلاعب بالدين شديد الخطورة عليه، وعلى المجتمع والدولة.