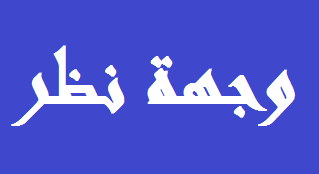دراسة سوسيولوجية لتحولات الحياة السياسية المغربية…
الانتقال الديمقراطي بالمغرب
دراسة سوسيولوجية لتحولات الحياة السياسية المغربية
مقاربة للفهم ومحاولة للتفكير
في الديمقراطية:
ليست الديمقراطية(*) سوى نمط معين لتنظيم المجتمع وربط مختلف أجزائه ومستوياته بعضها ببعض، من أجل تقوية قدرة فعل هذا المجتمع، اتجاه نفسه، أي إمكاناته وطاقاته، واتجاه محيطه الطبيعي والاجتماعي. إنها أداة فعالة لدفع جميع مكونات المجتمع كي تنخرط، بجدية، في مشروع تطوير وتنمية المجتمع نفسه بنفسه دون الاعتماد على قوة خارجة عنه. لهذا فإن للديمقراطية أوجها عديدة تغطي مختلف مناحي حياة المجتمع.
فهي مناخ ثقافي لإيقاظ الوعي الاجتماعي لكافة أفراد المجتمع وتحفيزهم، من أجل أن يعوا حظوظ نجاحهم، وصعوبات تحقيق مستقبلهم، وأن ينشغلوا باستمرار، وبإمكانيات متساوية، على تطوير الحظوظ وقهر الصعاب.
وعلى المستوى السياسي، تتجسد الديمقراطية في المشاركة الواسعة والمنتجة للشعب في التسيير عبر منظومة سياسية تعكس الشأن العام. وتتجسد اقتصاديا، في حق الفقراء في الكفاح والنضال من أجل رفع حصتهم من خيرات البلاد، وهي بهذا، تمكن من تقليص اللامساواة الاجتماعية بين الأفراد والجماعات والفئات..
أما على المستوى الاجتماعي والقانوني، فإنها تتجسد في إشاعة الحرية في الفعل والتنظيم والتعبير، وضمان حق مقاومة الخوف. والحرية لا تسود إلا إذا تمت حماية الأفراد بالقانون، وليس بشيء آخر غير القانون. بمعنى عدم تعرض الأفراد والجماعات والفئات (كيفما كان انتماؤها الاجتماعي، أو الثقافي، أو الجغرافي، أو الجنسي..) لمظالم القوة أو السلطة أو المال (سواء كانت هذه المظالم مادية، أو رمزية معنوية) واعتبار حمايتهم حقا وليس منحة أو امتيازا. بتعبير آخر، إن الديمقراطية لا تسمح لأمزجة الأفراد كيفما كان موقع أصحابها داخل المجتمع، من أن تعبث بالمصالح، وتتجاوز الحدود، وتنصب نفسها مصدر العيش والحياة والموت. إنها عملية اجتماعية تمنع ظهور الاستبداد داخل هذا المجتمع، وتجعل هذا الأخير، يعيش على الاعتدال، أي على توازن القوى والمصالح.
والديمقراطية، قبل كل هذا وبعده، تتجسد في الفرد/المواطن، عندما يحترم شرطه الطبيعي، ويتكلم مرة واحدة، لأن له فما واحدا، ويستمع مرتين، لأن له أذنين إثنين.
في مفهوم الانتقال الديمقراطي:
تشير مقولة “الانتقال الديمقراطي” إلى مراحل من تطور المجتمع “تطبع بالريبة السياسية، وتخضع لأحداث غير منتظرة، ولتطورات غير متوقعة، ولحلول اضطرارية. كما أن الإكراهات “العادية” للبنى الاجتماعية والمؤسسات السياسية في هذه المراحل تؤجل؛ فالفاعلين يضطرون في غالب الأحيان إلى تبني اختيارات سريعة وغامضة. والتحالفات التي يعقدونها غالبا ما تكون عابرة ونفعية. ونتائج تفاعل الفاعلين لا تتوافق في معظم الأحيان مع الأفضليات التي انطلق منها كل فاعل”.
إنها مراحل تدفع إلى تسويات بين الفاعلين السياسيين الأساسيين و”تقيم قواعد وأدوارا ونماذج للسلوك جديدة يمكنها أن تطبع قطيعة مهمة مع الماضي، وأن تخلق بدورها مؤسسات ستشكل تصورات لتدعيم النظام في المستقبل”.
هكذا فإن الانتقال الديمقراطي، هو حالة تأهب تاريخية كبرى، عند كل الفاعلين السياسيين، (أو على الأقل عند الأساسيين منهم) وبتفاوتات معينة، للدخول في سيرورة سياسية جديدة تتميز بالقطع مع الماضي، والحفاظ على توازنات معينة لمصالح كافة الأطراف الاجتماعية والاقتصادية، والاعتراف المتبادل بمشروعية مطالبها وحقها في الوجود والفعل. لهذا نجد مرحلة الانتقال مطبوعة بسيادة مطالب تتعالى من مختلف الاتجاهات: المطالبة بالاعتراف بأهمية الرأسمال إلى جانب المطالبة بالاعتراف بالعمل. المطالبة بتقوية القطاع العمومي إلى جانب المطالبة بتشجيع القطاع الخاص. الترحيب بالاستثمارات الأجنبية، إلى جانب المطالبة بقرار اقتصادي وطني. المطالبة بتشجيع المقاولة إلى جانب تنمية مداخيل الضريبة. كما نجد المطالبة باستقلال المجتمع المدني، والمطالبة في نفس الوقت، بسياسة تدخلية للدولة في كافة الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
كل هذا يعني أن الانتقال الديمقراطي هو سيرورة سياسية، تنطلق دون أن يتغيب عنها أي فاعل من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، الذين كانوا يتنازعون من أجل احتكار السلطة لفائدة أحدهم. إنه سيرورة يدخل فيها هؤلاء الفاعلون في حركية تاريخية، سواء ليؤكدوا هوياتهم السياسية، أو ليغيروها بإعطائها تأويلات جديدة تبرر تبنيهم لأدوار سياسية جديدة مغايرة.
إلا أنه عندما يقال أن “الإكراهات “العادية” للبنى الاجتماعية والمؤسسات السياسية” تؤجل في مراحل الانتقال الديمقراطي، فإن هذا لا يعني أن هذه المراحل تسود فيها إرادوية مطلقة. “فحتى في وسط اللا يقين السياسي الكبير الذي تثيره تغيرات النظام، فإن القرارات المتخذة من قبل مختلف الفاعلين، هي ردود فعل إزاء البنى السوسيو اقتصادية والمؤسسات السياسية الموجودة قبلا أو الحاضرة في الذاكرة. إن هذه البنى والمؤسسات تتحكم في القرارات ويمكن أن تكون حاسمة، باعتبار أنها تحد أو ترفع الاختيارات المعروضة على مختلف الفاعلين السياسيين الذين يحاولون بناء هذا النموذج أو ذلك من الديمقراطية”.
إن القول بتأجيل الإكراهات وتعليقها، يعني أن مراحل الانتقال، يعود فيها النقاش السياسي (ويحتد داخل المجتمع) إلى السؤال الفلسفي القديم: من يؤسس من: المجتمع أم الدولة؟ هل الديمقراطية تبتدئ من المجتمع لتفرز الدولة، من خلال المؤسسات؟ أم تبتدئ من الدولة، من أعلى الهرم الاجتماعي، لتخلق المجتمع الديمقراطي؟
لا تهمنا هنا الخلفيات الفلسفية لهذا السؤال، كما أن المجال لا يتسع لأن نجيب عنه باستحضار أطروحة روسو، أو باستحضار أطروحة لوك. كل ما يهمنا هو أن نقول إن مرحلة الانتقال الديمقراطي تأتي وفق الظروف التاريخية الخاصة بكل مجتمع، وهي تختلف من مجتمع لآخر، ومن مرحلة دولية لأخرى، ومن مستوى نمو اقتصادي لآخر، وحسب طبيعة الفاعلين السياسيين، الاجتماعية والثقافية، ودرجة نزاعاتهم ووحدتهم.
ولعل ما تعرفه الحياة السياسية المغربية، منذ مطلع العقد الأخير، من تحولات ونزاعات ورهانات وأفعال وتحالفات، كاف لأن يجعلنا نتحدث عن مرحلة جديدة يعرفها المغرب، تتسم بكل مواصفات مرحلة الانتقال الديمقراطي.
فالفاعلون السياسيون نحوا، منذ مطلع هذا العقد، إلى بناء تأويلات جديدة للواقع الاجتماعي والاقتصادي، وعملوا على تغيير، أو تعديل، هوياتهم السياسية، وإعطاء أبعاد جديدة لوعيهم الاجتماعي، وتمكين خصومهم من حق الوجود والفعل، ولم ينسوا أن يدخلوا قسطا، غير زهيد، من النسبية على خطاباتهم وأهمية أدوارهم، وآثار فعلهم.
هكذا، عرفت الحياة السياسية المغربية لغة سياسية جديدة، انتقلت من ثنائية، “الليبراليين”/”الماركسيين”، إلى ثنائية “اليمين”/”اليسار”. كما عرفت رهانات جديدة انتقلت من ثنائية الاندماج/الثورة، إلى الديمقراطية؛ وسلطة جديدة، من تلك التي تعتمد أسلوب الانفراد والاحتكار، إلى سلطة المؤسسات والقانون.
باختصار، يمكن القول إن الحياة السياسية المغربية، هي بصدد الانتقال من نهج سياسة “الحقيقة” من طرف الفاعلين، أي كل فاعل يعتقد بـ”حقيقته” حول الواقع الاجتماعي ويتصرف وفقها، ويعتبرها الضامن الوحيد للعصمة من الخطأ، إلى نهج سياسة “الملاءمة” أي اعتماد الحلول الملائمة للمشاكل والأزمات، وفق جدلية النزاع، وتضارب المصالح، وقوة الفاعلين على أرض الواقع الملموس.
وإذا كان كل انتقال ديمقراطي يمتاز بعنوان رئيسي، حسب كل مجتمع وخاصياته التاريخية والاجتماعية والثقافية، فإن العنوان الرئيسي للانتقال الديمقراطي بالمغرب، هو عملية فصل الدولة عن المنظومة السياسية، وجعل المنظومة السياسية تخضع لجدلية النزاع الاجتماعي، والدينامية المدنية للمجتمع المغربي. إنها العملية التي سوف يقاس بها نجاح الانتقال الديمقراطي بالمغرب، أو فشله.
ويجب أن نؤكد، أننا عندما نقول إن الحياة السياسية المغربية تعيش حاليا مرحلة الانتقال الديمقراطي، فإننا نشير إلى واقع يتحول، وإلى سيرورة معقدة وغنية، لا إلى واقع مكتمل، ووضع واضح.
I – في اكتشاف فكرة الديمقراطية بالمغرب:
– بين الثورة والاندماج:
عرفت الحياة السياسية المغربية، منذ سنوات الاستقلال، إلى بداية العقد الأخير، فكرتين أساسيتين تزاحمتا على الخطاب السياسي للفاعلين، سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة. هاتان الفكرتان هما، فكرة الاندماج السياسي، التي تبنتها السلطة المركزية، وفكرة مدرسة التبعية، التي تبنتها قوى اليسار المغربي في مختلف تياراته. فبالنسبة للسلطة السياسية المسيطرة، كانت تتبنى فكرة الاندماج، التي تعني بالأساس العمل على تقوية السلطة المركزية من خلال منع ظهور فاعلين سياسيين مستقلين عنها، وتبني نهج سلطوي (autoritaire)، يسعى إلى تحقيق سيطرة كاملة على مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية، وبناء مجتمع على مقاس المصالح الاقتصادية والسياسية لفئات النخبة الحاكمة المنفردة بالجاه والمال. واستندت السلطة السياسية، في تكريسها لهذا النهج السلطوي، على لغة سياسية محافظة، هي عبارة عن خليط من المقولات “التقليدية” و”الحديثة”، لتسوغ انفرادها بالقرار. فكانت مقولة الخصوصية من جهة، ومقولة الليبرالية، من جهة أخرى، أهم هذه المقولات. فالخصوصية كانت تعني أن المجتمع المغربي متفرد، في ثقافته وتاريخه، عن باقي المجتمعات الأخرى، وأن طبيعة السلطة السياسية السلطوية، وما يترتب عنها من حياة سياسية منغلقة إلى منعدمة، هي النهج الوحيد الملائم للمجتمع المغربي، بحكم أنها سلطة نابعة حسب ادعائها من صميم خصوصياته. أما الليبرالية، فهي المآل الذي سوف يصل إليه المجتمع المغربي، وفق خصوصيته، وهي الطريق الوحيد الممكن، تمشيا مع النموذج الغربي الرأسمالي، للخروج من حالة التخلف، التي ما هي سوى مرحلة عابرة، سوف يتم تجاوزها إلى ما هو أرقى. وكأن المجتمع المغربي، في هذه المرحلة، طفل صغير ينتظر مرحلة النضج والرشد، ليصبح متقدما وفي مصاف الدول الكبرى المصنعة، فقط عليه أن يدعن لقرار السلطةالمركزية دون أية مقاومة.
بالطبع لا يمكننا أن نجد انسجام هذه اللغة السياسية سوى في الواقع المادي للسلطة السياسية المركزية، والذي كان قائما بالأساس على الانخراط في المنظومة الاقتصادية الرأسمالية العالمية، ضمن وضع دولي مطبوع بحدة الحرب الباردة بين الغرب والشرق. إذ كان من المطلوب خلق شروط إعادة إنتاج ظروف التبعية الاقتصادية، للغرب الرأسمالي، وذلك بتبني سياسة “رأسمالية” في الاقتصاد، يقال عنها ليبرالية، وفي نفس الوقت، خلق شروط اجتماعية وسياسية، تمنع ظهور انعكاسات هذه السياسة على الحياة العامة للمجتمع المغربي سواء كانت هذه الانعكاسات عبارة عن حريات سياسية أو نقابية أو مطالب اجتماعية.
هكذا فرض النهج السلطوي على المجتمع المغربي نهجا وحيدا، هو الاندماج في منظومته وتحت سيطرة منطقه السياسي الأحادي الذي يسلم بانغلاق هذه المنظومة على أية حركية اجتماعية.
أمام هذا النهج المفروض من قبل منظومة سياسية، حصرت مهمتها في السيطرة على المجتمع، سادت عند الفاعلين السياسيين والاجتماعيين المعارضين فكرة مغايرة، تأخذ مرجعيتها من نظرية التبعية الاقتصادية المعروفة، مفادها أن النظام السياسي القائم لا يتمتع بأي استقلالية اتجاه المراكز الرأسمالية الغربية، سواء سياسيا أو اقتصاديا، وأن الفعل السياسي الوحيد الممكن، داخل حياة سياسية مغلقة وممركزة على نهج سلطوي هو الفعل الثوري القاضي بتغيير الاقتصاد والسياسة والثقافة تغييرا جذريا نحو الاشتراكية، كمآل وحيد لسيرورة المجتمع المغربي، في هذه المرحلة: مرحلة “الانتقال نحو الاشتراكية”. وكانت فكرة التبعية هذه، وانعكاساتها السياسية، تجد هي الأخرى، ما يدعمها داخل الوضع الدولي للحرب الباردة، وداخل إيديولوجية حركات التحرر العالمية، التي كانت تنتسب لها قوى المعارضة اليسارية المغربية. وجاءت اللغة السياسية لهذه القوى، هي كذلك مستندة على مقولتين اثنتين: الخصوصية والاشتراكية. فالخصوصية في هذه اللغة الثورية، تعني بالأساس الاقتصاد المغربي، وطبيعة تشكل الإنتاج “الرأسمالي” داخله، الذي يمنع ظهور أي شكل من أشكال الليبرالية، كما عرفتها المجتمعات الغربية، بفعل غياب برجوازية مغربية تتمتع باستقلال اقتصادي، مما يستدعي مقولة الاشتراكية، كحل وحيد ممكن للتخلف المغربي.
هكذا، فأمام نهج الاندماج والمحافظة، الذي فرضته السلطة المركزية، ينتصب نهج القطيعة والثورة، الذي تبنته قوى سياسية يسارية، كإمكانية وحيدة للتغيير، داخل المجتمع المغربي.
عرفت هاتان الفكرتان اللتان تزاحمتا على الحياة السياسية المغربية، منذ الاستقلال، عدة تجسيدات متفاوتة ومختلفة، على أرضية الواقع المغربي، حسب جدلية الصراع السياسي والإيديولوجي الدولي، وحسب توازنات القوى الاجتماعية الداخلية للمجتمع المغربي. فمن اللاءات الثلاث لليسار الرادكالي داخل الجامعة المغربية (أي موقفه من النظام القائم؛ اللاشعبي، اللاديمقراطي، اللاوطني) إلى تبني الاشتراكية العلمية تارة، أو اشتراكية “عربية” أو “إسلامية” تارة أخرى، إلى برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية، وقبول العمل السياسي المؤسساتي، داخل البرلمان، كواجهة ليس للتأثير على القرار السياسي، وبناء سلطة المؤسسات، بل فقط لإيصال صوت وبرنامج الحزب للجماهير الشعبية. كل هذه كانت أشكالا مختلفة “للاختيار الثوري” الذي كانت تتبناه القوى السياسية الصاعدة، على خلفية هيمنة فكرة التبعية على الفعل السياسي الثوري.
وفي الجهة المقابلة، جهة النهج السلطوي المسيطر على القرار السياسي، كانت السلطة المركزية تنوع وتشكل في سياستها المحافظة اتجاه المجتمع. فرغم سيطرة هذه السلطة على كل مناحي الحياة العامة للمجتمع المغربي، كان هامش حرية الفاعلين السياسيين المستقلين عنها، يتسع ويضيق حسب جدلية الصراع الاجتماعي الداخلي، وتوازنات الحرب الباردة دوليا. وكان التسامح مع التعددية السياسية لا ينعدم بالمطلق وفي نفس الوقت لا يتجسد في مؤسسات سياسية، الأمر الذي دفع أحد الباحثين (Waterbury) إلى وصف النظام السياسي المغربي بأنه نظام “لا يقطع الرؤوس ولا يحل المشاكل”.
– ظروف اكتشاف فكرة الديمقراطية:
إلا أن سيطرة السلطة المركزية على الحياة السياسية والاجتماعية للمجتمع المغربي لم تكن لها أهداف أخرى سوى العمل على منع ظهور فاعلين سياسيين واجتماعيين مستقلين عنها، يتمتعون بقوة مادية يمكن أن تؤثر على القرار السياسي المركزي. لهذا كان هدف السلطة من تبني النهج السلطوي، كأسلوب سياسي وحيد، هو تقوية ودوام السيطرة، وليس بناء تنمية ما، وتسيير تاريخية المجتمع المغربي، تماشيا مع ديناميته الداخلية ومطالبه الاجتماعية. مما أدى إلى تفاقم المشاكل على كافة الأصعدة والمستويات، وجعل المجتمع المغربي يدخل بسرعة إلى أزمة قوية، تمس بالأساس اندماجه الاجتماعي، الذي شكل لمدة طويلة، قوام المنظومة السياسية المسيطرة، دون أن تعمل على تقويته وتنميته.
فأمام التطورات والتغيرات التي عرفتها المنظومة الاجتماعية، للمجتمع المغربي، سواء من حيث حجمه وتشكله الديمغرافي (سيطرة الفئات الشابة على الهرم السكاني)، وتوسع مجاله الحضري وانتشار التمدن (التقلص الواضح لسكان القرى)، أو من حيث التغيرات الثقافية والمعرفية التي مست بناه النفسية والذهنية (وهي التغيرات التي انعكست في الخروج الكبير للمرأة خارج البيت وفي مختلف الأنشطة، دون أن تجد مقاومة كبيرة من المجتمع. الأمر الذي جعل الأسر المغربية في معظم الأحيان تتجاوز نموذج الأسرة الأبوية. كما أنها تغيرات انعكست كذلك في الاهتمام المتزايد بالطفل والطفولة..)، وخلقت متطلبات جديدة ووعيا يقظا بمقتضيات العيش العصري، (كضرورة أخذ بعين الاعتبار البعد الجمالي في الحياة اليومية..)، أو من حيث نمو واتساع الحركية الاجتماعية داخله بسبب التثاقف مع الخارج، وتوسع الفئات الاجتماعية الوسطى، ثقافيا على الأقل، (كانتشار الشهادات العليا في مختلف التخصصات داخل الطبقات الشعبية مثلا) وانتشار المعرفة التطبيقية وتنامي الطابع الدنيوي للحياة العامة للمجتمع المغربي، (كانتشار الوعي الصحي والوقائي، والاستعمال الكبير للتقنية في الحياة اليومية..). أمام كل هذا وغيره، صارت المنظومة الاجتماعية، بمختلف عناصرها، تدخل في حالة من اللاتوافق الحاد مع المنظومة السياسية المسيطرة، التي بدت تعيش استقرارها على حساب الاندماج الاجتماعي المأزوم، وصار المغرب عبارة عن قاعة انتظار كبيرة دون وجود طبيب مستقبل. فالمطالب الاجتماعية والاقتصادية أصبحت مصادرها متعددة ومختلفة: أرباب العمل والمقاولة، كما النقابات والعمال، المعطلون كما العاملون. وضرورة الإصلاح الفوري تتعالى من كل مرافق الحياة العامة للمجتمع، والاقتصاد ينكمش نموه كما تضعف إنتاجيته، ودوائر الفقر والتهميش تتسع، والظلم يستأسد. كلها مؤشرات تدفع الأفراد والجماعات داخل المجتمع إلى سلوكات مطبوعة بنوع من الفوضى (l’anomie) بين الطموح إلى أهداف مشروعة وعقلانية، لكن بوسائل غير العقل والعمل.
وإذا كانت أزمة الاندماج الاجتماعي داخل المغرب تجد جذورها داخل سيرورة تشكل البنية الاقتصادية منذ الاستقلال حيث تم بناء اقتصاد يعتمد على فلاحة التصدير للخارج، وإهمال التصنيع، وترويج تجارة الريع والامتيازات والفساد..، فإن الجديد في هذه المرحلة هو وصول هذه الأزمة إلى درجة أصبحت فيها تنعكس على المنظومة السياسية القائمة، وتحد من قوة سيطرتها على المجتمع المغربي. بمعنى أن أزمة الاندماج الاجتماعي بالمغرب وصلت منذ بداية العقد الأخير إلى وضع المبادئ المنظمة للبنية الاجتماعية، محط نقد ومراجعة ورهان سياسي وبالتالي صارت المؤسسات السياسية في طريقها إلى التفكك والانحلال (وما تزايد نسب العزوف عن المشاركة السياسية في الحقل السياسي الرسمي سوى مؤشر قوي على تأثير أزمة الاندماج الاجتماعي على المنظومة السياسية المسيطرة).
وأمام تعاظم مظاهر الأزمة الاجتماعية، وتنامي قوة المطالب النقابية والسياسية للمجتمع المغربي، وقف النهج السلطوي للسلطة المركزية على عجز مزدوج: عجزه عن حل المشاكل وتلبية المطالب الاجتماعية المشروعة من جهة، وعجزه من جهة ثانية، عن القضاء على الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين الخارجين عن سيطرته ومراقبته، وإسكات صوت المحتجين. فبخصوص عجزه عن حل المشاكل وتنمية الاقتصاد، فإنه يعود إلى طبيعة الأهداف التي بني من أجلها النهج السلطوي القديم، وهي الأهداف التي تتلخص في نقطتين أساسيتين: أولا إخضاع الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمقتضيات القرار السياسي، وليس العكس، كما هو الشأن في الأنظمة الديمقراطية. ثانيا، منع ظهور فاعلين سياسيين أو اجتماعيين مستقلين عن السلطة المركزية. هكذا فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لم تكن مستهدفة من قبل المنظومة السياسية المسيطرة، وإن وجدت بعض مظاهرها السطحية والمحدودة، فإنها من قبيل النتائج الجانبية (Effets pervers) ليس إلا. أما بخصوص عجز النهج السلطوي عن القضاء على الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين المستقلين عنه، فإنه يعود إلى عاملين مختلفين ومترابطين: عامل داخلي، هو توسع القاعدة الاجتماعية والمادية للمطالب الاقتصادية، وهو التوسع الذي قوى الفاعلين السياسيين المستقلين عن السلطة المركزية، ومكنهم من مراكمة مشروعية سياسية حديثة تلوح في الأفق، وعامل خارجي، تمثل في التحولات الدولية مع إنهاء الحرب الباردة وبروز معايير جديدة في العلاقة بين المراكز المصنعة الرأسمالية ودول المحيط التابعة. وهي معايير أساسها النموذج الليبرالي للحياة السياسية والاقتصادية، حتى تتمكن دول المركز الرأسمالي من ضمان أسواق خارجية بصفة دائمة ومسترسلة. الأمر الذي فرض على السلطة السياسية في المغرب أن تحدث انفتاحا في تعاملها مع المجتمع وتغير من نهجها السلطوي القديم، وذلك من أجل تحقيق استمرارية تاريخية على المستوى الداخلي، وتحقيق اندماج جديد في المنظومة الدولية الجديدة على المستوى الخارجي.
مقابل هذه الأزمة الاجتماعية وانعكاساتها السياسية على المنظومة السياسية المسيطرة، عاشت قوى اليسار السياسية، هي الأخرى، تغيرات كانت لها تأثيرات قوية على الحياة السياسية المغربية. فمع تفاقم مظاهر أزمة الاندماج الاجتماعي داخل حياة المجتمع المغربي، ومع التغيرات السوسيوثقافية التي عرفتها عناصر منظومته الاجتماعية، إلى جانب التحولات الدولية، خاصة مع فشل التجارب الاشتراكية، وتراجع الإيديولوجيات الكبرى داخل المجتمعات “الثالثية”، أصبح واضحا لأغلب عناصر هذه القوى اليسارية في المغرب أن فكرة التبعية التي كانت تؤطر تصورها العام فكرة اقتصادية بالدرجة الأولى، تسمح للحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي بأن تنفلت من الفهم والتحليل، وتجعل بالتالي الفعل السياسي ضعيفا ودون نتائج تاريخية حقيقية. فبقدر ما كان فيه هذا الفعل ثوريا على مستوى الطموح والتصورات العامة، بقدر ما كان فيه ضعيف الفعالية ودون التضحيات التي تطلبها.
لقد تبين لأهم مكونات اليسار المغربي أن أهمية نظرية التبعية، وهي بحق لا تخلو من أهمية، تبقى في الحدود الاقتصادية، وأن العلاقات الاجتماعية والثقافية والمصالح السياسية التي تنجم عن وضع تبعية الاقتصاد الوطني للخارج، ليست خاضعة بشكل آلي لهذه التبعية، بل لها خصائص ومميزات يجب الانتباه لها، وبالتالي الخروج من موقف إما الثورة الاشتراكية، أو الاستسلام للتخلف كقدر محتوم. لهذا أصبح خطاب اليسار، وخاصة خطاب أحزابه التي تنشط في شرعية قانونية، يبتعد عن استراتيجية القطيعة مع الواقع السائد، ويبحث عن مجالات ومرجعيات داخل هذا الواقع ليعتمدها في بلورة سياسيته الجديدة الإصلاحية. لذا تم الانتباه أخيرا إلى أن المغرب يتوفر على دستور متقدم فقط يجب النضال من أجل تطبيقه كاملا، وأن على المعارضة المساهمة في تطوير الحياة النيابية والمؤسسات السياسية، لا أن تثور عليها. كما تم الميل إلى اعتبار مشكل الطبقة العاملة هو غياب مقاولة وطنية تؤدي واجباتها وتراعي المصلحة الوطنية، وليس مشكل الاستغلال الطبقي. وعلى المستوى الإيديولوجي تم الرجوع إلى الفكر السلفي وتنشيط أطروحاته الإصلاحية كمحاولة لبناء مشروعية الإصلاح الديمقراطي من داخل الأدبيات الإسلامية، الأمر الذي ترجم سياسيا بالتحالف مع حزب الاستقلال. لقد أصبح الأمر في المحصلة النهائية، هو “أزمة المجتمع” برمته، وليس فقط أزمة دولة سياسية. وبالنتيجة فإن الاستراتيجية السياسية أصبحت هي “البناء الديمقراطي” لـ”إقامة تضامن بين الطبقات” وليست هي “الثورة الاشتراكية” التي تقودها مكونات كتلة الجماهير الشعبية ضد البرجوازية المغربية القاصرة عن قيادة التطور المجتمعي (كما كان واردا في التقرير الإيديولوجي للمؤتمر الاستثنائي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975). إنها استراتيجية “بناء دولة الحق والقانون” وليست استراتيجية “الثورة الاشتراكية” التي تقوم بها الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء والمثقفين الثوريين (كما كان يعبر الخطاب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية).
بالإضافة إلى كل هذا، تبين أن موقف الثورة والقطيعة لا يتوفر على قاعدته الاجتماعية الكافية والملائمة، لتحويله إلى فعل سياسي منتج، نتيجة لخلاصات نظرية نابعة من أوضاع اجتماعية مختلفة عن الوضع المغربي.
هكذا اكتشف اليسار المغرب أن الانعكاسات الاجتماعية والثقافية لغياب اقتصاد مغربي ممركز على الأسواق الداخلية المغربية تتمثل في تشكيلة اجتماعية مطبوعة باختلاف كبير عن التشكيلة الاجتماعية التي خلقتها الرأسمالية المركزية في المجتمعات الغربية الصناعية. فإذا كانت التشكيلة الاجتماعية في الغرب الرأسمالي تتكون من عناصر طبقية واضحة (طبقة برجوازية وطبقة عاملة، كما كان الأمر واضحا في القرن التاسع عشر)، فإنها في المغرب، وفي ظل سيطرة اقتصاد خارجي التطور (Exogène)، تتكون من عناصر منشطرة الوجود والفعل: فهي اقتصاديا طبقية، أي تتوفر على مواصفات التحديد الطبقي، كما جاء في الأدبيات الماركسية (قوة العمل كبضاعة، الامتلاك الفردي لوسائل الإنتاج)، لكنها اجتماعيا وثقافيا تحكمها علاقات ما قبل رأسمالية، مما يجعلها تنتمي إلى عالمين اثنين: عالم “رأسمالي” عصري لكنه غير صناعي (في العمل والإنتاج)، وعالم تقليدي في العلاقات الاجتماعية وأطر الإدراك الثقافية. بالإضافة إلى هذا اللاتطابق بين الاقتصادي والاجتماعي، هناك ازدواجية تطبع الحياة الاقتصادية نفسها، متمثلة في وجود أنشطة اقتصادية تقليدية إلى جانب الأنشطة العصرية وهي الازدواجية التي تعيد إنتاج القطاعات التقليدية وغير المهيكلة (l’informel)، وتجعل الواقع الاقتصادي ضعيف الاندماجية، وتخلق باستمرار قوى اجتماعية هائلة، من المعطلين والمهمشين والفقراء، لها ظروف عيش أكثر بؤسا من ظروف الفئات العمالية المشتغلة في القطاعات الاقتصادية العصرية المحدودة الانتشار.
هكذا تنتج الحياة الاقتصادية في المجتمع المغربي طبقة عاملة قليلة العدد، وتبدو اقتصاديا محظوظة بالمقارنة مع أغلبية المسحوقين والمهمشين والعاطلين والفقراء، سواء في البادية أو في المدينة، مما يفرز حياة ثقافية تكرس التقليد وتمجد الهوية والماضي ولا تتمفصل مع الحياة المادية.
صحيح أن تصورات اليسار المغربي قبل أواخر الثمانينات لم تغفل هذه الوقائع الاجتماعية والثقافية الناجمة عن وضع التبعية للخارج الإمبريالي، لكنها كانت ترى فيها أشكالا من بقايا الماضي والتقليد، آيلة للزوال مع سيطرة نمط الإنتاج الرأسمالي على الحياة العامة للمجتمع المغربي، ومع ما ينجم عن هذه السيطرة من خلق شروط الوعي الاجتماعي الحديث، تماشيا مع التصور الاقتصادي لهذا اليسار آنذاك، لعلاقة البنية التحتية مع البنية الفوقية.
ولقد نجم عن هذه الخصائص السوسيوثقافية لوضع التبعية الاقتصادية للمجتمع المغربي، حياة سياسية ينعدم فيها فعل سياسي قادر على أن يتطور إلى حركة اجتماعية، تمثل بديلا مجتمعيا للسلطة القائمة. فسيطرة منظومة اجتماعية لا تقوم على اندماج اقتصادي داخلي التطور يجعل بنيتها التحتية لا تتمثل في الاقتصاد. بمعنى أن ما يعيد إنتاجها ليس هو الاقتصاد، بل هو المراقبة والضبط السياسيين بواسطة ميكانيزمات قائمة على ثنائية الفساد-الزبونية. الأمر الذي يفرز حياة سياسية مفصولة عن الحياة الاجتماعية، أي لا تقوم على تمثيلية المصالح الاجتماعية-الاقتصادية. فغياب اندماج اقتصادي قوي داخل المجتمع المغربي يفرز مطالب وحاجيات متعددة ومختلفة ومتضاربة ومشروعة في الآن معا. مما يجعل الفعل السياسي غير قادر على بلورة تمثيلية اجتماعية منسجمة وموحدة تغذيه بالقوة والفعالية. الأمر الذي يجعله يتأرجح بين القوة والضعف: القوة في الخطاب السياسي عندما يتمثل مطالب وحاجيات كل الفئات الاجتماعية ويلامس مختلف مشاكل التنمية والتقدم (الخطابات الغليظة كما يسميها رجل الشارع المغربي). والضعف أمام بلورة فعل سياسي منتج للتغيير والتحول، لأنه لا يجد اتجاها اجتماعيا واحدا قادرا على أن يشكل القاعدة المادية الكافية له. فالطبقة العاملة ضعيفة العدد، ومطالبها لا تبدو سوى إصلاحية في أعين أغلب فئات الشعب العاطلة والمهمشة والمفقرة.. وبالتالي فإنها طبقة لن تقدر أن تشكل بمفردها القاعدة المادية لفعل سياسي منتج للتغيير. وعندما يرنو الفعل السياسي إلى تمثيل الفئات الوسطى والبرجوازية الصغرى فإنه لا يمثل سوى محاولة للإصلاح الفوقي في نظر الطبقة العاملة، ومناورة سياسية في نظر الأغلبية المهمشة خارج الاقتصاد الرسمي. أما عندما تصعد هذه الأغلبية لساحة الاحتجاج والتعبير عن واقعها، فإنها لا تجد أي فعل سياسي يمثلها بجد وفعالية، لأن صعودها لا يبدو في نظر الفاعلين السياسيين داخل الحقل السياسي الرسمي سوى رفض لواقع الأزمة، إن لم يكن عدمية وفوضى.
هكذا فإن الفعل السياسي في المغرب يصعب عليه أن يبلور تمثيلية اجتماعية واضحة وقوية تمكنه من بناء حركة اجتماعية قوية التماسك، وملمة بكل الأبعاد الوطنية والاجتماعية والثقافية للوضع المغربي، لأن الحياة الاجتماعية بالمغرب لا تتهيكل وفق أساس اقتصادي موحد، كما هو الشأن في المجتمعات الصناعية الغربية، وهي بالتالي لا تنتج تشكيلات اجتماعية مندمجة في مصلحة مادية واضحة (إلا في حدود ضيقة) وقادرة على أن تبلور فعلا سياسيا قويا يشكل تعبيرها داخل الحياة السياسية. فإذا أخذنا الطبقة العاملة المغربية مثلا، فإننا نجد داخلها شرائح جاءت من القرى إلى المدن وترى في وضعها كيد عاملة نوعا من الترقي الاجتماعي الفردي، مما يجعلها تضع مسألة ظروف العمل والأجور في درجة ثانوية من اهتماماتها لأن مرجعيتها هي الحياة القاسية في القرية. كما نجد داخل الطبقة العاملة شرائح من العمال متشبعين بثقافة دينية ماضوية وترى في الاقتصاد الرأسمالي نوعا من الانحطاط الحضاري يجب القطع معه والعودة إلى أشكال العمل السابقة. كما نجد شرائح داخلها ترى لظروف العمل والأجور استغلالا رأسماليا يجب التصدي له بواسطة النقابة من أجل تطوير هذه الظروف وتحسينها إيمانا منها بأهمية المجتمع الصناعي في الحضارة الحديثة. كل هذه الشرائح نجدها داخل الطبقة العاملة وقد يكون لها امتداد داخل العمل النقابي المنظم، إلا أن فعلها الاجتماعي لا ينعكس إلا في حدوده كتعبير عن وضعية مشتركة، أما كفعل سياسي تغييري فإنه يبقى ضعيفا ومكبلا بالاختلافات الثقافية والاجتماعية التي تهيكلها.
فاليسار المغربي، بتبنيه خلاصات تحاليل نظرية التبعية الاقتصادية، افترض واقعا اجتماعيا وثقافيا غير موجود كبنى مادية وتاريخية. وشكل على افتراضه هذا تصورا سياسيا ثوريا يميل إلى القطيعة مع الواقع ولا يفكر في الإصلاح السياسي والاجتماعي إلا لماما. وسلم، دون بحث واقعي، بأن وجود اقتصاد عصري تابع مفروض على المجتمع المغربي قادر وحده على خلق ظروف اجتماعية وثقافية رأسمالية، تمكن من ظهور طبقات، وأحزاب، ومثقفين عضويين، كما هو الشأن في المجتمعات الغربية المصنعة، وتجعل، بالتالي، الاختيار الثوري واقعيا، والاشتراكية العلمية ممكنة.
ولعل هذا الافتراض غير الواقعي هو الذي جعل تاريخ اليسار المغربي يمتاز بصفة التناقض بين الوعي والفعل. فبالدرجة التي كان الوعي السياسي، لهذا اليسار، واضحا على المستوى “النظري”، كان فعله السياسي، بالمقابل ضعيفا، ونتائجه دون مستوى التضحيات التي تطلبها. فالفعل الثوري لليسار لم تكن له القاعدة الاجتماعية الكافية المفترضة، داخل المجتمع المغربي المشكل من “تركيبة مزيجة” على حد تعبير بول باسكون. وكان أساسه الواقعي خليطا من فئات اجتماعية ليس لها ما يوحدها سوى أرضية الأزمة الاقتصادية المتعاظمة، وواقع الإقصاء والتهميش السياسيين، الذي كانت تعيشه أمام منظومة سياسية مغلقة، ونهج سلطوي ممركز.
– الصحوة الديمقراطية
هكذا أصبح المجتمع المغربي يعيش وضعا على طرفي النقيض: فهناك أزمة اقتصادية اجتماعية حادة من جانب، لم تستطع السلطة المركزية حلها، وهناك من جانب آخر، ضعف فعل هذا المجتمع لتغيير وضعه وتاريخيته والخروج إلى دينامية جديدة نتيجة تبني اليسار لاستراتيجية ثورية لا تتوفر على أساس اجتماعي يحولها إلى واقع مادي، وهناك من جانب آخر انتشار الوعي الاجتماعي بالأزمة الاقتصادية والسياسية في أوساط عموم الشعب المغربي. هذا الوضع الداخلي (إلى جانب العوامل الخارجية التي يعرفها الجميع)، هو الذي فرض على الفاعلين السياسيين، بما فيهم السلطة المركزية، أن يفكروا في مبادئ جديدة للحياة السياسية تمكن من تحقيق تغيرات على الاقتصاد كما على المجتمع، والخروج من الأزمة التي تهدد الجميع، وخاصة الذين لهم ما يخسرون. وجاءت فكرة الديمقراطية كحل وحيد، وكصحوة جديدة للنخبة السياسية المغربية، تمكن من تجاوز أزمة اندماج اجتماعية تنذر بـ”سكتة قلبية” بتعبير الملك المغفور له الحسن الثاني، للمنظومة السياسية إن هي لم تقبل التحول والانفتاح.
فلا السلطة المركزية قادرة وحدها على تجاوز الأزمة، ولا هي قادرة على الاستمرار بالنهج السلطوي. ولا النخبة السياسية اليسارية قادرة بدورها على تحقيق الفعل الثوري والتغيير الجذري الذي تطمح إليه. وأصبح المجتمع، على نار الأزمة، يمهد لبروز ردود فعل الأصولية الدينية والثقافية التي تنحو في اتجاه وضع مختلف الفاعلين السياسيين في الحقل السياسي الرسمي خارج المشروعية السياسية.
صحيح أن الديمقراطية كاصطلاح لم تخل من الأدبيات السياسية لليسار المغربي، إذ نجد مطلب الانتخابات الحرة والنزيهة، ودور قوي للبرلمان، وتحقيق الحريات العامة والفردية، وإنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي والنفي.. يملأ الخطاب السياسي اليساري المغربي بمختلف تياراته وتنظيماته. إلا أن الديمقراطية التي كان ينادي بها هذا اليسار، لم تكن بما يكفي من الوضوح السياسي والمؤسساتي، من جهة، ولم تكن خيارا استراتيجيا، من جهة ثانية. بل كانت تعتبر محطة نحو الاشتراكية وأداة لها، مما جعلها تكون، في نظر هذا الخطاب، مرادفا آخر للاشتراكية وتحرير المجتمع من قبضة الإمبريالية والتفاوتات الطبقية. الأمر الذي جعل ذكر مصطلح “الديمقراطية” في أدبيات اليسار المغربي غير كاف لوحده، وكان يرفق بتعابير مثل “الحقة”، “الاجتماعية”، “الراديكالية” وذلك لتمييزها عن الديمقراطية في الغرب، التي كان يعتبرها بورجوازية، والتأكيد على أن الديمقراطية التي ينادي بها هي التي تقود إلى التحرير والاشتراكية.
هكذا، إلى جانب “ديمقراطية” السلطة المركزية، التي كانت فارغة من كل محتوى اجتماعي أو قانوني ومن كل واقع مؤسساتي، كان اليسار، في المقابل، ينادي “بديمقراطية” معناها الواقعي هو تحقيق الثورة الاشتراكية.
إن ما نقصده باكتشاف فكرة الديمقراطية، من قبل الفاعلين السياسيين في الحياة السياسية المغربية، هو ذلك الاتفاق المشترك بين كل الفاعلين، ونعني مؤسسة الملك من جهة، واليسار المغربي في أهم مكوناته، من جهة ثانية، على أن الديمقراطية هي القاعدة السياسية الوحيدة التي يجب أن تقوم عليها الحياة السياسية، وأن هذه الديمقراطية لها معنى محدد، سياسيا ومؤسساتيا، ليس هو “المسلسل الديمقراطي” أو “الهامش الديمقراطي”، إلى غير ذلك من التعابير العامة التي سادت الحياة السياسية من قبل، بل هو التناوب على ممارسة السلطة من قبل الأحزاب السياسية، وبواسطة الانتخابات المباشرة، وإعطاء سلطة سياسية فعلية للمؤسسات المنتخبة، وجعل الحكومة منبثقة من البرلمان، وفق منطق الأغلبية، وضمان استقلال الوزارات والمؤسسات والفصل في تخصصاتها.
بهذا انتقل اليسار المغربي منذ بداية العقد الأخير، من تصور الديمقراطية على أنها مطلب ضد المنظومة السياسية المركزية، ولا يتحقق سوى بعد تجاوزها (أي مرادفة للاشتراكية)، إلى تصور الديمقراطية من داخل هذه المنظومة وتبني انفتاحها على كل الفاعلين السياسيين بصرف النظر عن تمثيليتهم الاجتماعية وخلفياتهم السياسية وظروف نشأتهم وأدوارهم الماضية، وبالتالي تحولت الأحزاب “الإدارية” إلى أحزاب “يمينية”. وبالمقابل بدأ الخطاب الرسمي للسلطة المركزية يعترف، سياسيا، بالأحزاب السياسية، ولو تحت تبريرات ليست دائما سياسية (كتحديد أدوارها في تأطير المواطنين وتربيتهم لبناء “مغرب جديد”). وبدأ الحديث عن تعددية سياسية تخترق المجتمع المغربي، ولم يعد الاختلاف مع هذه السلطة المركزية، نوعا من استيراد الأفكار والإيديولوجيات، كما كان في السابق. لقد ظهر هذا الاعتراف من طرف السلطة المركزية، بالأحزاب المعارضة، وبشكل قوي، إثر الانتفاضات الشعبية التي عرفتها عدة مناطق مغربية سنة 1984، حيث راج في خطاب السلطة أن هذه الأحداث تعبر على أن الأحزاب السياسية، خاصة المعارضة، لا تقوم بدورها التأطيري بالشكل الجيد، ولا تنشر “الوعي السياسي” داخل الأوساط الشعبية، لتمؤسس فعلها، وتمنع من ظهور مثل هذه الأفعال “المتوحشة”.
لكن إذا كان اكتشاف اليسار المغربي لفكرة الديمقراطية، جاء نتيجة ظروف سياسية اتسمت بالأساس بعجزه عن بناء قوة اجتماعية قادرة على ترجمة اختياراته الثورية على أرض الواقع المادي، أي بتعبير رجال السياسة اتسمت باختلال موازين القوى هذه، فإن السلطة المركزية اكتشفت هي الأخرى فكرة الديمقراطية، في ظروف فهمت فيها أن امتلاك السلطة وحده، لا يكفي للمحافظة عليها، ويجب بناء قوة جديدة وفق المقتضيات الجديدة للتحولات الدولية واستجابة للتغيرات السوسيو-ثقافية للمجتمع المغربي، وللأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على الاندماج الاجتماعي.
لقد كانت المنظومة الدولية، إبان الحرب الباردة، وحدة الاستقطاب بين الشرق والغرب، إحدى الموارد الأساسية لقوة النهج السلطوي الذي كانت تتبناه السلطة المركزية، كأسلوب سياسي وحيد في التعامل مع المجتمع المغربي. فالهدف الأساسي لهذا النهج كان هو تكريس تبعية الاقتصاد الوطني للأسواق الرأسمالية الغربية، ومنع أي ظهور قوي للفاعلين السياسيين المستقلين عن المركز، والذين في إمكانهم عرقلة هذه التبعية وجعل العلاقة مع المراكز الغربية مضطربة.
إلا أن هذا الدور لم يعد كافيا كي يتمتع النهج السلطوي بمباركة كافية من قبل المراكز الرأسمالية الغربية. إذ مع انتهاء الثنائية القطبية، وسيطرة المنطق الإمبريالي -ما يعبر عنه اليوم بالعولمة- على المنظومة العالمية وضمان القوة التقنية والصناعية، أصبح المورد الخارجي لقوة الأنظمة السياسية الداخلية غير مرهون بالتبعية الاقتصادية وحسب، بل أضيفت له معايير ومبادئ منظمة للحياة السياسية، كالانتخابات، وتوزيع السلطة داخل المجتمع، واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان. مما يكفل ويضمن استمرارية التبعية واستقرار الأسواق الاستهلاكية.
هكذا أصبحت المراكز الرأسمالية تنظر لمشروعية السلطة داخل المجتمعات التابعة لها من خلال توفر شرطين إثنين: شرط إبقاء وتقوية إعادة إنتاج العلاقات الرأسمالية التابعة داخل اقتصادياتها، وشرط التمتع بمشروعية سياسية داخلية تضمن الاستقرار كأساس متين لخلق أسواق لترويج الإنتاج الغربي.
فإذا استحضرنا معطيات الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية، ومعطيات الأزمة السياسية المتمثلة في غياب حركة اجتماعية صاعدة. بالإضافة إلى التحولات الدولية، فإننا سوف نجد أنفسنا أمام عوامل جدلية يتقاطع فيها الدولي بالوطني، الاقتصادي بالسياسي، السلطة المركزية بالمعارضة، لتشكل وضعية تاريخية تأتي فيها فكرة الديمقراطية كضرورة غير قابلة للتأجيل وليس كاختيار، كحل جماعي وليس رغبة المنتصر.
على هذا الأساس، تبنت السلطة المركزية فكرة الديمقراطية، بعد أن اقتنعت أن الداخل، أي الحياة السياسية الوطنية، هي المورد القوي الوحيد لبناء المشروعية السياسية، وأن الحلول الحقيقية للأزمة الاقتصادية تقتضي توازنات اجتماعية جديدة لن تتحقق سوى بتوسيع المشاركة السياسية داخل المنظومة المسيطرة، وجعل هذه الأخيرة معبرة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وجعل القرار السياسي، خاصة مع تراجع اليقينيات والوثوقية، مسؤولية الجميع، سواء في النجاح أو في الفشل.
فعلى عكس المجتمعات الصناعية، التي جاءت فيها الديمقراطية كثمرة للازدهار الاقتصادي والنمو السياسي، وصعود طبقات اجتماعية جديدة، فإن فكرة الديمقراطية في المغرب جاءت نتيجة الأزمة الاقتصادية، والتراجع السياسي لقوى اليسار، وتنامي ضعف السلطة المركزية أمام جماعات الضغط والمصالح الفئوية والنخبوية للأشخاص المسيطرين على دواليب القرار.
إن أي تحليل أو تقييم للتحولات السياسية الراهنة في المغرب يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الجدي الظروف المادية والسياسية لهذه التحولات، لأن مصير أي تحول لا يرتبط فقط برهاناته وأهدافه، بل كذلك بالظروف التاريخية التي يقف عليها وأمامها.
II – أسس الانتقال الديمقراطي:
هذا الوضع التاريخي، المتأزم اقتصاديا وسياسيا، هو الذي يشكل السياق المادي للانتقال الديمقراطي الحالي، وهو المرجعية المشتركة التي فرضت نفسها، بأشكال متفاوتة، على مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، أثناء بحثهم عن صياغات جديدة لوجودهم، وبلورة رهانات جديدة لفعلهم. إنها المرجعية التي شكلت الإكراه الموضوعي، العام، إزاء كل فعل سياسي داخل الحياة السياسية والاجتماعية المغربية، وأملت عليه بهذا الشكل أو ذاك أن يتخلى عن ادعائه بامتلاك ناصية الحقيقة. والاعتراف بدورها، وبهذا القدر أو ذاك، بالآخر كطرف موضوعي، وكإسهام لا غنى عنه في مقومات الحل. إن الأزمة المجتمعية التي عرفها المجتمع المغربي، على الأقل منذ بداية العقد الأخير، وما رافقها من تحولات سياسية واقتصادية دولية، كانت هي العامل الأساسي في دخول الحياة السياسية المغربية إلى مرحلة جديدة، سمتها الأساسية هي الاعتراف المتبادل بين الفاعلين السياسيين داخل المجتمع، وما ينطوي عليه هذا الاعتراف من إدخال النسبية على الخطاب، واعتماد أسلوب سياسي يسعى إلى تحقيق ما هو ملائم وليس ما هو حقيقة. بتعبير آخر، يمكن القول إن هذه الأزمة المجتمعية، والتي بينا على أنها أزمة في الواقع كما في الفعل، فرضت على الفاعلين السياسيين داخل الحياة السياسية المغربية أن يتمثلوا السياسة على أنها حوار مع الآخر، ومساهمة إلى جانبه، وليس فرض حقائق عليه وقطيعة معه، وجعلها نشاطا حواريا على حد تعبير J.Habermas على خلفية سياق مادي مشترك بين الأطراف ومعترف به ومتفق على عناصره الأساسية. هكذا عرف الحقل السياسي، ولربما لأول مرة، تحالفات سياسية بين الأحزاب وتكتلات للفاعلين الاجتماعيين، وتنظيمات للفاعلين الاقتصاديين خارج سيطرة السلطة المركزية. كما خرج الخطاب السياسي للفاعلين من وثوقيته المزعومة، وبدأ يتخلى عن ادعاء البطولة والخلاص، والإقرار بهذا الشكل أو ذاك، بعدم احتكاره قيم المجتمع والوطنية. كما أن تقرير وجود أزمة اقتصادية واجتماعية داخل المجتمع المغربي لم يعد من مهام اليسار وحده، إذ أصبح الخطاب الرسمي، في مختلف درجاته، لا يدع مناسبة تمر دون أن يؤكد على وجودها وضرورة إيجاد حلول لتجازها.
من السلطوية إلى الديمقراطية:
هكذا تحول السؤال، داخل الحياة السياسية المغربية، من سؤال حول هل هناك أزمة أم لا، ومن المسؤول عنها؟ إلى سؤال حول كيفية تحقيق صياغة جماعية لحياة سياسية تمكن الجميع من المساهمة في الخروج من الأزمة؟ وهو السؤال الذي يتضمن، من بين ما يتضمنه، الاعتراف المتبادل بين الفاعلين، بصرف النظر عن نشأتهم وتاريخهم، ووفق قواعد ومعايير مبنية داخل سياق هذا الاعتراف، أي مبنية داخل الحوار بين الفاعلين والاحتكام إلى المرجعية المشتركة، التي هي السياق المادي للحوار، أي الأزمة المجتمعية، وغلى خطاب حجاجي (argumenté) عقلاني، أي “قادر على فرز اتفاق وخلق تراض”.
لكن قبل الاستمرار في التحليل، يجب أن نتجنب سوء الفهم الذي يهدده. يتعلق الأمر بأمرين اثنين: الأول هو عندما نقول إن الحياة السياسية المغربية دخلت، مع احتداد الأزمة المجتمعية، مرحلة الحوار والاعتراف المتبادل بين مختلف الفاعلين السياسيين داخل الحقل السياسي الرسمي. ولا يجب أن تخدعنا كلمة “حوار” ونعتقد أنها مؤشر على وضعية سياسية ديمقراطية مثلى. بل إنه سلوك سياسي يعكس وضعية التفاوتات في القوة والتأثير، بين الفاعلين السياسيين، ويعبر عن مستوى معين من جدلية الصراع. وبذلك، فإن الإقرار بخاصية الحوار التي طبعت الحياة السياسية المغربية في العقد الأخير لا يحمل أي حكم قيمة، ولا أي معنى أخلاقي.
الأمر الثاني، هو أننا نميز بين حوار الفاعلين السياسيين، وما قد يفرزه من نتائج، وبين عملية تطبيقه على أرض الواقع الاجتماعي. لأن هذه الأخيرة تخضع لجدلية اجتماعية وسياسية غير الجدلية التي دفعت بالفاعلين لمائدة الحوار، وبالتالي فإن تطبيق مقتضيات الحوار ونتائجه لا تكون تلقائية وبشكل آلي، بل تخضع لسيرورة لا تخلو من نزاع. كما أن محدودية هذا التطبيق ونسبيته لا تسمح بالتقليل من أهمية الحوار، في حد ذاته، أثناء تحليل ومحاولة فهم الحياة السياسية المغربية، في سيرورتها ومستجداتها.
إلا أن من أهم نتائج هذه الوضعية السياسية الجديدة، والتي يمكن أن نسميها بـ”الوضعية الحوارية”(communicationnel)، التغيير الذي أصاب “طبيعة” السلطة السياسية داخل الحياة السياسية المغربية، وانتقالها من نمط إلى آخر.
لقد ظلت السلطة السياسية بالمغرب، منذ الاستقلال، قائمة على النمط السلطوي (autoritaire)، الذي يبني علاقة الدولة بالمجتمع على أساس السيطرة على كل مرافق الحياة العامة، والتحكم في كل السيرورات الاقتصادية والاجتماعية، ومراقبة كل آليات الدينامية التي تعتمدها المنظومة الاجتماعية والثقافية، والحفاظ على مركزة قوية للحياة السياسية وفصلها عن كل تأثيرات العلاقات الاجتماعية. فمع هذا النمط، لم تكن الدولة المغربية تسير الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتخضع لتحولاتها ونزاعاتها، بل كانت تعمل كل شيء من أجل السيطرة عليها وإخضاعها للمركز السياسي، عبر توجيه ومراقبة والتحكم في كل الميكانيزمات المادية والرمزية.
لا نعتقد أن مفهوم السيطرة الفبيري (la domination) ملائم لدراسة السلطة السياسية بالمغرب، كما شاع اعتماده في الكتابات السياسية حول الحياة السياسية المغربية. وذلك لسبب بسيط نوجزه كالتالي: يعني مفهوم السيطرة، عند ماكس فيبر الذي يعتمد في هذه الكتابات، ومن خلال دراسته لأنماط السيطرة، أن “الدولة تتشكل من علاقة سيطرة الإنسان على الإنسان، مؤسسة على احتكار العنف المشروع، بمعنى على عنف مأخوذ على أنه مشروع”، وبالتالي فإن مفهوم الدولة عند فيبر كان قائما على افتراض أنها “مشتقة من الممارسات الاجتماعية التي تتموقع في فضاء وفي زمن. كما تتموقع داخل مسار وبالعلاقات مع ثقافات تعطي للدولة معناها”. بتعبير آخر، يتعلق الأمر مع فيبر، “بإدراك النظام الدولتي، كفرد تاريخي ينبثق من مجموعة من الأفعال الاجتماعية الدالة”. هكذا فإن مفهوم السيطرة الفبيري قام داخل سيرورة أساسها الاندماج السوسيو-ثقافي داخل المجتمعات الغربية الحديثة، أو المجتمعات غير الغربية القديمة. وهو الأساس الذي جعل الدولة فيها تسمى بـ”الدولة المنبثقة”.
تختلف السلطة في الواقع التاريخي للمجتمع المغربي عن السلطة في المجتمعات الغربية تمام الاختلاف. ليس فقط لأن الدولة في المغرب، كما في الدول التابعة، تعد “دولة مستوردة”. بل كذلك، وأساسا، لأن الاندماج السوسيو-ثقافي ليس حركة موضوعية في الواقع المادي للحياة العامة للمجتمع المغربي، بفعل طبيعة تشكل السيرورات الاجتماعية والاقتصادية التي أدخلها الاستعمار من جهة، وبفعل خصوصية منظومة اللامساواة والسيطرة التي تخلقها التبعية الاقتصادية للمراكز الرأسمالية، داخل المجتمع، وتحافظ على إعادة إنتاجها الفئات الكومبرادورية المسيطرة من جهة ثانية.
فالسيرورات الاجتماعية والاقتصادية لم تقم على قطائع تاريخية، كما هو الشأن مع البلاد الرأسمالية في الغرب المصنع، وبالتالي بقيت السيرورات التقليدية تتمتع بتأثيرات قوية وإن داخل سياق اقتصادي جديد، كما نجد أن منظومة اللامساواة والسيطرة، قائمة هي الأخرى، وبفعل سيطرة اقتصاد خارجي التطور، على تركيبة غير منسجمة على أساس اقتصادي. بمعنى إنها منظومة قائمة على علاقات اللاتمفصل بين الحياة الاقتصادية، والحياة الثقافية والاجتماعية. لذلك من الصعب وجود نشاط اقتصادي يشكل المورد المركزي للحياة المادية للمجتمع المغربي، والبنية التحتية الموحدة لعلاقاته الاجتماعية.
هكذا، فإن الاندماج السوسيو-ثقافي داخل المجتمع المغربي، هو دائما بناء سياسي، وليس وليد حركية موضوعية. إنه ناجم عن تدخل إرادي للدولة السياسية، وليس عن علاقات اجتماعية متمركزة حول نمط معين للإنتاج. مما يجعل استعمال مفهوم السيطرة الفيبري الذي يرى “الخضوع يتأسس على اعتراف الخاضعين بالقوانين المعطاة لهم”، في تحليل الحياة السياسية المغربية، لا يعدو سوى إعادة إنتاج لخطاب السلطة، وتفكير في واقع الدولة، من داخل فكر الدولة نفسها، لأنه مفهوم لا يشير إلى ميكانيزمات العنف والإكراه التي تفرض هذا الاعتراف. كما أن استعمال مفهوم “نمط الإنتاج” لتحليل هذه الحياة، لا يعدو هو الآخر، أن يكون سوى هروب من خصوصيات الواقع الاجتماعي المغربي.
بناء على هذا، نعتقد أن مفهوم “نمط السيطرة السلطوي”، كما سنرى، هو المفهوم القادر على فهم “طبيعة” السلطة السياسية التي سادت منذ الاستقلال. فرغم أنه مفهوم ينتمي لحقل العلوم السياسية، ويمكن أن يحمل معه عيوبها، في دراسة المجتمع، والمتمثلة بالأساس في رؤية هذا الأخير، من فوق فقط، أي من خلال مؤسساته وتنظيماته المسيطرة، فإنه أكثر المفاهيم ملاءمة للوضع المغربي، حيث تشكل السياسة فيه، باعتباره مجتمعات تابعا وغير مصنع، (حتى لا نقول انقساميا كما عبر G.Balandie)، اللحمة التي تلم مختلف الأجزاء والأطراف المشكلة لمنظومته، وليس الاقتصاد كما هو في المجتمعات الرأسمالية المصنعة، وكما بينت دراسات كارل ماركس. إن الفرق بين مفهوم السيطرة الفيبري ومفهوم نمط السيطرة السلطوي الذي نأخذ به هنا هو أن الأول يوحي بأن علاقات السيطرة والخضوع هي طبيعية ناجمة عن “خط العثور على أفراد محددين مستعدين للخضوع للنظام له مضمون محدد”. كما أنها، أي علاقات السيطرة والخضوع، علاقات قائمة على اعتقادات ثابتة في مشروعية هذه السيطرة. فلا يكفي في نظر فيبر لتحقيق السيطرة الاعتماد على التقاليد أو المصالح أو التحالفات مهما كانت عاطفية أو عقلانية. بل يجب إضافة عامل حاسم هو الاعتقاد في مشروعية هذه السيطرة.
هكذا نجد السيطرة عند فيبر قائمة على الاقتناع أكثر مما هي قائمة على العنف. والأخذ بهذا المفهوم الفيبري، يمنع من رؤية واقع السلطة كروابط اجتماعية وليست كماهية. روابط تمارس فيها قوة المسيطرين من خلال السيطرة على العلاقات الاجتماعية التي تلعب دور البنية التحتية داخل المجتمع، وهيكلية الحقل الاجتماعي لتدخل الفاعلين السياسيين المسيطرة عليهم.
أما مفهوم نمط السيطرة السلطوي، على الرغم من رؤيته المجتمع من فوق، فإنه يشير إلى مبدأ الفرض الذي تقوم عليه السلطة داخل المجتمع، باعتبارها علاقات قوة متحققة عبر السيطرة على المؤسسات والتنظيمات التي “تنهض بوظائف التحكم في امتلاك ومراقبة وسائل الإنتاج والمنتوج الاجتماعي للجماعات والأفراد الذين يشكلون نمطا محددا من المجتمع والتي تنظم سير الإنتاج وتوزيع المنتوجات”.
فمن خلال التعريف الذي سنورده لنمط السيطرة السلطوي، سوف يتضح كيف أن السيطرة هي “التحكم في العلاقات الاجتماعية التي تشتغل في نفس الوقت كعلاقات للإنتاج وتشكل الهيكل الاجتماعي للقاعدة المادية للمجتمع”. وهي العلاقات التي نجدها تتجسد داخل المجتمع المغربي في العلاقات السياسية. فطبيعة التشكل الاجتماعي للواقع المغربي، كما أشرنا فيما سبق، تجعل العلاقات السياسية تلعب دور البنية التحتية، والعامل الموحد والمحدد لكل العلاقات الاجتماعية الأخرى. فاحتكار مراقبة العلاقات السياسية داخل المجتمع المغربي، بما لها من دور حاسم، هو الذي يملي على السلطة المركزية تبني النمط السلطوي في السيطرة على المجتمع. بمعنى ليست وحدة الاعتقاد في مشروعية ما الذي يفرز الاستعداد الطبيعي للخضوع هو الذي يفرز نمط السيطرة داخل المجتمع المغربي. بل إن أهمية ومكانة العلاقات السياسية داخل المجتمع المغربي، كمجتمع غير مصنع وتابع، من جهة، وطبيعة الظروف الدولية إبان الحرب الباردة من جهة ثانية، هما اللتان منحتا للسلطة المركزية إمكانية تبني النمط السلطوي في السيطرة.
يعرف الباحثون في العلوم السياسية النمط السلطوي للسلطة بأنه “يشير إلى علاقة بين الحاكم والمحكوم قائمة في أغلب الأحيان على العنف أكثر مما هي قائمة على الاقتناع. إنه أيضا، علاقة سياسية تكون فيها تعبئة المسيرين إتقائية وغير خاضعة للمنافسة الانتخابية بين المترشحين للمسؤولية العمومية”. إنه “سلطة الدولة المكثفة في يد أفراد أو جماعات يهتمون قبل كل شيء بتحصين مصيرهم من احتمالات لعب تنافسي لا يراقبونه كاملا”.
فعلى مستوى المؤسسات والتنظيمات القانونية، فإن النمط السلطوي للسلطة، يعتمد “توازنا بين التراتبيات المؤسساتية القانونية ويتحكم فيها من المركز”، كما أنه “لا يعتمد على إيديولوجية مسيرة ولا على تعبئة مكثفة أو واسعة إلا في بعض فترات تطوره”. ثم إن الأحزاب السياسية لا تنعدم تحت سيطرة هذا النمط من السلطة. إلا أنها دون سلطة سياسية. ذلك أن “الأنظمة السلطوية هي منظومات تتوفر على تعددية محدودة، لكنها تعددية غير مسؤولة”. نفس التعامل نجده مع الحريات العامة. فالنمط السلطوي “يقمع الحريات السياسية دون أن ينازع في واقع التعبيرات المتنوعة لاستقلالية المجتمع”. إنه نمط “ينطوي على حصر الحرية لكنه لا يلغيها تماما”.
أما على مستوى المؤسسات السياسية، فإن الأنظمة السلطوية تكون “قائمة في أغلب الأحيان على العنف، أكثر مما هي قائمة على الاقتناع”، والـ”علاقة السياسية.. غير خاضعة للمنافسة الانتخابية بين المترشحين للمسؤولية العمومية”، فإن المؤسسات السياسية (برلمان، جماعات محلية، مجالس إدارية..) لا تتمتع بسلطة فعلية على أرض الواقع السياسي. أما فيما يخص الانتخابات السياسية، فإن الأنظمة السلطوية، ما دامت فيها “سلطة الدولة مكثفة في يد أفراد أو جماعات، يهتمون قبل كل شيء بتحصين مصيرهم من احتمالات لعب تنافسي لا يراقبونه كاملا”. كما سبقت الإشارة في تعريف النمط السلطوي للسلطة، فإن التدخل في تزوير نتائج صناديق الاقتراع يبقى عملا ضروريا وأمرا حيويا في استراتيجياتها.
واضح أن هذه الخصائص متوفرة بقوة في نمط السلطة السياسية المسيطرة داخل المجتمع المغربي. ولا نعتقد أن هناك صعوبة في إلتقاط مظاهرها وتجلياتها في الواقع السياسي لهذه السلطة. إن حضور هذه الخصائص في العلاقات السياسية المسيطرة على الحقل السياسي الرسمي، هي التي مكنت السلطة المركزية من التمتع بقدر لا بأس به من الإمكانيات لأن تضفي على نفسها صبغة “قانونية” و”ديمقراطية” عندما يتعلق الأمر بتبني خطاب الحداثة. وأن تضفي على نفسها صبغة التقليد والأصالة عندما يتعلق الأمر بتبني خطاب الثقافة المحلية، كما مكنها من احتواء مجموعة من التحولات السياسية الإقليمية والدولية، وحشد أسلوب سياسي براغماتي فعال في إدارتها. ولعل هذا الواقع السياسي للسلطة المركزية هو الذي يجعل الاختلاف طاغيا إزاء تحديد مفهوم موحد حول نمط السلطة السياسية السائدة بالمغرب، وجعل لغة اليسار السياسية في هذا الصدد لا تتمتع بالوضوح الكافي (نظام لا ديمقراطي، نظام لا شعبي..).
إن الطابع المميز لخصائص النمط السلطوي للسيطرة، كما هي مذكورة في دراسة Guy Hermet المشار إليها، هو كونها تضع السلطة السياسية في موضع وسط بين مختلف أنماط السيطرة السياسية الواضحة (نمط كلياني، نمط استبدادي، نمط ديمقراطي..).
لقد كرست السلطة المركزية بالمغرب، طيلة الأربعين سنة الماضية، التعامل مع المؤسسات والتنظيمات كمجالات للحظوة والامتيازات في يد عناصر النخبة المغربية الموالية لها سياسيا. فإلى جانب سيطرة وزارة الداخلية على كل المؤسسات والتنظيمات المغربية واعتبارها ملحقات لها، فإن هذه الأخيرة كانت تحت سيطرة شخصيات تعتبر نفسها فوق القانون وتتصرف كما لو أنها تتصرف في ضيعاتها، شريطة أن توثق علاقات الولاء بالسلطة المركزية.
أما إذا قرأنا العلاقات التراتبية بين مختلف التنظيمات والمؤسسات داخل المجتمع المغربي، فإننا نجدها هرمية ولا تفاعل حقيقي بينها. فالسلطة المركزية تقف على رأس هذا الهرم لتتساوى كل المؤسسات والتنظيمات داخل المجتمع المغربي كأدوات لتطبيق القانون والتسيير الإداري للحياة العامة للمواطن. كما أن الوصول إلى مراكز ومواقع ومناصب داخلها يتم بآليات غير قانونية ولا ديمقراطية، أي بثنائية الفساد-الزبونية. إن خلق وإنشاء مؤسسات وتنظيمات كان في الغالب يتم استجابة لتضخم حجم النخبة المغربية في مختلف المجالات، أكثر مما كان استجابة لحاجة اجتماعية وسياية تاريخية للمجتمع المغربي. وبالتالي كانت السلطة المركزية تستعمل المناصب الإدارية كآلية لبناء المجال العمومي وفق سيطرتها ومصالحها، ومن أجل التحكم في الدينامية الاجتماعية ومنع تأثيرها على القرار السياسي.
أما على المستوى الإيديولوجي، فإن السلطة المركزية لم تكن لها منظومة إيديولوجية، تعبئ بها المجتمع داخل مشروع مجتمعي تنموي. ليس لأنها غير قادرة، بل لأنها لم تكن تتوفر على مشروع تنموي معين. وبالتالي كانت تعتمد على حشد التأييد لها إما من خلال إفراغ الحياة السياسية من فاعلين معارضين وقمع الحريات السياسية، أو إفساد عناصر النخب السياسية المسيطرة على التنظيمات السياسية العاملة في الحقل السياسي الرسمي.
ولم تعرف الحياة السياسية الرسمية في المغرب أي فترة انعدمت فيها مؤسسات سياسية. فرغم احتداد الصراع السياسي على السلطة في مرحلة أواخر الستينات وبداية السبعينات، ظلت المؤسسات السياسية دون أن تحل، واستعملت لتعزيز وشرعنة مواقف وقرارات (كالحكم بالإعدام على أصحاب انقلاب الصخيرات)، إلا أن وجود هذه المؤسسات السياسية في الحياة السياسية المغربية لم يكن له أي أثر على القرار السياسي المركزي. ولم تكن لها أية سلطة فعلية تعكس دينامية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية للواقع المغربي. الأمر الذي جعل الأحداث السياسية التي عرفها هذا الأخير، لا تصل مداها المنطقي، وبقي الثبات دائما الخاصية الأساسية للحياة السياسية المغربية، كما لاحظ واتربوري.
نفس التعامل كان يتم اعتماده مع التعددية السياسية والحريات العامة داخل المجتمع المغربي. فالمغرب لم يعرف حكم الحزب الواحد كما عرفته بلدان عربية أخرى. لكنه لم يعرف، قبل مجيء حكومة السيد اليوسفي، حياة سياسية تحملت فيها الأحزاب والتنظيمات السياسية مسؤوليات عمومية. والحريات العامة بقيت في حدود ضيقة ولم تسمح لها السلطة المركزية بأن تؤثر على القرار السياسي وتنعكس على المنظومة السياسية المسيطرة. ولعل أهم تضييق مارسته السلطة المركزية على الحريات العامة بالمغرب، تمثل بالأساس في التدخل الممنهج لتزوير وإفساد كل الانتخابات التي عرفتها الحياة السياسية المغربية، لضمان انفراد مريح بالقرار السياسي وقطع الطريق على أية تعددية حقيقية.
هكذا عكست الحياة السياسية المغربية مختلف خاصيات النمط السلطوي للسيطرة، وهو النمط الذي تبنته السلطة المركزية منذ الاستقلال. إن تحديدنا لهذا النمط يمكننا من بناء تصور سياسي حول التحولات التي يعرفها المغرب منذ مطلع التسعينات، والتساؤل حول أسسها وتجلياتها. وهي التحولات التي جاءت حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي لتشكل عنوانها الكبير.
التراضي الواضح والتوافق الهش:
لقد انبنت التجربة السياسية التي يعيشها المغرب حاليا على أساسين اثنين، أعطيا للحياة السياسية سيرورة مختلفة، وأدخلا الفاعلين السياسيين لمرحلة جديدة، تمس هويتهم الاجتماعية، كما تمس أدوارهم التاريخية، ووسعا مجال الفعل السياسي، وغيرا معاييره الأخلاقية والمادية، هذان الأساسان هما أساس التراضي وأساس التوافق.
وإذا كان الخلط بينها شائع في الخطاب السياسي المغربي، رغم تمتعهما بتمييز واضح، وأهمية متفاوتة، فإن الوقوف عند تعريفهما أمر يكتسي أهمية قصوى.
نتكلم عن التراضي (Consensus) عندما يتعلق الأمر بـ”معايير تعبر عن مصالح قابلة لأن تعمم (des intérêts universalisables)” على جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين داخل المجتمع. بمعنى أن التراضي يتم حول المعايير المركزية، والتوجهات الثقافية الأساسية التي سوف تشكل المرجعية التاريخية التي توحد الفاعلين المتنازعين. إلا أن هذه المعايير ليست مفروضة من قبل أحد الفاعلين. بل منبثقة من “نقاش يمكن فهمه كشكل لتواصل استخلص من التجربة ومستمد من الفعل حيث [ تكون ] بنيته [أي النقاش ] تضمن أن لا يكون موضوع نقاش سوى الادعاءات الشرعية أو حسب الحالة، الإنظارات والنصائح، المبنية بالإثبات. من هنا فإن التراضي عندما يتأسس على تبريرات مقترحة بطريقة افتراضية وتقبل البدائل فإن هذا التراضي يعبر عن إرادة عقلانية. إن الإرادة المشكلة بالنقاش يمكن أن نسميها عقلانية، لأن الخصائص الشكلية للنقاش ووضعية التشاور تضمن بشكل كاف أن لا يظهر تراضي ما إلا على مصالح قابلة للتعميم (Universalisable) مؤولة بشكل ملائم، أعني الحاجيات موزعة بشكل حواري (Communicationnelle)”.
هكذا فإن التراضي يقوم حول المبادئ والمعايير التي توحد المتنازعين. إلا أن هذهالمبادئ والمعايير ليس مفروضة، بل وليدة اتفاق بين فاعلين متنازعين توصلا إليه عبر نقاش عقلاني يعتمد الحجة وتبادل البراهين داخل وضعية معينة، نقاش يضمن في بنيته “أن يكون المشاركون والمواضيع والمساهمات غير محصورة.. وأن أي إكراه لا يمارس خارج إكراه الحجة الجيدة، وبالتالي، فإن التعاليل الأخرى غير تلك المرتبطة بالبحث المشترك عن الحقيقة، هي تعاليل مقصية”.
إن المجتمع “ليس فقط جماعة للإنتاج، ولكنه جماعة لها حاجيات الاندماج الاجتماعية والحفاظ على قيمها الثقافية، بالقدر الذي لها حاجيات الإنتاج. بتعبير ملموس لها حاجيات يكون فيها للتربية والعدالة نفس أهمية الاقتصاد والسياسية”.
أما التوافق Compromis فهو “التوازن حسب معايير بين مصالح خاصة، شريطة أن يكون هناك توازن بين سلطات الأطراف المعنية. الفصل بين السلطات هو مبدأ للتنظيم موجه لضمان توازن سلطات هذه الأطراف في مختلف مجالات المصالح الخاصة، وبالتالي جعل التوافق ممكنا”. إن التوافق بهذا المعنى، يمكن من الجمع بين ممارسة النزاع بين الفاعلين المختلفين في المصالح والإطار الاجتماعي الذي يشكل وحدتهم –غالبا ما يأخذ شكلا قانونيا- ويضع حدودا معينة للنزاع.
وليكون التوافق حقيقيا ومضمون النجاح، يشترط هابرماس شرطين أساسيين: أن يكون هناك “توازن السلط بين الأطراف المعنية، ثم أن تكون المصالح التي تشكل موضوع هذا التفاوض خاصة وغير قابلة لأن تعمم”.
هكذا وبناء على تعريف كل من مفهومي التراضي والتوافق، والتمييز بينهما، يمكننا أن نتساءل عن أسس التجربة السياسية التي تعرفها الحياة السياسية المغربية منذ تشكيل حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي.
قام التراضي في هذه التجربة على قطبين أساسيين في الحياة السياسية المغربية: قطب مؤسسة الملك، من جهة، وقطب النخبة الوطنية اليسارية من جهة ثانية. ومضمونه، باختصار، هو تجديد اعتراف هذه النخبة بشرعية مؤسسة الملك، داخل الحياة السياسية، مقابل أن تلعب هذه المؤسسة، معززة بمكانتها السياسة، أدوارا في فتح سيرورة تحديث الاقتصاد والمجتمع، وبالشكل الذي يمكن، من القضاء على المشاكل، التي تحد من الاندماج الاجتماعي، وتوسع البطالة والفقر والتهميش والفساد الإداري…
ولقد مكن هذا التراضي النخبة السياسية اليسارية من طرح ضرورة الإصلاح الشامل للمجتمع المغربي، بشكل قوي وواضح، لم يسبق له مثيل في تاريخها. ومكنها من إعادة بناء المشروعية السياسية، بناء حديثا، وبمعايير مؤسساتية وتنظيمية (قوانين تنظيمية، إدارة، اقتصاد، عدل، حقوق الإنسان..). بتعبير آخر، لقد تمكن اليسار، بفعل هذا التراضي، من أن يعيد بناء مشروعية السلطة على مبادئ جديدة، إذ تم تأويل مشروعية مؤسسة الملك بمبادئ الحداثة والعقلانية والتنمية، لتدخل الحياة السياسية المغربية، وإن بشكل غير مكتمل وغامض بحكم المرحلة الانتقالية، مرحلة الشرعية العقلانية، بالمعنى المادي لمفهوم العقلانية (حيث السلطة تقوم على مصالح مبررة بوسائل العقل والحجة المتبادلة). فالتراضي قائم حول قواعد وآليات ومعايير للسلطة السياسية المشروعة، تصب كلها في النمط الديمقراطي للسلطة، كمؤسسات منتخبة من قبل المواطنين، وقانون واحد يسري على الجميع دون استثناء، وتوزيع للسلط والاختصاصات، واحترام القوانين العامة والحريات الأساسية. إنه يعبر عن مصلحة الجميع، أو قابل لأن يكون في مصلحة الجميع. فمضمون التراضي هو “إرادة عقلانية” بمفهوم هابرماس، ولدت نتيجة تأويل معين للحاجيات، كانت هي نفسها منبثقة من خطاب حواري يعتمد الحجة والدليل والتبرير العقلاني حسب مفهوم هابرماس الذي بيناه سابقا.
فإذا كان الإقرار بشرعية مؤسسة الملك شيئا غير جديد على الحياة السياسية المغربية، فإن الجديد هو المضمون الديمقراطي للتراضي بين مؤسسة الملك واليسار، والذي يتمثل في إقرار الطرفين بأن المعايير الصالحة للمغرب، اليوم، هي معايير الفعالية والعقلانية والتنمية، عبر آليات سياسة موحدة، هي الآليات الديمقراطية، وهي المعايير والآليات القادرة على أن تلبي مصالح جميع الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. “إنها معايير تعبر عن مصالح قابلة للتعميم” بتعبير هابرماس، وتؤسس لتراض عقلاني–مادي جديد يقوم على ضمانات اجتماعية واقتصادية وسياسية، أي دنيوية، وليست على ضمانات فوق-اجتماعية، كما كان الأمر في السابق.
فإذا كانت ثمة ضرورة لاستعمال مفهوم المشروعية في تحليل الحياة السياسية المغربية، فإنها تبدأ مع التحولات الاجتماعية والسياسية التي جاءت بحكومة السيد اليوسفي للسلطة، وليس قبلها. لأن مع هذه التحولات، وتجسدها في تراض جديد بين الفاعلين التاريخيين للمجتمع المغربي، لم تعد السلطة السياسية سيطرة على المجتمع، بل مشروعية يعطيها المجتمع ويؤسسها الفاعلون السياسيون عبر معايير ومبادئ عقلانية، أي تشكلت من خلال الحوار والنقاش والحجة كذلك، وهي قادرة على أن تضمن مصالح الجميع وتنظم الحياة السياسية في ظرفية معينة.
هكذا يكون التحول التاريخي الذي جاءت به الحياة السياسية المغربية، مع التسعينات، هو الانتقال من نمط للسيطرة في السلطة السياسية، هو النمط السلطوي، إلى نمط السيطرة الديمقراطي القائم على عقلانية مادية تنهض على مصالح مادية-اجتماعية واقتصادية متبادلة ومعترف بها ومشكلة في سياق عقلاني حجاجي بين الفاعلين. وإذ نؤكد على هذا التحول، نشير مرة أخرى إلى أنه تأكيد لا يحمل أي حكم قيمة، أو أي حكم أخلاقي. أي أن عملية احترامه وتطبيقه على أرض الواقع الاجتماعي تخضع لسيرورة جدلية لا يجب خلطها مع سيرورة تشكله وبنائه.
ويجد هذا التراضي، أو لنقل هذا التأويل العام الجديد للمنظومة المعيارية السياسية المسيطرة، أساسه الاجتماعي على مستويين اثنين: مستوى سيرورة تشكل الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي، بفعل الظاهرة الاستعمارية والتبعية الاقتصادية التي تهيكل بناه المادية وتشكل ملامحه الاقتصادية والسياسية وتجعل فعله السياسي مشلولا خارج وسائط التقليد، ودون إنتاجية إذا لم يعتمد على تحريك الماضي؛ ثم مستوى سيرورة تشكل الوعي السياسي والاجتماعي للنخبة الوطنية المسيطرة على اليسار المغربي، والتي نمت في ظروف تاريخية، وترعرعت في مناخ سياسي كانت الديمقراطية فيهما منسية بفعل تزاحم فكرتين داخل الوعي السياسي السائد هما: الوطنية والاشتراكية.
وإذا كان التراضي في التجربة السياسية الحالية للمغرب، كما بينا، تجلى في اتفاق الفاعلين التاريخيين للمجتمع المغربي حول الجمع بين المؤسسة الملكية والنظام الديمقراطي للحياة السياسية المغربية في بنية معيارية تكون هي الموحدة للمجتمع المغربي وتضمن مصالح كل المواطنين المغاربة على مختلف مواقعهم الاجتماعية وانتماءاتهم الثقافية، فإن التوافق سيكون بين الفاعلين السياسين المتنازعين حول السيطرة على هذه الوحدة المتراضى حولها، واستعمالها وفق مصالحهم الاجتماعية الخاصة، دون خرق قواعدها وأخلاقها ومعاييرها، أو احتكار الاستفادة منها، وحرمان الطرف الآخر.
إن التوافق في التحولات السياسية الحالية هو إزاء آليات قواعد الوصول إلى السلطة والتناوب على السيطرة على دواليب القرار السياسي. فالمتنازعين السياسيين والاجتماعين داخل الحياة السياسية المغربية لهم مصالح متناقضة ومختلفة في كافة الميادين، ويسعى كل واحد منهم إلى تغليب قوته ونفوذه لتحقيق مصالحه الخاصة، كطرف اجتماعي واقتصادي داخل المجتمع. ويعتبر هذا السعي لتغليب مصلحة قوة اجتماعية على أخرى مشروعا عندما يحترم القواعد الديمقراطية والمؤسسات الدستورية المتراضى عنها من قبل الجميع، باعتبارها الوسائل والأدوات السياسية الوحيدة المشروعة داخل الحياة السياسية المغربية. والطريقة السياسية الديمقراطية والمؤسساتية في الوصول إلى السلطة هي موضوع التوافق الجاري حاليا بين الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والفاعلين الاقتصاديين دخل المجتمع المغربي. فالتراضي يتمثل في أن السلطة المشروعية هي سلطة المؤسسات والقانون والحريات العامة. والتوافق يتمثل في الاعتقاد بأن الوصول إلى هذه السلطة، لتحقيق مصالح اجتماعية واقتصادية، لأي جهة اجتماعية لا يتم إلا بأصوات الناخبين واحترام إرادة المواطن المغربي وحقوقه المدنية والاجتماعية وتطبيق حقيقي للقوانين.
إلا أن التوافق المغربي الحالي هو قريب من شبه توافق، على أن يكون توافقا حقيقيا وواقعيا. فإذا كان التراضي الذي تحدثنا عنه يقوم بين طرفين لهما قوة سياسية ومكانة بارزة تاريخيا في الحياة السياسية، فإن التوافق الحالي توافق بين طرفين غير متساويين على مستوى القوة السياسية والدور التاريخي داخل المجتمع، مما يضفي عليه صفة شبه توافق، ويفقده الفعالية الواقعية.
إنه توافق بين طرفين مختلفين في الطبيعة السياسية: طرف يشكل النخبة السياسية الوطنية اليسارية وطرف يشكل النخبة الإدارية الدولتية (أي التي نشأت وترعرعت بفضل دعم الدولة المركزية).
يشترط هابرماس كما بينا سابقا شرطين اثنين لكي يكون التوافق حقيقيا: الأول هو التوازن في السلطة بين الطرفين المعنيين، والثاني هو الخاصية غير العامة للمصالح التي تشكل موضوع التفاوض.
وإذا كان الشرط الثاني متوفرا في التوافق الحالي بين النخبتين، على افتراض أن النخبة الإدارية الدولتية “تمثل” أو أريد لها أن تمثل مصالح خاصة بفئات اجتماعية مسيطرة، وأن النخبة السياسية الوطنية اليسارية ينتظر منها أن تمثل مصالح خاصة بفئات اجتماعية شعبية، فإن الشرط الأول من الصعب إقراره، لأن النخبة الإدارية الدولتية عملت طيلة إقحامها للحياة السياسية على استعمال السلطة العمومية لفائدتها الخاصة. وبالتالي فإنها تفتقد للسلطة السياسية الحقيقية التي تقوم على أساس اجتماعي، ووفق سيرورة سياسية-نضالية، وليس على أساس امتيازات ممنوحة، وسيرورة خرق القوانين العامة، إبان النهج السلطوي السابق.
بهذا المعنى، فإن إحدى الأسس الهشة لتجربة الانتقال الديمقراطي الحالي بالمغرب هي غياب توافق حقيقي وصلب بين مكونات النخبة السياسية الفاعلة داخل الحياة السياسية المغربية. وما التسميات السياسية، التي يراد فرضها وإشاعتها في الخطاب السياسي السائد، مثل أحزاب “اليمين”، “الوسط”، “المعارضة الليبرالية”..، سوى اعتراف بهذه الهشاشة ومحاولة لتجاوزها.
III – مخاطر الانتقال الديمقراطي:
بناء على تحليلنا السابق، سواء للظروف الموضوعية التي جاء فيها الانتقال الديمقراطي، أو للأسس السياسية التي انبنى عليها، وبناء على الملاحظة المباشرة للحياة السياسية لأزيد من سنة من مرحلة الانتقال، نستطيع أن نرصد المخاطر التي تهدد هذا الانتقال في مستويين اثنين: مخاطر يمكن اعتبارها خارجية، وأخرى داخلية.
الخطر الخارجي:
فالمخاطر الخارجية، نقصد بها تلك الآتية من خارج النخبة السياسية التي تقود وتتزعم الانتقال الديمقراطي، والمتمثلة أساسا في ظروف وأسس هذا الانتقال.
لقد بينا كيف أن الانتقال إلى الديمقراطية لم يأت نتيجة صعود اجتماعي وسياسي لقوى تاريخية تحمل مشروعا سياسيا ديمقراطيا. بل إنه انتقال جاء إثر أزمة مجتمعية وتراجع سياسي للفاعلين السياسيين أمام معارضة صامتة، لكنها مؤثرة، للمجتمع المغربي، كان آخر تعبيراتها الواضحة، العزوف عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
هكذا فإن الانتقال الديمقراطي الحالي بالمغرب لم يكن ثمرة انتصار قوى سياسية على أخرى، ولا يترجم صعود حركة اجتماعية منسجمة اقتصاديا واجتماعيا وإديولوجيا، لها سلطة حقيقة داخل المجتمع المغربي.
إن ظروف ميلاد هذا الانتقال تشكل أول خطر حقيقي على دوامه واكتماله، لأنها ظروف مطبوعة بالهشاشة وتسمح دائما بالتراجع لنقطة البداية ومرحلة الصفر. وما الطابع الفضفاض للتحالف الحزبي التي تقوم عليه حكومة السيد اليوسفي سوى أحد التعابير المباشرة لهذه الهشاشة.
ويزيد من حدة هذه الهشاشة وخطورتها كون الانتقال الحالي للديمقراطية، وكما سبق أن أشرنا، يأتي على أساس توافق غير حقيقي بين عناصر النخبة السياسية الوطنية من جهة، وعناصر النخبة السياسية الإدارية من جهة ثانية. الأمر الذي سوف ينعكس دائما على علاقة القرار السياسي الحكومي بالمجال الاجتماعي والاقتصادي، ويجعل ترجمته على أرض الواقع أمرا غير بديهي دائما.
الخطر الداخلي:
إلا أن أكبر المخاطر التي تهدد الانتقال الديمقراطي الحالي هي المخاطر التي تأتيه من داخله، أي من لدن عناصر النخبة المكونة لحكومة الانتقال الديمقراطي. فإلى جانب الخطر الخارجي المشار إليه سابقا، والذي يتجسد في جماعات الضغط داخل الإدارة والاقتصاد، والتي لها مصالح تتنافى ومضمون التراضي الذي يؤسس لهذا الانتقال، هناك خطر يمكن أن نسميه بالخطر النخبوي. ونستطيع أن نرصد تعبيرات هذا الخطر في ثلاثة سلوكات سياسية متفاعلة فيما بينها، هي كالتالي:
ـ سلوك إفراغ الانتقال الديمقراطي من المضمون الاجتماعي.
ـ سلوك تضييق مجال ممارسة الديمقراطية.
ـ سلوك اختزال الانتقال الديمقراطي.
السلوك الأول، نجد تمظهره في محاولة تحويل الديمقراطية إلى آلية سياسية لتحقيق مصالح النخبة المسيطرة على التنظيمات السياسية والاقتصادية والثقافية، وجعلها أداة لتوزيع المناصب العليا بين مختلف عناصر هذه النخبة، أو منهجية سياسية وإدارية لاختيار عناصر تسيير الجهاز المسيطر، بمعنى تحويل الديمقراطية إلى طقوس وشعائر سياسية، مفروغة من محتواها الاجتماعي والثقافي، باعتبارها نمط حياة يعبر عن مختلف مصالح الأفراد داخل المجتمع. إن الديمقراطية مع هذا الخطر لا ترتبط بالمساواة السياسية، التي تعني التوزيع العادل للسلطة السياسية، أي المساواة في الحظوظ لممارسة السلطة، ولا ترتبط بهدف هو عقلنة تسيير المجتمع، من خلال مشاركة المواطنين في سيرورات بناء الإرادة السياسية العقلانية. كما أنها لا ترتبط ببناء الظروف التي تلبي كل الحاجيات المشروعة، من خلال تحقيق المصالح الأساسية، من أجل الاندماج الاجتماعي والمشاركة السياسية. بل إنها إرضاء لعناصر من النخبة السياسية المسيطرة، وتعويضها عن ما قامت به من أدوار لتحقيق فائدة غير عامة، في سياق سياسي غير ديمقراطي.
ويمكن اعتبار الطريقة التي تم بها توزيع المناصب العليا في الوزارات، ثم منح وزارات إلى “أحزاب” لم تعمر سوى بضعة أشهر قليلة، ولا تتمتع بأي امتداد اجتماعي على الإطلاق، وقائع وأمثلة حية على محاولة تحويل الديمقراطية إلى آلية سياسية للتوزيع النخبوي للسلطة.
إفراغ الديمقراطية من محتواها المادي الاجتماعي، وجعلها، فقط، مطية لأصحاب “المشروعية التاريخية” وذوي “الشهادات العليا” والمقربون من دوائر السلطة السياسية، هذا الإفراغ يخلق ويعزز السلوك الثاني من الخطر النخبوي ضد الديمقراطية، وهو سلوك تضييق المجال السياسي الذي يمكن أن تمارس فيه الديمقراطية. إذ يتم تسييد تصور يرى أن المنظومة الحكومية هي القرار الوحيد الذي يجب أن يخضع للديمقراطية. أما سيرورات اتخاذ القرار الأخرى، والتي لها انعكاسات مهمة، فهي في نظر هذا التصور غير خاضعة للتنظيم الديمقراطي. هذا التصور الانتقائي للديمقراطية لا نجده، فقط، عند رجال الدولة المتشبثين بالنهج السلطوي القديم، بل كذلك داخل عناصر النخبة السياسية اليسارية التي لا ترى ضرورة للديمقراطية، سوى من أجل أن تصل هي، كجماعة من الأفراد، إلى دوائر القرار السياسي. وتحصر هذه الضرورة، دون أن تطبقها على سيرورات أخرى تربوية، حزبية، نقابية، إدارية، مدنية، علمية.. سيرورات تفتح عملية تشكل نخب جديدة صاعدة تعبر عن دينامية اجتماعية.
حتى نكتفي فقط بمثالين اثنين، لهما تعبيرات قوية في منحى تضييق مجال الديمقراطية وحصر ممارستها، نذكر مثال وزارة الاتصال ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللذين بقيا خارج نفوذ وسيطرة مقتضيات مرحلة الانتقال الديمقراطي الحالي. كما نذكر بقرار الحكومة بمنع استعمال القاعات والأماكن العمومية من طرف الهيئات الثقافية والسياسية والمدنية.
السلوك الثالث هو خطر اختزال الديمقراطية، أي عندما يراد تحويل الأزمة الاجتماعية إلى مشكل تنظيم إداري للاقتصاد، كأن الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعيشها المغرب حصلت، فقط، بفعل سوء التسيير الإداري وعدم كفاءة النخب التي كانت تسند لها المسؤوليات، وكأن السياسة هي فقط مجال للخبرة التقنية، وحسن التدبير الإداري، والعلاقات الجيدة، وليست مجالا للمصالح المادية والتمثيلية الاجتماعية ونمطا معينا لتوزيع الخيارات السياسية. إن رؤية الأزمة الاجتماعية بهذا الشكل تجعل من الديمقراطية آلية للانتقاء السياسي، على أساس مبدأ غير سياسي، هو الرأسمال الرمزي الذي يحول أصحابه إلى خبراء وتقنيين في شؤون المجتمع، ويحول هذا الأخير إلى مجموعة من الأعطاب التقنية، من يقدر على إصلاحها يكون هو الجدير بتسلم السلطة، إن هذا المبدأ لا يختلف إلا شكليا عن المبدأ الذي تحكم، في السابق، في الوصول إلى السلطة، والذي كان يتمثل في “الحياد” الاجتماعي اتجاه السلطة المركزية.
نستطيع أن نستدل على هذا السلوك بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي لم تصل إلى تغيير نمط استثمار المجتمع المغربي لعمله وتراكماته. وانحصرت في إصلاحات إدارية أكثر منها سياسية، كالتركيز على ترشيد المال العمومي، على أهميته، وتخليق الحياة الاقتصادية، والحفاظ على ثوابت غير محايدة في الاقتصاد المغربي كنسبة العجز في ميزانية الدولة والتوازنات المالية الكبرى. إن هذه “الأرتدوكسية المالية” كما سماها إدريس بنعلي لا يجب أن تسود والعجز الاجتماعي يتفاحش.
هذه بعض السلوكات السياسية التي نرى أنها تهدد الانتقال الديمقراطي الحالي، وتعمل، بشكل أو بآخر، على إفراغه من المضمون التاريخي الذي يجعل منه مرحلة نوعية في التاريخ السياسي والاجتماعي للمغرب.
لقد مر المغرب، وعاش حياته السياسية، منذ الاستقلال إلى الآن، تحت سيطرة فكرة “الوطنية دون شعب”. إذ كانت مقولة الوطن دائما حاضرة في الخطاب السياسي للسلطة المركزية، لكن دون ملئها، واقعيا وماديا، بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي. واليوم، وبعد دخول الحياة السياسية المغربية مرحلة الانتقال الديمقراطي، هناك منزلق أن يعيش المغرب تحت سيطرة فكرة “شعب بدون ديمقراطية”، منزلق يجعل الخطاب السياسي الرسمي يمتلئ بمفردات “الشعب” و”الجماهير” و”المجتمع المدني”.. دون أي مضمون واقعي. والخطر النخبوي، بسلوكاته السياسية الثلاثة، والذي يهدد الانتقال الديمقراطي المغربي الحالي، هو خطر يقود إلى هذا المنزلق، بمنعه المطالب الاجتماعية من أن تترجم إلى قرارات سياسية منتجة واقعيا.
IV – بعض شروط إنجاح الانتقال الديمقراطي:
عندما نقول إنجاح الانتقال الديمقراطي بالمغرب، فإننا نعني أن هذا الانتقال هو إرادة سياسية في التدخل اتجاه الحياة السياسية والاجتماعية. إنه نمط من التدخل السياسي يستطيع تهييء الظروف الاجتماعية، والمؤسسات السياسية، والمناخ الثقافي والحقوقي، التي هي وحدها الضامن لتحقيق ديمقراطية تكون عبارة عن “حدث اجتماعي” وحالة مجتمعية، وليس فقط حالة حكومية.
والقول بأن الانتقال الديمقراطي يتحقق عبر تدخل سياسي إرادي قول ينطوي على تصور لسيرورة تشكل تاريخية المجتمع المغربي. فإذا كانت الديمقراطية في الغرب الصناعي قد جاءت وليدة حركات اجتماعية، كان محركها الأساسي الصراع الاجتماعي، وفاعلها المركزي هو الطبقة الاجتماعية، ورهانها الوحيد هو التصنيع، مما أفرز، من خلال صراعات ونزاعات، الديمقراطية كنمط سياسي، يحقق نوعا من التوازنات الاجتماعية المطلوبة؛ إذا كان الوضع هكذا في الغرب الصناعي، فإن الأمر في المغرب، والمجتمعات غير المصنعة عموما، يختلف. إذ نجد أن السياسة هي التي تخلق المجتمع، لأن هذا الأخير يقوم على خصائص بنيوية، تجعل فعله الاجتماعي ضعيفا ويحتاج دائما، إلى أدوات غير اجتماعية في تطوره، والدولة أحد أهم هذه الأدوات. فالتبعية الاقتصادية، وما تخلقه من فقر وتخلف، تجعل المجتمع غير موحد على أسس اقتصادية، كما هو الحال في الغرب الصناعي، حيث لعبت المقاولة الصناعية دور المبدأ الموحد للأفراد والجماعات والطبقات. بل إن وحدة المجتمع التابع، كالمغرب، تنبع من خارجه، بقوة التدخل السياسي والمؤسساتي، ويحتاج دائما إلى نخب سياسية لإدارته.
هذا هو، باختصار، الوضع التاريخي الذي يجعل من غير المعقول، معرفيا وتاريخيا، الاعتماد على العلاقات الاجتماعية السائدة كي تبني مؤسسات وشروطا ديمقراطية، لأن هذا هو الدور التاريخي للنخبة السياسية الديمقراطية، في ظروف الانتقال الديمقراطي. إذ كيف لأفراد وجماعات، فرض عليهم أن يعيشوا في الرتب الأخيرة من الحضارة الحديثة، وأكثر من نصفهم لا يعرفون القراءة والكتابة، والفقر والبطالة تحتل حياتهم اليومية، وإن اشتغل بعضهم يوما، فمن أجل أن تغتني الأقلية وتهرب الخيرات.. كيف لمثل هؤلاء أن يطلب منهم أن يكون لهم فعل جماعي، اجتماعي، في مستوى البناء الديمقراطي الحديث؟
لهذا، وبناء على تجارب التاريخ، فكرا وممارسة، فإننا نستطيع أن نحدد شروط أساسية لإنجاح مشروع الانتقال الديمقراطي بالمغرب. وهي شروط لها أثر حاسم في الواقع التاريخي للمجتمع المغربي، إذ ترفع من قدرته وطاقاته، ليتدخل في واقعه وظروفه، ويرفع من مستوى فعله الاجتماعي، سواء اتجاه حاضره، أو مستقبله. وهي بهذا شروط تجعل من مفهوم الانتقال الديمقراطي مفهوما تاريخيا، وليس جملة لغوية تبرر تأجيل تحقيق الديمقراطية.
علمانية الاقتصاد المغربي:
إذا كانت العلمانية في الغرب قد طرحت في مسألة علاقة الدولة بالدين، وكانت تعني فصل الدولة، كموحدة للأمة (la nation)، عن كل اعتقاد ديني يسود المجتمع ويتخلل النزاعات الاجتماعية فيه، وجعل أفراد هذا الأخير متساوين، قانونيا، أمام الدولة رغم اختلافاتهم الاجتماعية والإيديولوجية والدينية. أي أنها كانت تعني تغيير مكانة الدين في الحياة العامة للمجتمع الأوروبي، وذلك بتحرير الأفراد والجماعات ومختلف القطاعات العمومية من سيطرة الكنيسة، وجعل الدولة تخضع لاعتبار وحيد هو الدينامية الاجتماعية والثقافية للمجتمع، فإنها، أي العلمانية أو الدنيوية (sécularisation)، في المغرب، إذا كان لا بد لها أن تطرح باعتبارها أحد أبعاد الفكرة الديمقراطية، فإنها تطرح في مسألة علاقة الدولة بالاقتصاد، أي حياد أجهزة الدولة إزاء الحياة الاقتصادية. لقد بينت العديد من الدراسات، سواء في علم الاجتماع أو الاقتصاد، كيف أن السلطة المركزية في المغرب، عملت منذ بداية الاستقلال إلى الآن على إحكام سيطرتها على الاقتصاد المغربي وإرغامه على الخضوع لاعتبارات السلطة، وليس لاعتبارات الإنتاج والتراكم والاستثمار. ولا نقصد بسيطرة الدولة على الاقتصاد المغربي كون هذا الأخير كان تحت سيطرة القطاع العمومي، بل إن ما نقصده بهذه السيطرة هو جعل الاقتصاد أهم الميكانيزمات على الإطلاق لإعادة الإنتاج الاجتماعي، وليس لبناء الثروة المادية والخيرات الوطنية والاستثمار، وبالتالي توسيع قاعدة الاندماج الاجتماعي. بمعنى آخر، لقد ظلت السلطة السياسية، على الدوام، هي الرأسمال الحقيقي في الاقتصاد المغربي، إذا استعملت، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كمورد مركزي وسند قوي في الوصول إلى الأرباح دون الخضوع للمنطق الاقتصادي القائم على العمل والرأسمال والاستثمار. فمن أجل أن يتحكم النهج السلطوي في النسيج الاجتماعي ويتمكن من مراقبة الفاعلين الاجتماعيين، عمد إلى جعل النجاح الاقتصادي رهينا بمنطق الزبونية والعصبية القرابية والولاءات السياسية، وجعل الربح المالي والتوسع التجاري لا يخضعان للعمل المتقن، تقنيا وبشريا، وللإنتاج الجيد في التسويق، بل للإعفاءات الضريبية والامتيازات القانونية والمالية والإقطاعات السخية؛ باختصار، جعل السلطة، أو التقرب لها ومنها، عملة رابحة، وجعل السياسة سوقا لتحقيق حاجيات الأفراد والجماعات المسيطرة داخل النخبة الإدارية والاقتصادية..
من هنا فإن علمانية الاقتصاد المغربي، نقصد بها إخضاع العملية الإنتاجية لقانون واحد هو المنافسة في العمل الإنتاجي دون تدخل أية قوة خارج المنطق الاقتصادي تعني أن الربح المالي يأتي من النشاط الاقتصادي والعمل المنتج العقلاني، وليس من مقتضيات عالم بعيد وسري، اسمه أجهزة الدولة.
فعلمانية الاقتصاد المغربي، نعني بها عملية حصر دور الدولة المركزية في ما يخص الشأن الاقتصادي، في حدود الإدارة الاقتصادية للتنمية الوطنية، أي توفير البنية التحتية المادية والمعنوية، لقيام اقتصاد وطني منتج، ومنع التدخل لفائدة أي طرف اجتماعي أو فئوي لتمتيعه بأي امتياز كيفما كانت قيمته. الأمر لا يتعلق هنا بالدعوة إلى اقتصاد السوق، وخوصصة الاقتصاد، كما لا يتعلق بأي تصور إيديولوجي للاقتصاد. إن العلمانية في هذا الشأن تعني جعل النشاط الاقتصادي المغربي خاضعا لقانون الإنتاج المادي العصري، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، وهو القانون الذي يتحكم في العمل المنتج والمنافسة المشروعة والمراقبة القانونية المعممة. أما التوجهات الإيديولوجية والاجتماعية للاقتصاد، فهي تقوم حسب موازين الصراعات الاجتماعية التي تنعكس على شكل قرارات في المنظومة السياسية.
إن رهانات تحديث وتأهيل المقاولة، كلبنة أساسية في الاقتصاد القوي، واستراتيجية توسيع قاعدة الاندماج الاقتصادي داخل المجتمع المغربي، لا يمكن لهما أن يتحققا دون جعل الاقتصاد الوطني يغير وجهه نحو السوق الداخلية، ما أمكنه ذلك، وأن ينفصل بالضرورة عن الدولة، ليصبح نشاطا قائما على مبدأ واحد هو المنافسة في العمل والإنتاج، على قاعدة المساواة في الظروف والقوانين.
تقوية وتوسيع سلطة القانون:
إحدى الميكانيزمات الحقيقية لعلمانية الاقتصاد هي تقوية وتوسيع سلطة القانون وتطبيقه دون اعتبارات سياسية واجتماعية. إن تطبيق القانون في المجتمع الحديث يعني أن الفضيلة لم تعد هي التي تحدد سلوكات الأفراد، وأن المصلحة هي المبدأ الذي تقوم عليه العلاقات داخل المجتمع، كما رأى مونتيسكيو منذ بداية القرن 18. لهذا فإن مسألة سلطة القانون وتوسيع مجال تطبيقه الفعلي على كافة شرائح وأفراد المجتمع المغربي، هي مسألة من صميم عملية الانتقال الديمقراطي المطلوب، وتعد معيارا تاريخيا لنجاح هذا الانتقال. فعلى الرغم من معاناة أفراد الشعب المغربي من غياب سلطة فعلية للقانون، ظلت أهمية هذه المسألة غير واضحة في الخطاب السياسي لليسار المغربي، بسبب سيادة تصورين اثنين: تصور أخلاقوي، وآخر اقتصادوي. فالأول كان يرى أن مواثيق الشرف والاتفاقيات الموقعة بين أطراف الحياة السياسية المغربية كافية لاحترام القوانين التي تحكم الحياة عامة، والسياسية منها على الخصوص، خاصة عندما كان هذا التصور يلوح ببعض القضايا الأساسية للأمة ككل، كسمعة المغرب في الرأي العام الخارجي، مثلا، واعتبارها إكراهات كافية لحث السلطة على جعل القانون سيد الموقف داخل المجتمع المغربي. أما التصور الثاني، فقد كان ينظر للقانون على أنه من تعبيرات البنى الفوقية للمجتمع، وأن التفكير فيه، سياسيا، يتم من خلال البنية التحتية التي هي الأساس، من هنا فإن الإصلاح القانوني يبقى دون قيمة. كلا التصورين ساد أطراف اليسار المغربي، ولم تبدأ المسألة القانونية تأخذ معناها الحقيقي إلا مع بداية العقد الأخير. وما زالت تعاني من صعوبات لكي تصبح محورية في الاستراتيجية السياسية للقوى الديمقراطية بالمغرب. أما موقف النهج السلطوي الذي كان سائدا من قبل، من المسألة القانونية، فإنه كان يتكئ في جزء منه على المرجعية الليبرالية التي كانت تبدي تحفظا كبيرا إزاء تطبيق القانون على كافة شرائح وأفراد المجتمع. فرغم قبول هذه المرجعية بمبدأ السيادة للشعب، فإنها لم تراه يلزمها بتلبية كل مطالب الجماهير. إذ تنظر للديمقراطية ليس كحكم للأغلبية، بل كتحالف بين مصالح خاصة. وبالتالي، فإن النهج السلطوي لم يقبل بأهمية المسألة القانونية إلا مع التنامي الدولي لحركات حقوق الإنسان وتأثيرها على العلاقات الدولية وعلى الثقافة السياسية الوطنية.
هكذا بقيت الحياة السياسية بالمغرب تجهل أهمية المسألة القانونية، إلى أن طرحت في سياق عملية الانتقال الديمقراطي الحالي، إذ انتقل الفكر السياسي النقدي من الاهتمام بإظهار الفوارق الموجودة بين واقع الحياة السياسية والتصور اليوطوبي الذي كان يتبناه من موقع القطيعة والثورة، إلى الاهتمام بإظهار الفارق الموجود بين القيم السياسية والقانونية المعلنة والمتبناة من قبل كل الفاعلين السياسيين داخل الحياة السياسية، والواقع المؤسساتي السائد.
إن المسألة القانونية تعني، في نظرنا، تطبيق مجموعة من المعاني على أرض الواقع اليومي لحياة المواطنين. فهي تعني بناء المساواة أمام القانون رغم التفاوت في الاقتصاد والاختلاف في الثقافة. والبناء نقصد به إحداث ميكانيزمات واقعية لمراقبة هذه المساواة وجزر مغتصبيها، لأن المساواة في الديمقراطية تعني الحد من اعتباطية السلطة.
وفي المغرب، فإن المسألة القانونية لا يمكن اختزالها في مسألة فصل السلط ونزاهة الانتخابات؛ فهذه المسألة هي شرط قيام ديمقراطية فعلية، إلا أن الحياة السياسية في المغرب مازالت في مطالب سابقة، أهمها إقرار فعلي بفصل التخصصات بين الوزارات والتنسيق العقلاني بينها، لأن تطبيق القانون يسبقه أولا تحديد المسؤوليات وفصل التخصصات، حتى لا يكون الخروج عنه من فعل قوى غيبية، أي حتى يتسنى تحديد المسؤول عن خرق القانون. ومن معاني المسألة القانونية كذلك، جعل القانون مسايرا للحياة الاجتماعية والثقافية، من جهة، وجعله، من جهة أخرى، غير مكلف في احترامه وتطبيقه من لدن عموم الشعب المغربي. لأن المسايرة تمكن القانون من مأسسة كل النزاعات الاجتماعية، القديمة والجديدة وكل المظاهر الجديدة للعيش والتطور التي يعرفها أفراد المجتمع. ومأسسة الحياة الاجتماعية، باستمرار، هو أحد العناوين البارزة لتطبيق السياسة الديمقراطية في المجتمعات الحديثة. وجعل القانون غير مكلف في احترامه، يعني واقعيا، تسهيل عملية الاندماج الاقتصادي والاجتماعي عند الفئات والجماعات الفقيرة في المجتمع المغربي، بتحقيق إصلاح شامل وعميق للإدارة المغربية يمس تغيير القوانين لتصبح لها صلة وثيقة بالحياة الاجتماعية المتطورة للمجتمع المغربي، وتبسيط عقلاني للمساطر والإجراءات، وجعل الغايات الاجتماعية والتنظيمية للقانون واضحة وشفافة وتصب في احترام المواطنة والحقوق المدنية والإنسانية. بتعبير آخر، يجب على الإصلاح الإداري أن يسعى إلى القطع مع مفهوم الإدارة القمعية الذي بنيت على أساسه الإدارة المغربية من أجل ضبط السيطرة على المجتمع، وأن يفتح سيرورة بناء إدارة لتسيير المجتمع المغربي حسب حاجياته المتطورة، ومتطلباته المتجددة، واستجابة للدينامية الاجتماعية والثقافية.
كما أن أهم معاني المسألة القانونية، كذلك، داخل سياق الانتقال الديمقراطي، هي كونها توسع من المجال السياسي بالمغرب، ولا تكتفي بحصره في الشأن الحكومي فقط. من ثمة فإن الحرص المستمر على اعتبار حقوق الإنسان، مبدأ أساسي في الممارسة السياسية تعني أن المصالح المشروعة للأفراد لا تتجزأ ولا تختزل، ولها في مجملها أبعاد سياسية يجب أن تنعكس في عملية اتخاذ القرار.
إلا أن أكبر عائق أمام تقوية وتوسيع سلطة القانون، هو طغيان الشخصية، إن صح التعبير، في الحياة السياسية المغربية (La personnalisation du pouvoir). وهو أول عائق يجب القضاء عليه. فالشخصنة، المتمثلة في الزعامات المحلية أساسا، تقف كوسائط بين الأفراد والسلطة المركزية، وتمنع من تطبيق القانون وتحقيق المساواة، فهي أولا تجعل المصالح غير محددة تحديدا اجتماعيا. ثم إنها لا تلبي، ثانيا، سوى المصالح الأنانية للأفراد، لتشيع بذلك ثقافة تغيب فيها فكرة المواطن.
إن هذه الزعامات المحلية، لم تعد تستجيب لمقتضيات الانتقال الديمقراطي، لأنها كانت وليدة مرحلة النهج السلطوي، الذي كان يريد من وراء خلقها منع بروز الفاعل الاجتماعي، كتعبير مجتمعي عن الحاجيات والمطالب المشروعة، وتسهيل عملية المراقبة الاجتماعية داخل المجتمعات المحلية والجهوية. من هنا فإن قوة هذه الزعامات لا تستمد من علاقة كريزمية تجمعها مع الأفراد والجماعات المحيطة بها، بل إنها تتقوى بالدعم الذي تجده عند السلطة القائمة لتلعب دور العائق أمام تشكل مطالب اجتماعية منظمة في أحزاب ونقابات وجمعيات وهيئات مدنية.. وكان هذا الدعم يتجسد في تسهيل الاغتناء غير المشروع لهذه الزعامات، ومنحها مكانة، ولو شكلية، في عملية التسيير المحلي، عبر إعطائها مقاعد مزورة، بهذا الشكل أو ذاك، في المجالس المنتخبة.
إن القانون بمعناه الديمقراطي يفيد أن المصالح المشروعة تلبى ويستجاب لها دون الحاجة إلى الوسائط المشخصنة وبفضل تطبيقه واحترامه الفعلي.
فصل الدولة عن السياسة:
إن تحقيق المساواة أمام القانون داخل المجتمع المغربي لا يمكنه أن يتم إلا مع تحقيق فصل تام بين الدولة كمجال للوحدة، والسياسة كمجال للتعدد والاختلاف. ذلك أن عدم التمييز بين المجالين هو الذي يقود إلى تقوية سلطة المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة لعموم المجتمع. فالنهج السلطوي الذي حكم المغرب منذ الاستقلال إلى الآن، كان يجعل من الدولة أداة في يد السياسة ويخلط بين المجالين، ليتمكن من القضاء على الفاعلين الاجتماعيين، ويستعمل السياسة موردا ماليا للنخب التي تدعمه، ويخلق بالتالي هوة كبيرة بين الحياة اليومية للمواطنين، وعالم السلطة الذي يقوم على اعتبارات غير اجتماعية ولا يحترم القوانين.
إن المقصود من هذا الفصل والتمييز هو جعل الدولة المبدأ المركزي الموحد للوطن، في العلاقات الدولية وجعلها رمز السيادة العامة للأمة، والبنية المعيارية والأخلاقية للتراضي الذي ينظم المصالح والاختلافات. إنها تاريخية المجتمع المغربي، التي توحد النزاعات والرهانات. أما السياسة، فهي في المقابل مجال للمصالح الاجتماعية والاقتصادية المتناقضة، للنزاع بين الفئات والجماعات، للسيطرة على القرار السياسي، على تاريخية المجتمع، سيطرة مشروعة حسب ميكانيزمات متوافق عليها، ومن أجل إعطائها وجهة تخدم مصالح فئات معينة وفق توازنات تاريخية. إنها مجال “قول الشيء وضده”. أي المجال الذي تتضارب فيه الأفكار والأطروحات والمصالح.
وإذا كان هذا الفصل بين الدولة والسياسة يجعل الدولة خادمة للجميع، فإنه يجعل من السياسة، في المقابل، ممارسة تمثيلية لفئات متنازعة عن مصالح اقتصادية. بمعنى إن الممارسة السياسية لن تبقى ممارسة للمشاركة في السلطة فقط، بل ممارسة تمثل وتعبر عن مصالح فئات وجماعات اجتماعية خاصة، وبالتالي تصبح السياسة مجردة من كل الأدوات التي تستعمل من أجل منع الاختلاف والتعدد. وعلى رأس هذه الأدوات المقدس. ذلك أن هذا الأخير مجاله الوحيد، المقبول، هو الدولة. أي لا يمكن إعطاء صفة المقدس، في الحياة الاجتماعية للمجتمع المغربي، سوى لما يوحد هذا المجتمع داخل الدولة، وداخل مجاله الجغرافي أو التاريخي. أما في مجال السياسة، حيث التعدد والاختلاف، فإن استعمال المقدس يكون ممارسة غير ديمقراطية تؤدي إلى قمع المعارضة والتعدد، أكثر مما تؤدي إلى الوحدة.
من النتائج الأساسية لهذا الفصل بين الدولة والسياسة، إلى جانب خلق شروط مادية لتطبيق المساواة أمام القانون، ربط علاقة مباشرة بين المنظومة السياسية والواقع الاجتماعي، وجعل هذا الأخير هو المرجعية الأساسية في الممارسة السياسية.
إن مظاهر الاحتقان السياسي التي تملأ الحياة السياسية المغربية، المتمثلة أساسا في انتصار بنية السلطة على الحدث السياسي، وجعل السياسة مراوحة في نفس المكان، وتكرار نفس المطالب والقضايا، هي مظاهر ناجمة، ليس عن سيطرة التقليد في المجتمع المغربي، كعائق أمام المشاركة في السياسة، أو ناجمة عن سيطرة نمط إرثي من المشروعية، بل إن السبب هو غياب علاقة مباشرة بين الواقع الاجتماعي، كحقل للنزاع والمطالب، والسياسة كمنظومة للقرار.
وإذا كانت الديمقراطية هي الحدث الاجتماعي الذي يدخل عموم الشعب للحياة السياسية في المشاركة والتأثير على القرار، فإنها داخل المجتمع المغربي لن تتجسد سوى بربط علاقة مباشرة بين الاجتماعي والسياسي، وجعل هذا الأخير فعلا تمثيليا يعكس مصالح الناخبين/المواطنين.
إن تحقيق فصل واضح بين الدولة والسياسة، وجعل هذه الأخيرة ذات علاقة وثيقة مع الواقع الاجتماعي، هو أمر يفترض وجود دينامية اجتماعية وثقافية مركزها العلاقات الاجتماعية، وليس الدولة. أي أنه يفترض أن تكون هذه الدينامية صاعدة وليست نازلة من فوق، ومتحكم فيها من قبل المركز السياسي كما تعودنا أن نعيشه في المغرب.
هكذا، فإن فتح سيرورة تشكل المجتمع المدني أمر على غاية من الأهمية داخل عملية الانتقال الديمقراطي. لأنه يمكن من تنظيم المطالب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، تحت حماية القانون، ومن أجل جعل الثراء الثقافي للمجتمع، والتفاوت الاجتماعي، والاختلاف في المصالح، واقعا بناء لسيرورة تطور المجتمع المغربي وقوة تزيد من تنمية فعله اتجاه تاريخه ومحيطه.
إن أهمية تشكل المجتمع المدني بالمغرب تكمن في إدخال الحياة العامة للمجتمع تحت تحديدات اجتماعية، وتخرجها من أشكال الشخصنة السياسية التي لم تعد منسجمة مع التطور التاريخي للمجتمع المغربي، ولها أدوار معيقة للتحديث ومزكية للتسلط والتخلف.
إلا أن تطور المجتمع المدني بالمغرب ليس مسألة قانونية فقط، إنه يقتضي فسح المجال لظهور رأي عام وطني، يناقش بحرية ومسؤولية (مع ضمان حق الخطأ) القضايا والمشاكل العامة للمجتمع، قبل وفي استقلال عن المؤسسات السياسية، وخارج أي مراقبة حزبية أو فئوية، وبإمكانات عامة وعمومية. فتطور الرأي العام، كإحدى التعبيرات الأساسية لحيوية المجتمع المدني، يقتضي وجود قنوات للتعبير الحر والمستقل في متناول الجميع بدون استثناء، وعلى رأس هذه القنوات الإذاعة والتلفزة والصحف. من هنا فإن إصلاح القوانين المنظمة لمجال الصحافة والتعبير بالمغرب وتطويرها لن تكون لهما أية نتائج ديمقراطية، إذا لم يرافقا بتحرير هذا المجال للتداول العام وفتحه للمشاركة العمومية حتى يعكس الاختلاف الثقافي والجمالي والتعدد السياسي.
فالسياسة ليست سوقا حرة لتلبية الطلبات فقط، إنها بالأساس وعي بالمواطنة لا يستقيم إلا بالقضاء على أشكال الوعي الفئوي، والفردانية الأنانية، التي تتحدد خارج العلاقات الاجتماعية، أي وعي ينمي الإدراك والإحساس بالانتماء إلى فئات اجتماعية داخل الانتماء إلى الوطن. وهو بهذا، لا يتطور سوى بالنقاشات العامة، والسجالات السياسية داخل وسائل التعبير العمومية دون رقابة فئة خاصة، أو سلطة غير سلطة القانون. بل أكثر من هذا، فإن الانتقال الديمقراطي بالمغرب لن يضمن بشكل محكم إلا بجعل الرأي العام سلطة تراقب السلطة السياسية، وتقف ضدها، عند كل محاولة لأن تصبح اعتباطية. فالضمانة الوحيدة للمساواة والعدالة والحرية، كأسس أكيدة للحياة الديمقراطية، هي وجود سلطة للرأي العام الوطني، إذ لا شيء يمنع السلطة من الاعتباطية، سوى تعدد السلط، تحت وحدة دولة القانون والوطن.
خاتمـــة:
واضح أننا نقصد بالديمقراطية حالة مجتمعية، وليس حالة حكومة فقط؛ أي عندما يتحرك المجتمع ليوسع فعل مشاركته السياسية، وتحسين ظروف الحرية والمساواة. إن الديمقراطية بهذا المعنى هي “حدث اجتماعي” يترجم المساواة في ظروف العيش والتعبير وتحقيق الأماني، عبر التنظيم المؤسساتي وتحت سيادة القانون.
إن الخروج من الأزمة المجتمعية التي تتفاقم في المغرب، لن يتحقق فقط عبر القرار الاقتصادي، خاصة إذا كان يعتمد اقتصاد السوق كحل سحري للأزمات. إن هذا الاعتبار هو الذي يكبل الانتقال الديمقراطي بحدود تهدد إمكانياته المستقبلية. ذلك أن شروط الاندماج الاجتماعي لا يمكن حصرها في الاقتصاد، لأن إشاعة اقتصاد “حر” له نتائج اجتماعية وسياسية لا يمكنها أن تلعب دورا في الاندماج، إلا بسياسة اجتماعية وحقوقية ومؤسساتية، قائمة على مبادئ الديمقراطية.
فالتساهل مع استمرار النهج السلطوي، في إدارة الحياة السياسية، له انعكاسات سلبية على استراتيجية الانتقال الديمقراطي، انعكاسات تجعل الانتقال مسألة إصلاحات اقتصادية ومالية فقط، وتجعل ثمن النمو على كاهل الفئات الشعبية دون سواها. وبالتالي الاستمرار في نهج نفس السياسات السابقة، وإفراغ الأمل الديمقراطي من محتواه الواقعي.
صحيح أن السياق التاريخي، الموروث عن الحقبة السلطوية، سياق غير ديمقراطي، أي مطبوع بأزمة حادة تفجر مطالب مشروعة عند جميع مكونات المجتمع، وفي مختلف الاتجاهات، الأمر الذي يجعل من الصعب على القرار السياسي أن يكون واضحا وفعالا. كما أنه سياق غير ناجم عن صعود وانتصار قوى اجتماعية وثقافية ديمقراطية، مما يجعل خصوم الانتقال يحافظون على سلطة واقعية لا يستهان بها. إلا أن الإجراء السياسي التاريخي الوحيد القادر على تجاوز هذا السياق غير الديمقراطي، هو إطلاق سيرورة دمقرطة الحياة السياسية والاجتماعية، قانونيا ومؤسساتيا، باعتبارها سيرورة تمكن الفاعلين، في مختلف انتماءاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعلى اختلاف مطالبهم ومصالحهم، من بناء فعلهم الاجتماعي واستقلاليتهم السياسية والاقتصادية، والوصول عبر مأسسة النزاعات والاختلافات (وليس عبر قمعها) إلى توافقات تاريخية حقيقية، بمعنى أن تكون نابعة من صميم دينامية المجتمع المغربي وجدل العلاقات الاجتماعية داخله، ومحصنة بفصل حقيقي للسلطات. فبدون هذا الفصل الذي يعني السهر على تطبيق القوانين على الجميع سواء كانوا حاكمين أو محكومين، وحفظ المال العام من الاستعمالات الفردية أو الفئوية.. وجعل القضاء والصحافة سلطة فوق كل المغاربة، بدونه، سوف يتحول التوافق إلى اتفاق بين عناصر النخبة المسيطرة داخل الأحزاب والتنظيمات على جعل السياسة مطية للمصالح الخاصة، والسلطة العمومية غنيمة، والتناوب الحكومي تناوبا على نهب وسرقة خيرات المجتمع المغربي وجهده وعرقه..
فليست الأصولية الدينية والثقافية هي وحدها من يهدد الديمقراطية، بل إن الانصياع وراء العولمة، اقتصاديا دون جوانبها السياسية والمؤسساتية، والحقوقية –إذا نحن افترضنا جدلا أنها حتمية اقتصادية- لا يقل خطورة وتهديدا للعملية الديمقراطية.
فبيع ونشر “ثقافة السعادة” المصنعة في المراكز الرأسمالية الغربية، دون توفير الشروط المادية والمؤسساتية لتحققها، أمر يؤول إلى أن ينقلب إلى ضده، ويحول وعد السعادة إلى موعد مع العنف والتفكك